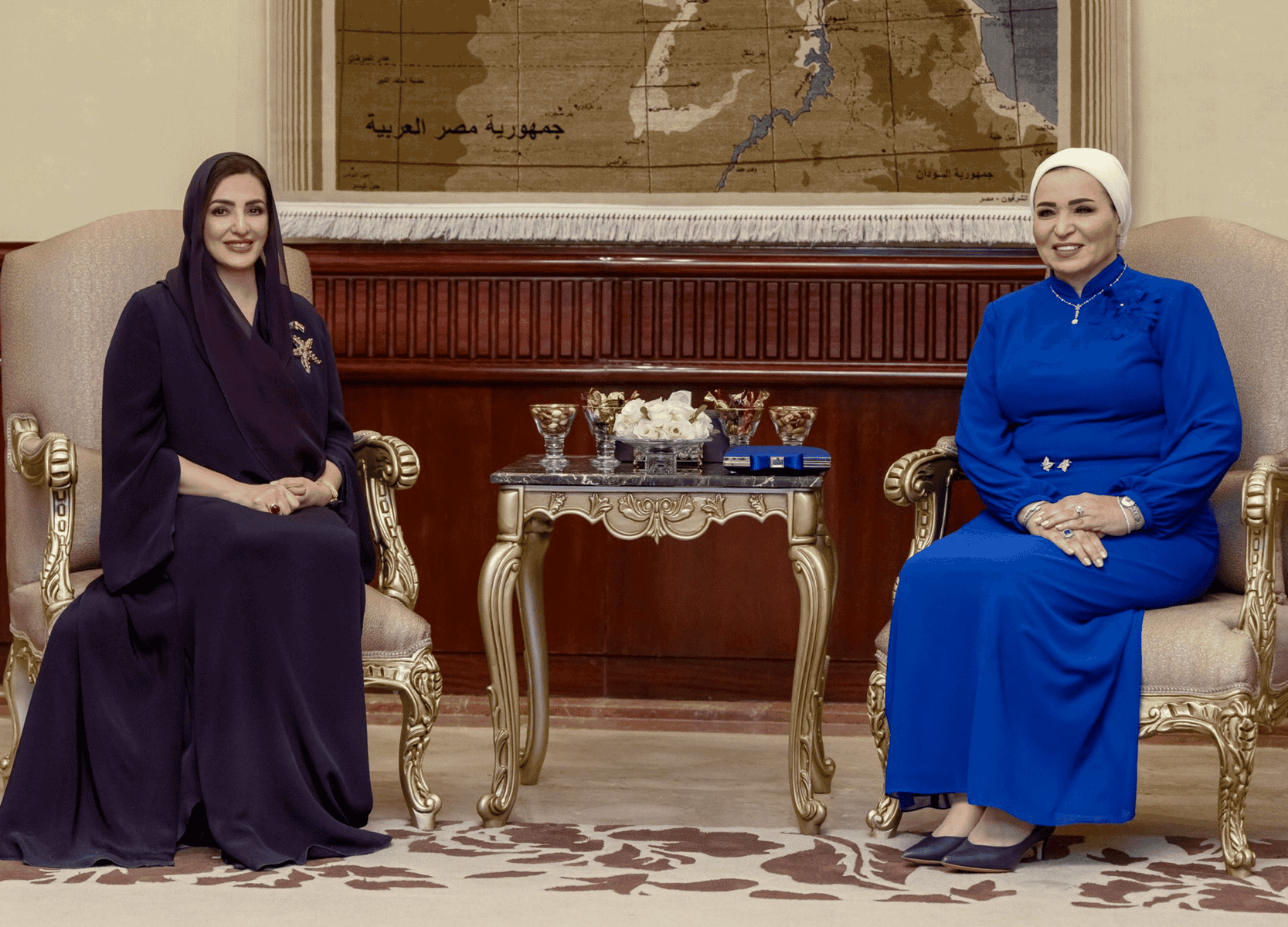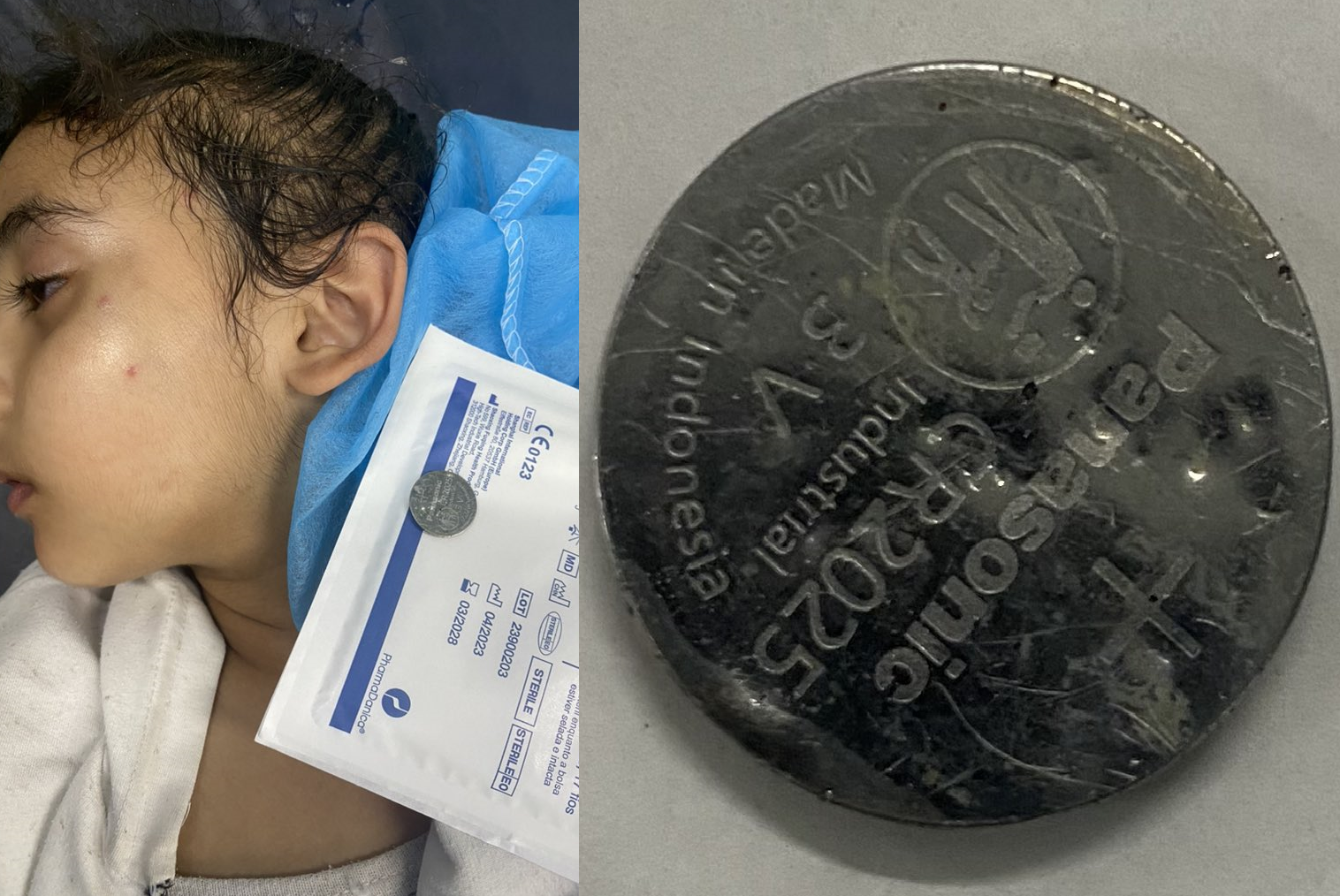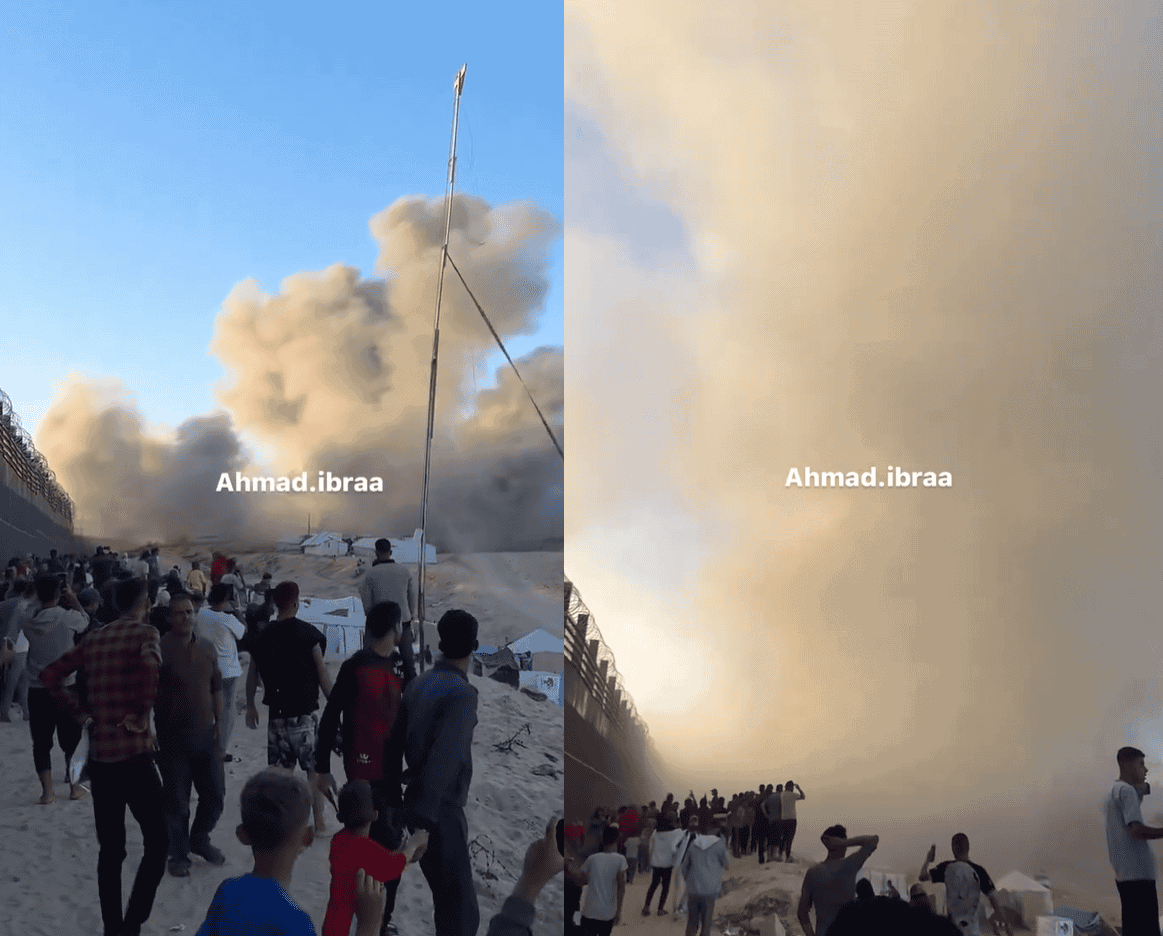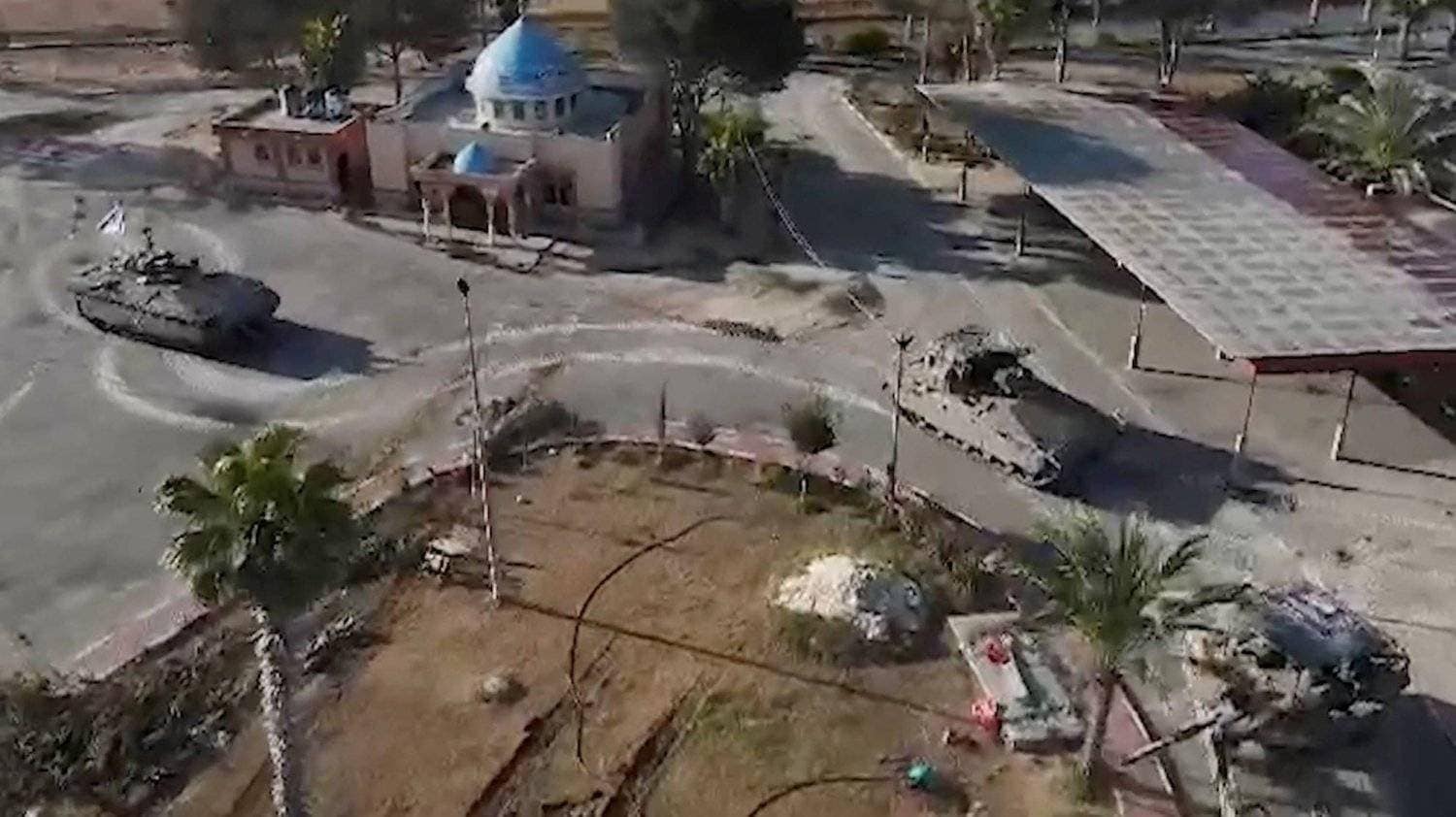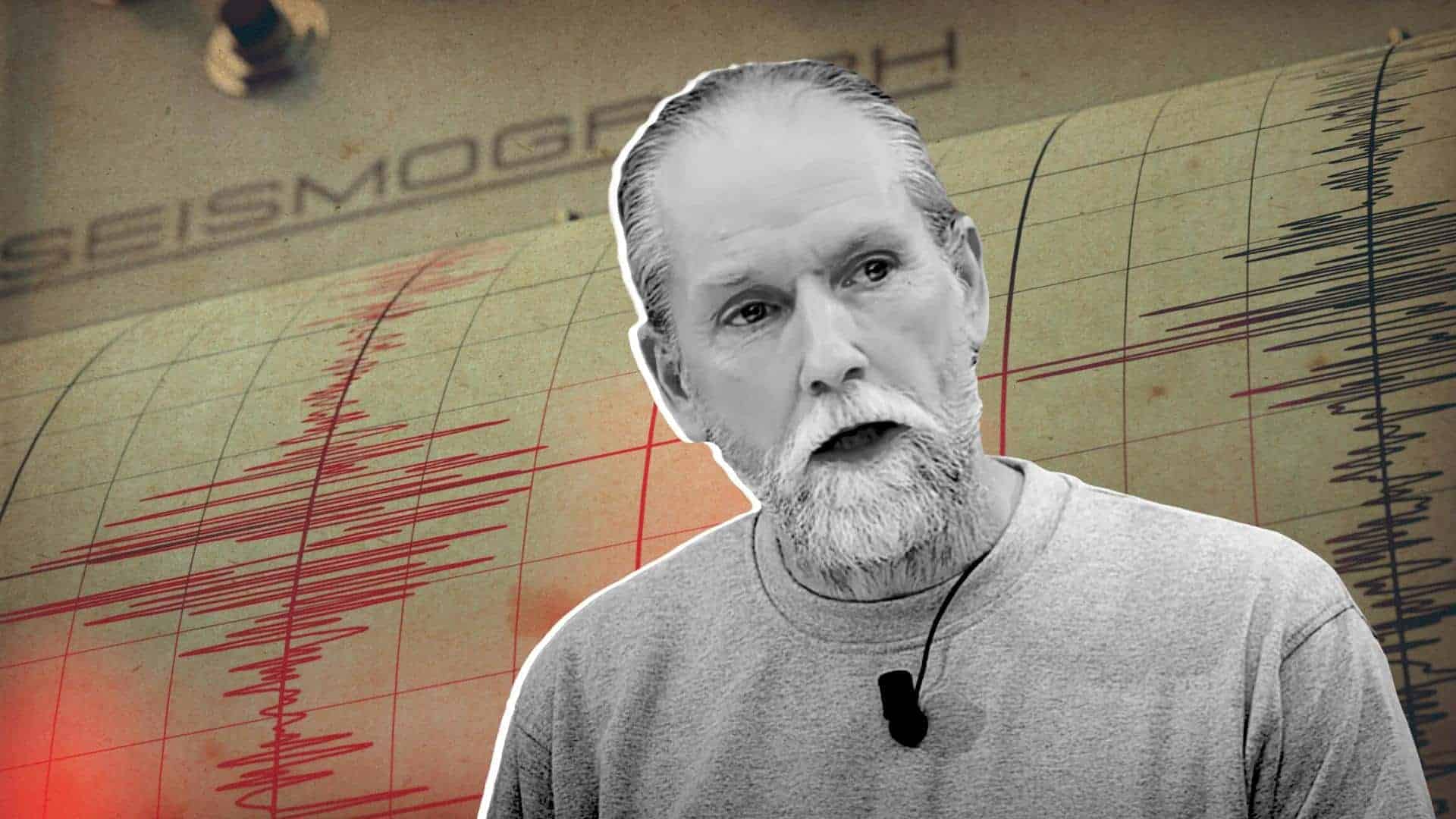ما إن تبدأ النّسمات الحارّة تلفح وجنتيك التي اشتاقت إلى مداعبة لفحات الربيع العليلة لها، حتّى تعلم بأنّ الصّيف قد غزا هذه البقعة من الأرض منذ نيّف من الزّمن ليضفي على لحظات يومك هنا صعوبة على صعوبتها و لتمسي الدقائق أكثر غلاظةً و قسوة و كأن هذا المغترب يخشى على ذاكرتك النّسيان و كأنّه يخاف من غدرها إذا ما عزمت تجاوز ذكراه يوماً…
صيفٌ يجعلك من قساوته تتناسى للحظات كيف كان شتاءه الأكثر قسوة إذا ما تأفّفت في ساعات ذاك النهار الطّويل من ارتفاع درجات الحرارة ، خاصةً حينما تشعر بمدى قرب الشّمس على سطح هذه الأرض دوناً عن غيرها و كأنها شمس أخرى غير التي عرفناها و اعتدنا وجودها يوماً هناك ..
هناك حيث موطني ، أم تراني أقول في أماكن أخرى من على هذه الكرة الارضية على اختلافها أو على الأقل على اختلاف تلك التي كنت قد شهدت شمسها يوماً !
و على الرّغم من أنها المرة الثّانية الّتي يزورني فيها هذا الفصل و أنا في غربتي هنا ، فقد أقتربت أيام غربتي في هذا المنفى أن تبلغ العام و نيّف من الزمن ، إلا أنني لم أعتد عليه بعد ، و خاصة حينما تصبح تلك الشمس موازية لسطح هذه المعمورة، فيخيّل إليك أنها ستلثم سطحها عند الغروب و كأن الأرض ستعانق شعاعها محتضنةً إيّاه قبل المغيب بلحظات …
كانت الساعة لم تتجاوز السّابعة صباحاً حينما عزمت على الخروج من منزلي قبل أن تبدأ الشّمس من إرسال شعاعها الحراري الغير محتمل ذاك ، و كأنها بذلك تعتذر لنا عن برودته الكائن في شتاءٍ سبق هذه الأيام و كأنها ستعوّض بذلك لحظات صقيعنا الذي سكن داخلنا قبل أجسادنا أشهراً طوال…
و كروتين حياتي اليومي البطئ الجريان جلست على أحد كراسي مقصف الجامعة أحتسي قهوتي المعتادة ناظرة نحو المارة متأمّلة تلك الشوارع علّ ذاك يساعدني على تخفيف توتري يومها ، فقد كان يوم يحمل لي امتحان آخر من امتحانات هذه القاعات و لكن لم أعلم حينها أنّ لحظات أخرى ستزورني كاسرة ذاك الروتين ، لتحلّ ضيفاً ليس على ذاكرتي وحسب بل أيضاً على ذاكرة قلمي الدّائمة ..
لم أكن أجلس وحدي اليوم، فقد كان يرافقني كالعادة صديقي الذي لا يملّ مجالستي على تلك الكراسي أو غيرها ، يزورني إذا ما شعر أني بخير و يطمئن عليّ إذا ما ساءت حالتي ، يواسيني بمسح دمعي إذا أنا أخبأته عن العالمين ..
أنه أكثر من يشعرني بالأمان بل هو المعنى الحقيقي للوفاء الذي لم ألتمسه بين تلافيف هذه الأرض ، مجتمعاتها ، و أناسها …
هو صديق..
بل هو أكثر من صديق ، هو ذاك الصوت الذي يؤنّبك إذا ما أخطأت و يحاورك إذا ما تهت و يجالسك إذا ما مللت الجميع ..
لعلكم تقابلوه يوماً ، لعلّكم تستشعرون صدق كلماتي و نقصانها فيه إذا ما وددت الإبحار في وصفة يوماً …
أعلم أنّ جميعكم بات لديه الآن فضولاً لمعرفة ذاك الشخص الخفي أو على الأقل ” اسمه “..
لا تبحثوا كثيراً يا سادة فهو شخص يجلس معكم أحياناً و داخلكم في كثير من الأوقات ، ذاك الصوت الذي لا تستطيع يوماً أن تبرئ منه إلا حينما تفارق الروح ذاك الجسد أو بتعبير أصح حينما تغادر الروح الجسد شريطة اللقاء الآخر حيث اللا فراق ، اللا عتاب ، اللا حزن ، لا أعلم، ربّما..
هو صوت داخلي و لكني في كثير من الأحيان أتخيل أن مرافقته لي ماديّةً لا معنويّةً و حسب ، ربما هو الصوت الحكيم الذي خلقه الله في كل منا إذا صح التعبير ، أم لعله هو ذاك الضمير الذي يتحدثون عنه على الدوام ، أم تراه أسمى و أجل، أيضا لا أعلم …
و لكن لا بد أنه موجود عند كل من روّاد هذه المعمورة ، بعضهم لم يكتشفه بعد و آخرون كان اكتشافه و عدمه سيان بالنسبة إليهم، و غيرهم فضّلوا إعدامه حينما وقف في طريق مصالحهم و أهوائهم ..
فهو ليس دائما يأتي مرافقاً لأهواءك ليثني على أفكارك ، فهو ليس بخائن و لا متملّق أو منافق ، هو شي خال من المصالح ، هو شيء لا يتحدث عن نفسه إذا شكوت إليه وجعك ، بل يتحدث عنك و لصالحك أنت فقط ، لذلك لم استطع أن أطلق عليه مصطلح صديق و لا حتى حبيب ..
ذاك الشيء إذا ما اكتشفته و زدت من ثقتك فيه و أثنيت على الخير الموجود بين ثناياه منحك راحة حين التّعب و حباً حين الألم و سلاماً إذا ما بدأت نيران الاشتياق تعتلي داخلك حاجمةً عن صدرك التقاط أنفاسه…
أنه انت و ليس انت ..
كيف ؟
سأخبرك ..
أنت يا سيدي انسان فيك يتوضع الخير و الشر و لو أن بذرة الخير أسبق و ذلك بحسب الفطرة من جهة و كما أثبتت الكثير من الدراسات الدينيّة و الدنيوية من جهة أخرى..
و أنت وحدك من يجعل منه المصدر الأعظم لشرورك أوالمصدر الأسمى لخيرك الدّفين فيك أو حتى الواضح منه..
فحصاد حكمتك كما ذكرتُ يا سيدي هو من زراعك أنت لا غيرك .
و بالعودة إلى ذاك الكرسيّ حينما زارني مجدداً ذاك الشيء الذي سأطلق عليه مجازاً اسم الوحدة ، و ذلك لأني أخاف إذا ما أطلقت عليه اسم الأنيس أن يعتقد بعض أمراض النفوس أن ذاك ما هو إلا أحد أسوأ أنواع إنفصام الشخصية على حد ظنونهم و مستوى تفكيرهم المحدود ..
فإذا به يزورني مجدداً …
و كأنّ ذاك الشيء يخاف حينما يلتمس روحي التي تخبره بأنها باتت لا تشعر بشيء سوى ببرودة هذا المكان و دفئه ..
و.كأنّه بذلك يطمئن بين الحين و الآخر على روحي بمشاعرها ، تقلباتها ، و ربما ميلها للوحدة أيضاً ، ذاك الميل الذي يلمسه ليس فقط من يتواجد في محيطي الخاص بل أيضاً من استطاع لمس روحي من وحي كلماتي و متابعتها الدؤوبة لها دون كلل أو ملل …
فإذا كان الميل للوحدة أحد أكثر سمات الضعف في شخصية الإنسان فهي نفسها الميزة الأهم لحياة كل من اتخذ من القلم منجياً و سبيلاً سواء أكان كاتب ، شاعر ، أو حتى روائي …
فلولاها لما كان للكاتب حظّاً بالتّأمّل و دونها لا يستطيع أستشعار حالات الحزن و الفرح معاً , الضحك و البكاء في آن واحد ، البسمة التي يتخللها دمعة قديمة عالقة في المقل ، فوحدها تلك الوحدة التي تفهم روحك و تدفق عليك من المشاعر و الأحاسيس ما يخدم ليس قلمك و وحيه و حسب بل و روحك أيضاً .
فإذا ما شَعَرَت بأنّ روحك التي باتت تفقد الأمل في بعض الأشياء أو ربما في أغلبها أم لعلّي أقول في كل الأشياء متضمّنةً بذلك حتّى البشر في كثير من الأحيان ، حتّى تزورك من جديد لتُضحكك في حزنك و تبكيك في فرحك و تجعلك تغضب في سلمك و تجعل منك مسالماً في أكثر لحظات الغضب شدّة ..
هي أكثر أنواع الأقنعة تعقيداً إذا ما صحّ وصفها بالقناع و لكنه على خلاف غيرها من تلك الأقنعة …
سواء أكانت مزيّفةً تخفي خلفها الكثير من الحقد، الشر، و المرض أم خيّرة ، صادقة ..
فهو قناع امتزج بالرّوح حتى بات جزءً منها فلا يُكتب له أن يتحرك من مكانه المعتاد قيد أنملة و ذلك على حسب معرفتي الجيدة بها ..
و الآن يا سادة لماذا تراني أتحدث عن الوحدة ، ميزاتها و مساوئها ؟
سأخبركم و لكن دعوني أعود إلى صباح ذاك اليوم حيث فنجان قهوتي و نافذة ذاك المكان …
كان يتواجد على بعد أمتار من اطلالة ذاك المقهى الصغير حديقة للعامة ذو أشجار كثيفة متوضعة بشكل متتالي مشكّلةً ممر يحمي رؤوس المارة و أجسادهم من أن تقبّل أشعّة تلك الشمس وجوههم و أصدغتهم فترة من الزمن قبل انقطاعه، ليقبع خلفه ساحة تحمل ذات الطابع خصّصت للجلوس بعدما توضّع تحت ظلالها بضعاً من المقاعد الخشبيّة …
لم يكن في ذاك المشهد ما يثير تأملي، و لا حتى محاكاتي لنفسي المعتادة على الإطلاق، و لم أجد في ذاك الصباح ما يحفّز قلمي و لا حتّى فضولي أو دعوني أقول ذاك ما ظننت حينها..
فما هو إلّا روتين معتاد لوجوه أناس منهكة و أخرى يبدو عليها أنّها متأخرة متوترة و غيرها متعرقة لاعنة متأفّفة كحالتي قبل لحظات ، غير تلك الوجوه التي تبنّت الوجوم و كأنها بذلك تعبر عن شوقها أو ربما حبها ، كرهها أم لعله كان يئسها ، ضعفها و استكانتها تحت مسننات هذا المكان بعد أن ملّت ذاك الروتين و ديمومته ..
إلى أن توضّعت ناظريّ عند وجه مجعّد استقرّ عليه خطوط العمر كمحراث قديم رسم بمجرفته مستقيمات واضحة المعالم على صحراء قاحلة فتمسي بذلك لوحة إذا ما زارت مقلتي أحدهم حتّى تتركهما زائغتين تلتمس الرّؤية من جديد و لكن دون جدوى …
خطوطاّ رغم أنها باتت تدل على أنّ صاحبها تجاوز الستين من العمر إلّا أنّ جسده كان يقول شيئاً آخر و هو يمارس تلك الحركات بحرفيّة تجعلك تستنبط منها أنها أحد روتينيّات أيّام عمره المنصرم مروراً بمراحلها المختلفة حتى هذا الصباح ..
حركات ما إن تراقبها للحظات حتى تستنتج تلقائياً بأنها رياضة ” اليوجا ” الشهيرة ، و إن لم يحظى لك تجربتها يوماً ، فيكفيك أن تملّ بطئ إيقاعها ذاك إذا ما عزمت تتبّع تلك الحركات و ربطها لا شعوريّاً ببطئ إيقاع هذا المكان ، أو على الأقل ذاك ما شعرت به حينها ، حتى تتعرّف عليها ..
كان رجل يبدو من ملامحه أنّه يعود إلى أحد بلاد شرق آسيا ليحضره القدر إلى هذه البقعة من الأرض و ليجمعني فيه القدر أيضاً دون إبرام موعد مسبق معه و ليقبع على اوراقي و بين كلماتي دون أن يعلم أنّه سيمسي أحد تلك الشخصيّات ليس بين صفحاتي و حسب بل أيضاً بين ثنايا الذاكرة الدائمة لأحدهم أيضاً …
لأقول متمتمةً و كأني أخاطبه و كأنه سيسترق السمع إلى صدى كلماتي قائلة :
إنك وحيد مثلي يا هذا ، فحتى رياضتك تلك التي داوَمتَ على اتباع منهجها سنين عدداً تدل على وحدتك لأيامٍ عديدة ، فيبدو أنك اتّخذت من النّأي عن البشر سبيلاً ، مثلي تماماً ، أو على أقل تقدير خلال طقوس رياضتك الصباحيّة تلك ..
أتراه قد جاء الوقت لاكتشف أسرار هذه الرياضة التي لم أقتنع بها يوماٌ ..
لا أدري …
قطع تأملي لتلك اللحظة نهوض الطلاب الواحد تلو الآخر من ذاك المقصف لينذرني ذاك الحراك أن ميعاد الحصة الدراسية الأولى قد بدأت لتوّها أو على أقل تقدير قد شارفت على ذلك ..
دون أن أعلم أني سأعود بذاكرتي إلى هذا المكان مجدّداً وسط ساعات نهاري القادمة ..
كان قد سبق ذاك الامتحان حصة نقاشيّة عن الصّعوبات التي ستواجهك إذا ما عزمت على الهجرة ، متضمّناً ذاك الحديث عن الطّرق التي يمكنك من خلالها الانخراط بالمجتمع و تهيئة نفسك لتقبُّل الآخر متجاوزاً جميع الاختلافات بينك و بينه على اتّساعها ، سواء كانت تلك الاختلافات ثقافيّة ، لغويّة ، دينيّة ، عرقيّة ، أو حتّى إذا ما اقتصرت على اختلاف لون البشرة و حسب …
لم تكن المرّة الأولى التي يُدور فيها مثل ذاك النقاش و حول هذا الموضوع دوناً عن غيره ، فهنا كما تعلمون يا سادة موطن لما يزيد عن مئتي ألف عرق مختلف و التي تعود إلى أصول متفاوتة و أحياناً كثيرة تكن متناقضة أيضاً، كيف لا و ذاك الاختلاف يبتدء بالعقيدة و ينتهي باللّغة الأم ….
و لكن كان النقاش هذه المرة له جماليّة فريدة من نوعها و تحمل معها خصوصيّة تستجلب انتباهك الذي بدأ يتململ من تكرار ذاك الحديث على مسمعيه …
فمحدّثتنا في ذاك اليوم كانت كنديّة الأصل كما كنت قد ذكرت في خاطرتي السّابقة إلّا أنّ لها تجربة فريدة من نوعها مع الهجرة …
فقد كانت قد عزمت ترك بلادها الأم و هي في العشرينيّات من العمر لهدف يحمل معه طابع الغرابة في نظري على الأقل ..
فقد كانت قد توجَّهَت إلى كوريا لتعلّم لغتها، فقط من باب الهواية لا أكثر ، فقد كانت أحد أحلامها حينها إتقان تلك اللّغة و التّعرف على ثقافتهم أيضاً..
استقرت هناك قرابة العامين قبل أن تقرّر العودة ..
لم تكن لتعلم حينما عزمت الرّحيل إلى هناك أنّها ستقطن قرابة العامين ، بل كانت لم تحدّد مدّة لسفرها ذاك ظنّا منها أنّها لربما ستكمل تفاصيل حياتها القادمة أجمعها وسط أزقّة و حواري كوريا و بين أناسها ..
بدأ ذاك النقاش حينما طرحت علينا محدّثتنا السؤال التالي قائلة :
برأيكم ما هي أكثر الصّعوبات التي واجهتها هناك ؟
فبادرت فتاة كورية الأصل بالإجابة حينما قالت:
لغتنا بالطبع و بتعبير أصح تعصّبنا للغتنا الأم فكما لاحظتِ سيدتي، إذا ما مشيت في الشوارع و إذا ما وددت أن تستقلي القطار السريع أو حتى أذا عزمت ِ ابتياع بعض الأشياء من تلك المحال فإنّك ستواجهين العديد من الصعوبات ، فجميع ما سبق كُتبت باللغة الكوريّة و حسب ..
و ذاك أصعب ما يواجه السياح في مدينتنا ..
قاطعتها حينها محدّثتنا قائلة :
صحيح ، صدقتي ، ذاك أصعب ما قد سيواجهه السّيّاح و لكن بالنسبة لي لم اكن سائحة بل كنت طالبة أبحث عن تعلّم هذه اللّغة فكان اكتشاف اسماء الأماكن و المحطّات من أكثر الاشياء متعة بالنّسبة إليّ حينها ..
بدأ ذاك النقاش بالاحتداد و راح كل من الحاضرين يدلِي بدلوه …
أمّا أنا و ذاك الشّيء الذي يقبع بجانبي و الّذي كان ما يزال يلاحقني إلى الآن ، قد تبنّينا الصّمت ، نائين بنفسنا عن ذاك الحوار على غير عادتنا ، ربما كنا خائفين أيضاً ، ليس من مجريات الحديث و إنّما إلى ما سيؤول إليه ذاك النّقاش و إلى أين سينتهي به المطاف ..
لتنهي محدثتنا ذاك الجدال الدّائر قائلة :
” إن أكثر الأشياء صعوبة كانت دخولي إلى المجتمع الكوري ككل و الاختلاط بين أناسهم..
فالكوريين بطبعم منغلقين على أنفسهم ، يهابون الغريب و يحرصون على أن يبقوا داخل دائرتهم المغلقة…
تلك الدّائرة التي عشقوا فيها نقاطها المتّصلة ببعضها البعض و المتوضّعة على بعد ثابت من مركز تلاحمهم ذاك دون أن يكتشفوا خارج تلك النقاط و لا حتّى داخل تلك الدائرة من حيّز الفراغ المتوضع في وسطها ..
فكل فرد فيهم يعلم مكان توضعه بين نقاط تلك الدائرة دون زيادة و لا بمقدار إنش واحد أو حتّى نقصان … “
لتومئ تلك الفتاة الكورية بالموافقة و لتهدأ القاعة بضع ثوان قبل أن يبادر أحد الطّلاب بالسؤال قائلاً :
“ألهذا السبب قررت العودة يا ترى ؟ “
لا …
قالت مجيبة ثم أكملت :
بل لأني شعرت أنه لم يعد هناك ما يثير فضولي حول الثقافة ، البلد ، أو حتّى تلك اللغة ..
فبعد عامين يبدأ ذاك الانبهار الأول بالبلد الجديد عليك و الثقافة المختلفة عنك يتلاشى رويداً رويداً ..
بل إنّك تبدأ بالتمحيص و التدقيق بكل تفاصيل الحياة لعلّك تكتشف نقاطها الإيجابيّة و السلبيّة منها ..
و إذا بك تصب كامل تركيزك على تلك السلبيّة و كأنّ بلدك الأم بلد طاهر زلال كماء شلال عذب تدفّق أميالاً و أميال بين صخورٍ ذو حواف حادة ، لتصب تلك المياه على مكان أمسى كلوح زجاج مصقول ترى فيه انعكاس أعماق ذاك المكان فتنسى للحظات أن ذاك القاع يفصله عنك مئات الهيكتو مترات من المياه…
و كأنٌك بتلك الطّريقة تبرّر لنفسك قرارك بالعودة..
ذاك القرار الذي أبرمته مع روحك قبل أيام و ربما أشهر من تمحيصك الأخير ذاك…
و ما إن شارفت تلك المحادثة على الانتهاء حتى قلت معقبة كاسرة ذاك الصمت الذي أطبق فجأة على تلك القاعة و كأنّ الجميع كان يحاور صوته القابع داخله أو بجانبه ربما ، إذا صحّ التعبير ، سائلاً إياه قائلاً :
أتراني بدأت التّمحيص يا ترى ؟
و إذا بي أقول ، أم تراه ذاك الصوت هو الذي قال حينها معبراً عنّا قائلاً :
” بل إنّك حينما عزمت الرّحيل من هناك سيدتي كنت قد خاطبتِ نفسك أو لعل صوتك الداخلي هو من أخبرك قائلاً :
” ثم ماذا بعد ، ما الذي أفعله هنا ، و إلى متى ..
أتراني بعد عامين استطعت أن الحق بوكب و ثقافة هذا المجتمع أم مازلت في عداد المكتشفين أم تراني بين الاثنين ..
هل استطعت بعد كل تلك الأشهر الأيام و الساعات بطولها و قصرها أن أنسلخ عن هويتي ، لغتي ، اصلي ، أهلي ، ثقافتي ، عقيدتي و تاريخي ..
أتراهم يختلفون عني بشكل وجوههم و لونهم و حسب أم هناك فجوات أكبر لا يمكن للأيام و الأشهر و لا حتى للسّنين أن تردمها أو تقارب بينكما حافتيّ تلك الفجوة …
ألم يأتيك سيدتي ذاك الصوت يسألك قائلاً :
أنا من ؟
من أكون ؟
أنا أين ؟
ما الذي أفعله هنا ؟
و لم أنا هنا ؟
و إلى متى ، ثم ماذا بعد ؟
فإذا بوجهها يشرق مستبشراً فرحاً و عيناها علت عليهما ابتسامة رضى و راحا يلمعان كلؤلؤتين عكس عليهما ضوء ليلة مقمرة قائلة:
” قبل توجهي إلى الميناء الجوي لذالك المكان عازمة الرحيل دون عودة تذكر زارني ذاك الصوت بأسئلتك كلّها تلك مرات و مرات داخلي ، أحيانا بصوت مسموع و أحياناً أخرى بهمس لا يذكر ليمسي حديث نفسي اللا منقطع حتى عزمت على الرحيل ، كان عنوان تلك الاسئلة كلها : أنا من أكون ؟ “
فبادلتها تلك الابتسامة قبل أن يهمس ذاك الصوت في أذني مجدداً قائلاً :
أنا من أكون ..
لأعود بذاكرتي إلى ذاك الصباح حيث ذاك العجوز و لاستنبط حينها أن رياضته تلك تعبر عن صوته الداخلي ذاك ، ذاك الصوت الذي لا يجد نفسه إلا في ساعات صباحه الأولى مع تلك الرياضة التي اعتاد عليها يوماً في بلده الأم ….
صوت يصرخ دون انعكاسات تستجلبها أذن بشري …
صوت يخبره و لو لساعة من ساعات يومه أنه ما يزال على قيد الحياة قبل دخوله ديمومة هذا المكان مجدداً ..
ليزورني اليقين حينها مخبراً إيّاي أنّ لكلٍّ منّا صوت داخلي يحادثه ، يجالسه ، و يعاتبه أيضاً…
و لأستنبط في تلك اللّحظة أنك إذا ما أردت سماع صريخه ، عويله ، و حتّى شتاته عليك بالاغتراب سبيلاً….