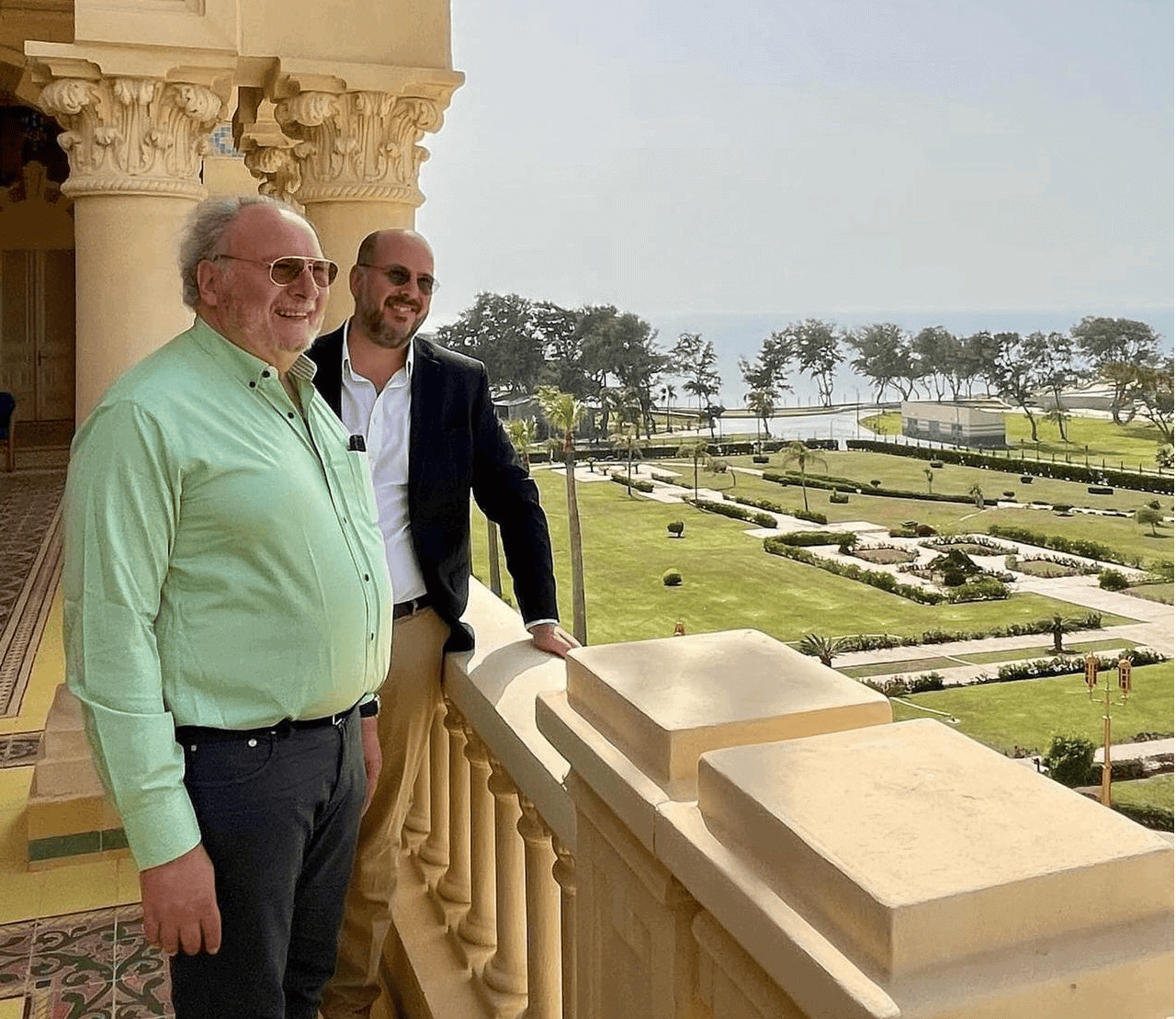مثلكم أشعر بتسارع الزمن وانعدام الإحساس بالقيمة الحقيقية للوقت.
كانت هذه المقدمة ضرورية لأصنّف نفسي معكم.. أو لنقل مع غالبيتكم.
انشغلت في صغري بعامل الوقت، وكثيرا ما حيّرني انقلاب الليل والنهار واختلاف الفصول الأربعة وعوامل الشروق والغروب، وتساءلت كثيرا عن النوم وحكمته، ولماذا ننام ولا نبقى يقظين، وكنت أستغرب الفروق بين الأجيال كبارا وصغارا، ولماذا نُخلق صغارًا ولم نُخلق كبارا، أو لماذا لا نبقى صغارا، أو لا نُخلق كبارا ونصغر إلى أن نتوارى ونفنى، ولماذا نموت أصلا، ولماذا الكد والتعب في الحياة، ووجوب العمل حتى نأكل ونلبس ونجد البيوت لنسكنها دون أن يتوفر ذلك لنا تلقائيًّا.
في الحقيقة قد كانت أسئلتي أسئلة طفولية، أو هكذا صرت أنظر لها بعد أن شببت، لتكبر أسئلتي وتصبح أكثر إبحارا في الخيال التعجيزي الذي يصعب الإجابة عليه، أو أن لا إجابة ممكنة لأحد على مثل هذه التساؤلات، التساؤلات التي تؤكد ضعف معلوماتنا وضيق أفق عقولنا الذي لم يتسع بعد ليعي إجابات وافية لمثل هكذا تساؤلات، وأنا على يقين ومتأكد أني لست الوحيد الذي يطرح نفس أسئلتي التي تشغلني.
هل نستطيع الرجوع إلى الوراء بالزمن؟ أو أن نخطو سريعا إلى الأمام به ونطلع على المستقبل؟ أو هل نستطيع إبطاءه أو إيقافه تماما ليحلو لنا فعل ما نشاء دون الشعور بأن وقتا سينتهي قبل إنجاز ما نُريد؟ أو هل باستطاعتنا أن نعيش الأمس واليوم والغد في وقت واحد؟
هي بعض أسئلة كتلك التي حدثتكم عنها آنفا، أسئلة كانت في وقتها إجاباتها صعبة إلى أن درست الفلك والملاحة البحرية في الأكاديمية البحرية وتعرفت على خط التاريخ الدولي وعرفت عن اختلاف الوقت باختلاف المكان وأن مقاييس الوقت على الأرض ليست نفسها في الفضاء أو على الكواكب الأخرى وأن التاريخ والفصول قد تختلف بين مكان ومكان في الوقت نفسه، وهذا ما يجعلنا الآن نعتقد بإمكانية الإجابة عن كل تساؤلاتنا ولكن لم يُفسر بعد كيفية تطبيقها أو إمكانية تطبيقها، فلكي تعيش بحاضرٍ وماضٍ ومستقبل عليك أن تكون نفسك في أماكن مختلفة لكي يكون ماضيك وحاضرك ومستقبلك معا. وهذا بالطبع قمة الإعجاز أو استحالة أن تكون في أكثر من مكانٍ في آنٍ معًا. أمّا أن تنتقل من حاضرٍ إلى ماضٍ أو إلى مستقبل، ما كان دائما موضوعا لأفلام ومسلسلات الخيال العلمي حول كيفية السفر عبر الزمن، وهو أمر يختلف تماما عن الواقع، لأنك إن انتقلت من حاضرك إلى ماضٍ، فذلك لن يكون ماضيك لاختلاف المكان، وبالطبع لن يكون مستقبلك إن انتقلت إلى مستقبلٍ، وأيضًا لاختلاف المكان .
اشتهرت السينما والمسلسلات الأمريكية بمواضيعها المشابهة التي تتحدث عن الانتقال عبر الزمن سواء إلى الماضي أو المستقبل وقد شاهدت يافعا الكثير من تلك الأفلام والمسلسلات لا أذكر أي من أسمائها، فأنا متابع جيد يتمتع بذاكرة رديئة تماما، وأنا أكتب الآن بانسيابية تامة تمنعني من البحث واستقصاء أسماءها، ولكني أذكر أحداث بعضٍ منها باختصار ربّ قارئ ساعدته ذاكرته على معرفة عن ماذا أتحدث.
أحد هذه المسلسلات كان لدى البطل قطة تأتيه كلّ يومٍ صباحًا بجريدة الغد التي تُكتب عن أحداث اليوم ، فيأخذ علما مسبقا بما سيحصل في المدينة من أحداث وكوارث في يومه، فيسعى جاهدا على منعها أو مقاومة حصولها في عمل درامي شيّق.
وهناك مسلسل آخر، كان البطل فيه لمجرد ملامسته بالتحية والسلام ليد من يقابله يحضر أمام ناظره فيلم يسرد له كل تفاصيل ماضي ذاك الذي سلم عليه، لتدور أحداث الحلقات بكثير من التشويق والإثارة.
لكن ذلك يبقى انتقالا بالفكر والخيال وليس بالجسد، وهذا ما عالجته مسلسلات وأفلام أخرى لينتقل فيها البطل جسدا وروحا إلى الماضي في عصور خلت، أو أن ينتقل إلى المستقبل روحا وجسدا ليعيش حياة لم تكن تخطر له على بال ولا وردت في الخيال لغرابة ما فيها.
أستدل من ما سبق على أنّ توارد الأفكار والانشغال بنفس التساؤلات ممكنا بين البشر سواء عشنا نفس الظروف والموقع، أو اختلفت ظروفنا ومواقعنا، لأننا بشر أولا وأخيرا كما قلنا، وقد خلق الله لنا عقولنا القابلة للاتساع والحشو دون حدود أو نهاية، وهي قابلة أن تحمل في وعائها كل ما نختلج فكرا ومشاعر ورغبات قد تتشابه مع شركائنا من بشر على هذه البسيطة لأن آدميتنا واحدة.
وبرغم ذلك ما زلنا قاصرين وهذه أفكارنا، عن إمكانية تحقيق ما ذكرنا من أفكار واقعا لعجز ما بإيدينا حتى الآن، من تكنولوجيا متطورة، وتفنيات تمكنا من الانتقال جسدا وروحا من زمن إلى زمن، أو أن نسرع بالزمن أو نبطئه. ليبقى سر ذلك من عظمة خالق هذا الكون ، الله سبحانه تعالى، وبقيت مسألة السيطرة على عدّاد الزمن مسألة إلهية يتحكم بها وحده.
شاهدتُ منذ مدة فيلما وثائقيا مثيرا للغاية يتحدث عن نفس الموضوع ويتحدث عن إمكانية سرعة الزمن أو إبطائه أو إيقافه على الأرض في حالة واحدة وهي أن تسرع حركة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس أو أن تتباطأ أو تتوقف تماما عن الدوران ، وهذه تحتاج كلها لقدرات إلهية وقرار إلهي يفعل بها ذلك. طبعا الفيلم يتحدث بشكل علمي لا يخلو من التوقعات غير المؤكدة عن الآثار التي ستلحق بنا كبشر وبأرضنا سواء أسرعت الأرض حركتها أو تباطأت أو توقفت عن الدوران، وجميعكم أيها القراء الأعزاء لن يتمنى لأرضنا أن تفعل ذلك إن شاهد الفيلم، وسيرجو الله ويدعوه بقلبٍ خاشع أن لا يفعل ذلك.
إذن أرضنا لم تتباطأ بعد، أو تسرع ، أو تتوقف، أو تميل عن محورها بقدرٍ يجعلنا نعتقد ببطء الزمن أو سرعته أو الخشية من وقوفه، ما يعني أن قيمة الوقت هي ذاتها من آلاف السنين وستبقى كذلك لآلاف السنين اللاحقة وطبيعة الزمن هي نفسها.
هذا يعني أيضًا، أن لا علاقة لقدراتنا بسرعة الزمن أو بُطئه وبالأسباب التي تجعل حدوث سرعته أو بطئه ممكنة، وهنا يتوجب علينا البحث في مكانٍ آخر عن الأسباب التي تصدّر لنا هذا الشعور الذي يكرهه جميعنا وأنا أحدكم.
أجمل ما قرأته في هذا الصدد عن عامل رياضي وآخر نفسي ، وإن كنت أميل إلى أن العاملين من العوامل النفسية التي تثير فينا مشاعر سرعة الزمن. وكلاهما من وجهة نظري منطقي وقابل للأخذ به.
واعْتبَرَ العامل الرياضي أن التقدم في عمر الإنسان هو سبب تلك المشاعر وقد حسبوا الأمر على النحو التالي:
إعتبار السنة الأولى في حياة الإنسان ما نسبته 100% من عمره كلّه، أما السنة الثانية فهي تعتبر ما نسبته 50% من عمره، وهكذا السنة الرابعة فهي تشكل ما نسبته ربع عمره فقط، أما السنة العاشرة في تمثل عشر عمره، وفي سنته الأربعين فهي تمثل ما نسبته فقط 2.5 % من عمره هذه في حساب الزمن والحياة مساحة من الوقت ضئيلة ، لذلك قيل أن شاب في العشرين يعيش سنته بمساحة أكبر تمكنه من معالم كثيرة بدقائقها في حياته، وكذلك طفل في العاشرة مثلا فهو يمتلك من مساحة للوقت تعطيه الكثير من الإمكانيات التي تساعده أن يحياها بطولها وعرضها دون الشعور بقصر الوقت لقضاء واجبه أو الاستمتاع بألعابه. أما من تقدم به العمر ، فإن السنة التي يعيشها تشكل له مجرد مساحة ضئيلة جدا من الوقت تنفد قبل أداء ما عليه من أعمال وواجبات، وتجعله يتمنى لو أن اليوم أطول من ما هو عليه حتى يكمل ما قصّر بأدائه.
على منطقية هذا العامل وصحة ذلك رياضيًّا، لكني ما زلت اعتبر المسألة نفسية لا أكثر ولا أقل.
وفي حديثنا عن العامل النفسي، فإن الروتين يلعب دورًا أساسيا في مشاعرنا السلبية تجاه الوقت لأننا نقوم بنفس الأعمال أو نتابع أو نعيش نفس الأحداث، والتغيير الذي يحصل بين يوم وآخر غالبا ما يكون بنسبة كبيرة في نفس السياق، لذلك تضعف الذاكرة ، ونفتقد تفاصيل كثيرة لأحداث مرت في حياتنا، ولا نعود نتذكر إلا أحداثًا بعينها مثلا ، فإننا تستطيع تذكر حبنا الأول، ويوم تخرجنا من الجامعة ، ويوم استلامكنا لعملنا، ويوم زواجنا، ويوم ميلاد أولادنا، ولكننا لا نستطيع تذكر تفاصيل كثيرة عن سنة زواجنا العاشرة مثلا أو عن السنة الخامسة من عملنا في شركة ما، وهذا سببه غرقنا في ما نفعله أو لا نفعله في يومنا وحاضرنا.
غير أنّ أمرًا آخر، أعتبره من العوامل النفسية ويلعب دورًا مهما في شعورنا بتباطؤ أو تسارع الزمن، ألا وهو حاجتنا لإنجاز أمر ما في حياتنا أو إخفاقنا في إنجازه.
أذكر أنني عندما كنت في الثانوية وفي فترة الإمتحانات، كانت بعض المواد أسئلتها صعبة وكثيرة تحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص للامتحان، وتكون الطامة الكبرى، بعد أن يمر معظم الوقت وأنا أقوم في حل الأسئلة وشعوري أنها كثيرة، ويفاجئُني المراقب بالقول، تبقى من الوقت عشر دقائق، من أصل ساعة مخصصة للامتحان، وأنا ما زلت في السؤال الثاني أو الثالث من ورقة تحتوي على أربع أو خمس أسئلة، هنا أتعرق وينشف حلقي وترتعش فرائصي، فقد مضى الوقت سريعا وتنطلق العشر دقائق المتبقية بأقصى سرعتها وأنا أفعل كل ما في جهدي أن أكتب أسرع دون فائدة تذكر أو إنجاز أكبر، فقد صاح المراقب الآن ضعوا الأقلام انتهى الوقت .
ومثالا آخرَ، حين يلعب فريقا كرة قدم ويحقق أحد الفريقين أهدافا على حساب الفريق الآخر، تجد كل فريقٍ في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني يشعر شعورًا مختلفا عن الآخر. إذ أن الفريق الفائز يشعر بتباطؤ الزمن لحاجته لإنهاء المباراة وإعلان فوزه، أما الفريق الخاسر فإنّه يشعر بسرعة الزمن، قبل أن يحقق التعادل أو الفوز على الفريق المنافس، لتمر عليه الدقائق الأخيرة كثوانٍ لم تمهله ولم تمكنه من الفوز، وهكذا نجد أن كلا الفريقين شعرا بشعورٍ مختلف لنفس المساحة الزمنية من الوقت.
وهذا المثال الأخير قارئي العزيز يوصلنا إلى خلاصة مفيدة وهامّة، مفادها أنّ الزمن هو الزمن والمساحة الزمنية للوقت هي نفسها في كل عمرٍ من أعمارنا. الفارق الوحيد بين مرحلة ومرحلة هو ما يتحقق من إنجازات، أو ما يلحق بنا من إخفاقات، وذلك سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي والواقع العام المحيط والبيئة التي نعيش فيها. بمعنى أننا لو أردنا الاستمتاع بوقتنا بمساحته الطبيعية دون الشعور بسرعته أو بطئه، علينا أن نعمل ما بوسعنا أن لا تكون حياتنا متكررة، وأيامنا معادة، وأن نعمل على إنجاز ما يفيد لنا ولمجتمعنا ولأمتنا.
وليس هناك من إنجاز أعظم من أن نعمل لآخرتنا كما نعمل لدنيانا، على نفس المبدأ الذي يعنيه الحديث الشهير المبهر والقيّم الذي اختلف في نسبه ولم يُختلف بصحته، سواء كان للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أو لسيدنا علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهَهُ وأرضاه أو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.