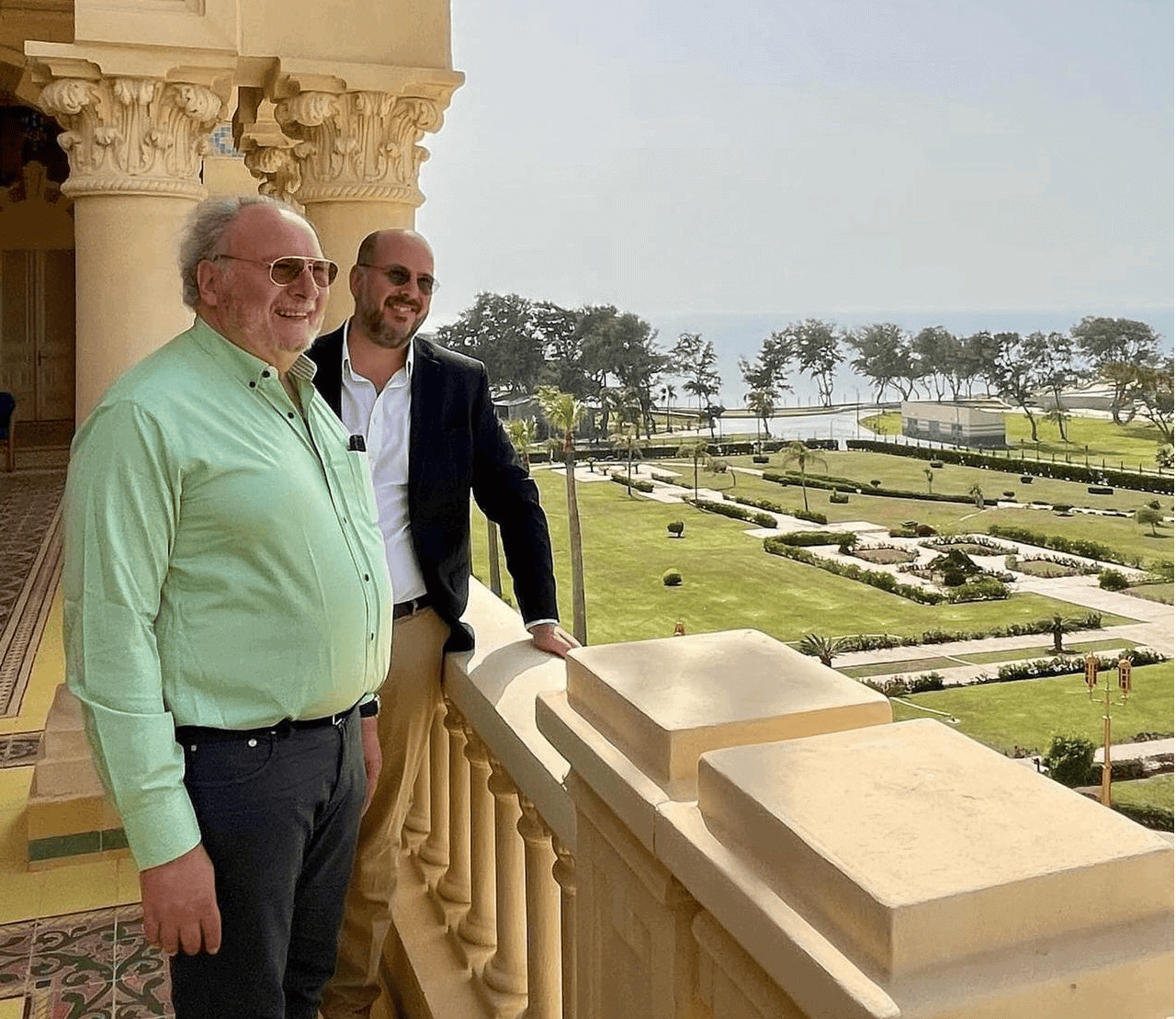أظن أن كل من كان يراهن
على الانتخابات الرئاسية المصرية لتكون فرصة لتغيير المسار، وتصحيح الاتجاه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قد أفاق من هذا الوهم، على حقيقة أكثر مرارة تتمثل في أن مسلسل الانحدار نحو الهاوية مازال مستمرا.
لكن قبل الدخول في التفاصيل، هناك إضاءة ضرورية..
مصر ليست شأنا مصريا صرفا، بل هي شأن جميع العرب، لأنها القاطرة التي تجر خلفها بقية الدول.. ولهذا عندما تكون مصر في كامل عافيتها، فإن كل محيطها يستفيد من هذه العافية، وعندما تَوْهن فإن الوهن يسري على الجميع..
لقد كانت مصر بالنسبة لجيلي وما قبله، وحتى بعض ما بعده، هي “أم الدنيا” فعلا.. فالأدب في مصر، والفكر في مصر، والرواية في مصر، واللغة في مصر، والدين في مصر، والفن في مصر.. والصحافة في مصر.. وحتى عندما سقطت “أسهم” النظام السياسي بعد كامب ديفيد، في بورصة المشاعر العربية، ظلت هذه المجالات خارج المقاطعة..
فمصر كانت دائما أكبر من نخبتها ومن حكامها وساستها..
ولهذا لو نجحت التجربة الديموقراطية في مصر لتغير مجرى التاريخ في العالم، وليس في المنطقة فقط..
ويبدو أن جزء كبيرا من “النخبة” المصرية الحالية لا تعي هذا الواقع جديا..
ولذلك تحولت مصر إلى حديقة خلفية تعلب فيها دويلة خليجية صغيرة، بل صار قرارها السياسي والاقتصادي يصنع في المكاتب المغلقة، في إمارة تخترع اليوم تاريخا لأنه ليس لها تاريخ بل لم تكن أصلا مذكورة في أي تاريخ..
ولذلك صغرت مصر حتى أصبحت تناكف دولة خليجية أخرى، وتدخل معها في معارك تخسرها مسبقا..
ولذلك أصبحت مقولة “مصر هبة النيل” من الأرشيف، بعدما صار مصير مصر معلقا على كرم أثيوبيا وسد نهضتها..
لم يعد زئير أبي الهول يخيف أحدا.. بل تحول إلى مواء..
إن الحل ليس في سب كل من يقدم نصيحة أو يعبر عن رأي في ما يجري في مصر -خاصة إذا لم يكن مصريا- .. وليس في اتهامه بالانتماء للإخوان، أو بالعمالة لإسرائيل أو أمريكا.. فالكل يعلم أن القاهرة أصبحت مجرد شارع صغير من شوارع تل ابيب..وصورة الرئيس المصري واقفا عند رأس الرئيس الأمريكي في مكتبه البيضاوي اختزلت كل الكلام الذي يمكن أن يقال عن سقوط مصر التي كانت “في خاطري”..
لقد كان يوم 25 يناير 2011، فرصة لن تتكرر حتما، لبناء دولة ديموقراطية عصرية وقوية، ولفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم.. لكن شاءت إرادات خارجية عكس ذلك.. وهذا أمر متوقع..
لكن غير المتوقع كان هو الإرادات الداخلية ممثلة في “النخبة” المصرية.. التي شاركت بفعالية وحماس في قتل هذا الحلم المشروع..
إن النخب الحقيقية هي التي تضع مصلحة الشعب والوطن قبل كل شيء، لا التي تعدل مواقفها تبعا لحصتها من الغنيمة..
لقد كانت الفترة التالية لـ 25 يناير، لحظة حاسمة لتأسيس الدولة الديموقراطية.. فلو سمح للمؤسسات المنتخبة يومها بالاستمرار، إلى نهاية مدتها الدستورية، لما سالت كل تلك الدماء، ولما انحدرت مصر إلى ذيل القائمة حتى في التصنيفات الخاصة بقطاع التعليم..
ولعل من مؤشرات انحدار مصر، أن السيناريو الذي نجح فيها بسهولة شديدة، وبكل تفاصيله، فشل بشكل شبه تام في تونس والمغرب..
لقد قبلت “النخبة” في مصر أن تكون الجسر الذي عبر من خلاله الجيش للانقلاب على إرادة الشعب.. وظنت أنها ستحصل بالدبابة على ما لم تستطع الحصول عليه بالصناديق”..
وقبلت أن تكون مخلب “الخارج” و”الخليج” لخدش صورة الربيع العربي..
والعجيب أن هذه “النخبة” مازالت مصرة على المكابرة، وحتى من امتلكوا شجاعة الاعتذار فعلوا ذلك بشكل ملتبس.. وربما فقط لأنهم لم يحصلوا على نصيب من الكعكة..
في تونس كان هناك مشروع أكثر من انقلاب، منذ الإطاحة ببن علي لكنها فشلت كلها، بفضل وعي الشعب والنخبة..
أموال الخليج التي صرفت لدفن ثورة الياسمين فشلت عموما.. ولو أنها حققت مكاسب طفيفة، لأنها اصطدمت بإرادة الشعب ووعي جزء كبير من نخبته..
مناورات الخليج لم تنجح حتى في المغرب..
تغريدات الشرطي الإماراتي الشهير حددت تواريخ لإسقاط الحكومة المغربية المنتخبة، فجاء الرد من صناديق الاقتراع بما لا يدع مجالا للمناورة..
أتحدث عن نموذجي تونس والمغرب، ليس من باب المفاخرة أو المقارنة، بل كمدخل لسؤال : كيف تفشل مصر بكل تاريخها ومفكريها وعلمائها ومبدعيها وإشعاعها الإقليمي والدولي في استغلال لحظة 25 يناير للانطلاق نحو الآفاق الرحبة؟ وكيف تنجح دويلات ولدت قبل أقل من نصف قرن، في التحكم في مصير دولة تجر خلفها تاريخا حافلا وحضارة عمرها آلاف السنين.. وتحولها إلى ملعب هي كرته التي تتقاذفها الأقدام؟
الجواب على هذا السؤال لا يكون بالسب والشتم وتوجيه الاتهامات المجانية.. ولا بالوطنية الانفعالية.. بل بالنزول إلى أرض الواقع..
لو كان توفيق الحكيم رحمه الله حيا كان سيكتب ربما جزء ثانيا من “عودة الوعي”، أو لربما اختار عنوانا أنسب للمرحلة “نهاية الوعي”..
إن المصريين عموما، ونخبتهم على وجه الخصوص، مطالبون -وهذه نصيحة وليست أمرا- بالاطلاع على وجهة نظر الآخر، مهما كانت صريحة وجارحة.. لأن هذا الآخر، ينظر إلى الصورة كاملة، ومن خارج المعمعة..
كيف ينظر هذا الآخر إلى خطابات الرئيس المصري الحالي التي تحولت إلى وصلات للكوميديا السوداء؟
كيف ينظر إلى فضيحة البحث عن مرشح للمنافسة الشكلية من الأحزاب، والحال أنه كان أفضل البحث عنه في نقابة المهن التمثيلية، لأن المطلوب كومبارس لا مرشح؟
كيف ينظر إلى وصلات “الردح” البذيئة والمتواصلة عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها وألوانها وتسريباتها؟
كيف ينظر إلى “النخبة” السياسية الحالية التي تمارس أي شيء وكل شيء ما عدا السياسة؟
كيف ينظر إلى الرضى الإسرائيلي التام عن النظام المصري الحالي؟
كيف ينظر إلى التماهي التام مع مواقف الرئيس الأمريكي الحالي الذي يعارضه حتى حلفاء أمريكا التقليديون؟
كيف ينظر إلى كون العالم الحر يعارض الانقلابات في أدغال إفريقيا ويفرض على الانقلابين عودة الحياة الدستورية، لرفع العقوبات، بينما يغض الطرف عن انقلابات مصر وكوارثها؟
كيف ينظر إلى عدم شعور “النخبة” المصرية بالحرج، بل وبالخزي، وهي تسمع والدة ريجيني تقول :”إنهم عاملوا ولدها كما يعامل المصريون”؟ هل انحدرت إنسانية المواطن المصري إلى هذا الحد؟
ربما يرى البعض أن الجواب على هذه الأسئلة بسيط، ومن سطر واحد : إنها المؤامرة الكونية على مصر.. لكن الواقع اليوم، يشهد أن المؤامرة الوحيدة على مصر كانت من نخبتها.. وهذا ما سيكتبه التاريخ .. في النهاية.
قبل أكثر من تسعين سنة، قال سعد زغلول وهو على فراش الموت، لزوجته -رحم الله الجميع-: “شدي اللحاف يا صفية .. مفيش فايدة”..
“مفيش فايدة”.. في الدواء؟ أم في السياسة؟
اختلفت الروايات والتفسيرات، لكن حال مصر اليوم، يؤكد أنه لا فائدة في الدواء لأنه من نوع “جهاز الكفتة”.. ولا فائدة في السياسة، لأن “زعيم” حزب متولد من حزب “الوفد”، قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم “زوج تحت الطلب” لكن من غير ليلى علوي ولا هالة صدقي..
* كاتب من المغرب