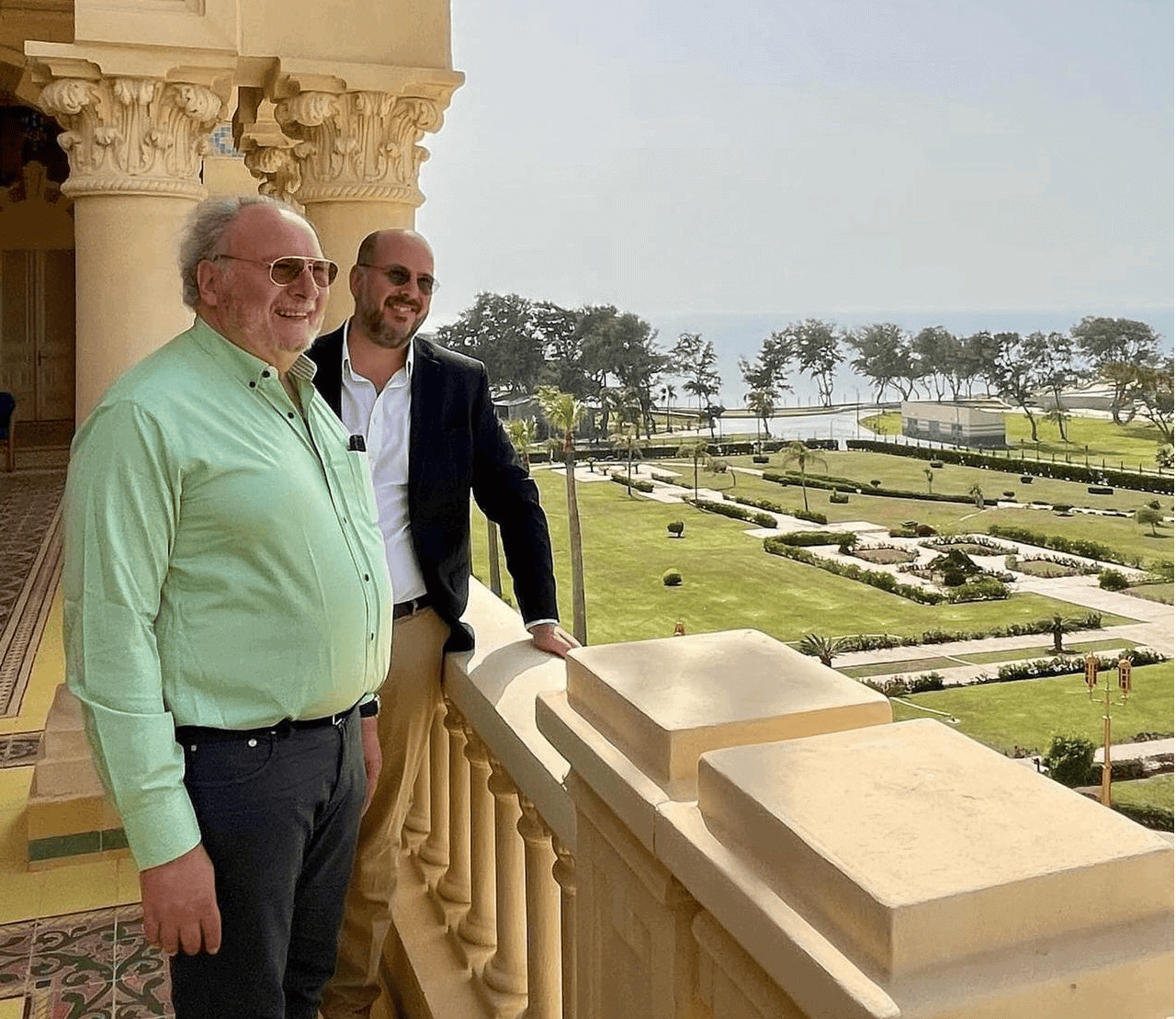وطن- كانت أغصان الأشجار ترسم يخيالاتها لوحة جميلة على حائط غرفتي بعد أن أعلن الليل بدء انتهائه و اكتسى الظلام زوايا الغرفة إلا بصيص نور النافذة و خيالات الأغصان المرتسمة بقربي كل ما هبت نسمات الليل و سمع للأشجار صوت حفيف فالساعة كانت قد تجاوزت الثالثة بقليل ..
فتلك الليلة لم تكن كسائرها لباساً لي على الإطلاق ، كيف لا و كل صفات تلك الكلمة كان قد راودني عكسها آنذاك..
فاللباس هنا لا يقتصر معناه بالطبع على ستر جسد الانسان و حسب و لا على ستر عيوب ذاك الأخير و حسب بل إنما أيضا يفترض لذلك الليل أن يلبس أفكارنا بسكونه فيوقف بظلامه الرهيف ذاك تدافع أفكارنا و ازدحامها ليتركها مخدرة متجمدة تجلس في مكان ما من الذاكرة غير قادرة على الحراك تنتظر بزوغ شمس النهار على من تقطن فيه لتعلن نشاطها مع بدء نشاط ذاك الأول و لكن هيهات فتلك الليلة كانت معاشاً لأفكاري فظلام الليل لم تكن لها بمثابة مؤشر للسكينة و الاستسلام لبحر الأحلام ، فيبدو أنها لم تعد تثق بالأحلام بعد الآن سواء أكانت في يقظتها أو حتى في نومها ..
إن ما أقلق ليلتي و جعل من تلك الليلة سبباً لعدم استقرار نهارات و ليال تلتها و ذاك لاختلاف ساعات النوم و اليقظة في عقارب ساعة جسدي الدفينة سببه بضع ساعات مضت من تلك الليلة ، و بالرغم أنها ساعات تعتبر بضع دقائق من ساعات عمر مضى إلا أنها استجلبت معها كل ذاكرة العمر ، و كانت كفيلة لتؤرق راحتي و تطرد شبح النوم ساعات و ربما ليال لتتركني ضريحة للسهر أعلن صباحاً جديداً لليلٍ لم ينم …
جلست على كرسيِّ الذي كان يقبع بالقرب من نافذتي ، و إذا بي أنظر من خلالها نحو نوافذ ذكرياتي متناسية تلك الأغصان المترنحة ليتلخص ظلام ذلك الليل بوجه كان قد استقر في ثنايا تلك الليلة قبل الذاكرة بملامحه و تقاسيمه الشقية و بشرته الداكنة حين قال :
مهاجر ..
أنا مهاجر ..
ماذا تعني تلك الكلمة ..
تعني الكثير يا سادة …
ليس كما تظنون ..
فأنا سأقوم بإخباركم لكي لا ينتابكم الفضول ..
كانت لغته الفرنسية لا توحي لك أنه مهاجر ، فإذا أنت اكتفيت للاستماع إليه مغمضاً عينيك عن شكله الذي يخبرك أنه لا ينتمي بأصوله إلى هذه الأرض فإنك لن تستنبط ذلك على الإطلاق ، فهو لم يكتف بأن يتعلم لغة هذا المهجر و حسب بل إنه كان قد امتص لكنةً تميّز بها سكان هذا المكان عن بقية الناس ممّن يتكلمون الفرنسية ..
ذاك الشخص كان أحد الممثلين في مسرحية تتحدث عن معاناة الكنديين مع المهاجرين الجدد الذين لا ينطقون بعد أحد اللغتين اللتين يتحدثونها في هذه المقاطعة ألا و هي الفرنسية أو الانكليزية بالطبع ..
ليدخل ذاك الممثل قاطعاً معاناتهم مخبراً أياهم عن مقدار حجم معاناته و صغر معاناتهم نسبة إلى ما يعانيه ..
دخل ليقطع سيل من الضحل اللا منقطع في فقرة كانت قد سبقت كلماته تلك ، فيثبت بذلك أنه ممثل رائع أو ربما ليخبرنا أنه لم يكن بمثِّلٍ حينها ، و لعلّه لم يبذل جهد في تجسيد تلك الشخصية أيضاً ، لينتاب جميع الحاضرين لحظات من التأمل و استشعار ما قيل قبل أن يغادر تلك المنصة ، و يعود المكان إلى ضجيجه الأول و ضحكات الحاضرين ..
بالفيديو.. عكاشة يفتح النار على الجميع.. ويقول: 30 يونيو كانت مسرحية
كان مكان بسيط لا يخبرك أنه مسرح على الإطلاق ، فلم يكن يوجد منصة كبيرة كما المعتاد ، و لم تكن هناك ستارة و لا حتى معدات كانت قَد زيَّنت تلك القاعة لتخبرك أن هناك عرض مسرحي يمر من هنا كل ليلة ، فقد أكتفوا بتلك الدائرة التي كانت قد دلدلت من سقف ذاك المكان و التي كانت تحمل شكل بعض من القطع الخشبية الغليظة و التي اتصلت إحداها بالأخرى لتشكل دائرة أو شبه دائرة لتوحي إليك على الفور بغرابة مجهولة المصدر تماماً كذاك المكان ، فهو مسرح أقرب إلى الواقع ، مسرح يخبرك ببساطته أنك لن تشاهد أشخاص أُستخدموا كأدوات لتجسيد نص قطن الأورق أيام أشهر و ربما سنوات خارج حدود الواقع و بعيداً عن الحياة ، فما ستشاهده اليوم هو شيء قد عشته بالفعل أم تُراك سوف تعيشه في يوم من الأيام أو لحظة ، لحظة لم تكن لتتوقع قدومها يوماً على الإطلاق ، وذلك ما حصل بالفعل حين أكمل قائلاً :
أنا يا سادة من بلدة صغيرة جميلة ، ليست رائعة الجمال ، و لكنها جميلة ، جئت إلى هنا كمهاجر ، ليس لأن في بلادي حرب ، على الإطلاق ، فأنا لست سورياً بالطبع فاطمئنوا ..
قال جملته الأخيرة مشيراً إلى وجهه و لون بشرته الداكنة تلك التي يغطيها بعض خصلات من شعر رأسه الجعد القطط ، رافعاً تلك الخصلات قليلاً قبل أن يكمل قائلا :
جئت إلى باريس ..
مشيت في شوارعها ..
مزدحمة ..
مليئة بالناس ممتلئة بالأحداث ..
شوارعها لا تتصف بالواسعة و لكنها تحمل من القصص الكثير الكثير ..
في تلك اللحظة كنت أود أن أقاطعه و أخبره الكثير ، أقاطعه لأخبره بأعلى صوتي قائلة :
و أنا مهاجرة ..
مهاجرة جئت إلى هذه الأراضي ، و لا موعد لي للقاء مع الذاكرة و لا الذكريات ..
أنا يا سيدي مهاجرة و لكني قدمت من بلد غرقت من بكاء الثكالى و نحيب االثيِّبات …
بلد أغرقتها الحرب في بحر من الظلمات ..
فأنا يا سادة سورية الأصل ، قادمة من بلد باتت للحرب عنوان حين بدأت أحداث ذاك الموطن الذي لم يعد بالموطن دون علم لنا أو خبر و دون سابق إنذار و لا حتى صافرة ذاك الأخير ، أتت لتتركنا حائرين لا نعلم أترانا سنشهد شارة الانتهاء يوما ً فتُسدل الستارة أم ستبقى يا وطني أسيراً لتلك المسرحية ، ليبقى فيها الممثلون ذكرى و عابرون سبيل في مجرياتك و بين أحداثك ..
ليعيدني من أفكاري تلك صوته من جديد قائلاً :
صحيح أنني كنت أمشي في تلك الشوارع الضيقة و أسمع مقتطفات من حديث المارة و ضحكاتهم ..
و صحيح أنني لم أكن أفهم لغتهم تلك…
و صحيح أن قدمي كانا قد توّرما من طول ذاك المسير إلا أن ذلك كله يبقى أفضل بكثير من العودة إلى بيتي ..
بيتي ؟؟ أتراه بيتي ؟!!
أقصد ذاك البيت ذو الجدران الباردة …
قالها متأتئاً متلبكاً…
لا تحزن يا هذا قلت مجدداً ..
فإنك تتسم بالحظ و تمتلك منه الكثير ..
فأنت لربما إذا ما مشيت في تلك الأزقة سمعت بعض الضحكات و انتابك الفضول حول بعض الكلمات فأنا هنا يا سيدي في هذا المغترب الذي يمتلك من الشوارع الواسعة الكثير و من الأماكن العامة الكثير الكثير لم أجد من الناس إلا القليل القليل ، و قلّما ما يوجد أناس يتحادثون أو حتى يضحكون ..
.فيا سيدي يبدو لي أنك تمتلك من البخت الكثير الوفير …
هل تعلمون لماذا ذاك كلّه أفضل من ذاك المنزل ؟!
قالها بصوت أقرب إلى الصراخ ليقطع حديث نفسي اللا منقطع ..
قالها فارداً ذراعيه يلتفت برأسه يمنة و يسرة يحاكي الحاضرين ، لتطفئ الأضواء إلا واحداً كان قد أُسقط على وجهه قبل أن يُنزل رأسه نحو الأرض ماشياً بخطوات توحي بالخذلان تارة و الوحدة تارة مجيباً سؤاله الأخير ..
و من أين لكم يا ترى أن تعلموا و من كيف لكم إن تستجلبوا المعرفة ..
فكيف لإنسان لم يرى البحر أن يستشعر جماله في ليلة صيفية عكست صورة قمرٍ توضع في سماء تلك الأمسية و عَلى أمواجه الهادئة و كيف لذاك الإنسان الذي كان الجهل عنواناٌ للبحر بين مفرداته و صور ذاكرته أن يهابه في ليلة عاصفة كحلاء ماطرة ؟
فبالطبع أنتم لا تستشعرون صعوبة العودة إلى ذاك المنزل و لن تستشعرون ..
ففي ذاك المنزل
لا صوت يذكرك بأنك تستطيع أن تسمع و لا سؤال يجبرك أن تجيب لتسمع صوتك الذي بت تشتاق إليه ..
في ذاك المنزل توقف كل شيء ..
صوت الأهل و الأصدقاء ..
ضحكات الأطفال
بكاءهم ..
توقف كل شيء ..
كل شيء
إلا الزمن و صوته
فهنا قد اكتشفت أن للزمن صوت …
كيف ؟
يكفيكم أن تستمعوا إلى تكتكات عقارب الساعة كل مساء لتخبركم أنكم تتقدمون بالعمر يا سادة ..
يا سيدي قد جئت إلى هذا المسرح أجلس على مقعدي هنا قاصدة الضحك متلمسة صوت القهقات ..
جئت لأبحث بين الوجوه عن ابتسامة افتفدتها الشوارع ..
فإذا بك تسرق من عيني دمعة أخرى ..
لتصمت حروفي و لتنطق تلك الدمعة راسمة سيل من الحروف على وجنتي …
صوت بداخلي قال لي أن أعود ، صوت لم أستطع أن أسكته ..
قال من جديد قاطع دمعاتي ..
أعود
الآن أعود إلى أين أعود
نحو ماض لن أستطيع الانسجام معه بعد الآن ..
يبدو أنه علي البقاء..
البقاء …
كيف لي أن أبقى و لماذا و لمن علي البقاء و من سيأبه لمكان وجودي أو حتى لعودتي .
من أكون ..
أخبروني يا سادة أنا من ؟
من أكون ..
أنا ماضيَّ أم حاضري .،
أنا من ؟
ليقطع حبل الكلمات تلك صوت آخر كان يجلس على كرسي مظلم قبل أن تتوجه الأضواء إليه كاشفة عن وجهه الذي يوحي أنه مهاجر آخر ، هاجر من مكان ما إلى هنا ، مكان بعيد عن اصل ذاك الأول و بعيد أيضاً عن هذا المكان ..
صحيح أنه كان على الكرسي لكنه لم يكن يجلس كما المعتاد ، فقد كان قد رفع قدميه فوق ذاك الكرسي ليجلس القرفصاء ، مغمضاً عينيه ، واضعاً يديه على ركبتيه ، مطأطئ الرأس هامساً :
أنا مثل شكسبير ..
نعم أنا مثل شكسبير حين قال ..
أكون أو لا أكون …
نعم في هذا المغترب لا سبيل آخر لك ..
إما تكون و إما لا تكون ..
ليصدر صوت من العدم يعقب قائلاً :
إن المهاجر قد لا يستشعر يد ابنه الصغير اذا ما شدَّ طرف ثوبه طالباً منه أمراً ما خاصة في هذه المرحلة ، فإثبات الذات ليس لنفسه و حسب و لا لمن حوله و حسب و لا لابنه إذا ما كبر وسط وحدة و وحشة هذا المغترب و حسب بل حتى لماضيه الذي تركه منطلقاً نحو المجهول ، فأحياناً لا يقتصر إثبات الذات خوفاً من الغد بل لربما كان يهاب ماضيه أكثر من يوم سيتلو حاضره الذي يحمل من الغموض و الجهل الكثير فهو لم يُكتب له أن يراه بعد فلما يهابهُ ! ..
مسحت بيدي زجاج نافذتي بعد أن غطاها طبقة ضبابية من برودة ذاك الخارج قبل أن أعاود الجلوس و أنا أهمس ..
لقد صدق ذاك الصوت في تعبيره ، فهنا إما أن تكون أو لا تكون..
فإما أن تخلق لك حيز في هذه البقعة من الأرض وسط مسننات تلك العجلة التي ارتكز كل مسنناً فيها آخذاً مكانه منذ زمن ليس بقليل قبل قدومك هذا المكان و إما أنك ستبقى كقطعة خردة تنتظر أن تأخذ دورها إذا ما تهالك أحد تلك المسننات يوماً ، فتغدو أسير الإنتظار و ربما أسيراً للموت البطيء أيضاً ..
فصحيح أن الأديب الانجليزي : ” شكسبير ” حين أرفق تلك المقولة على لسان ” هاملت ” الشخصية الرئيسية لمسرحيته التي أتخذت ذات الاسم أيضاً ، كان يخبر بها عن وجع تلك الشخصية بعد أن تسبّبت بالكثير من موت الأبرياء و لم تعد تعرف أكانت حياتها ذات فائدة أم لا ؟
و صحيح إن ” هاملت ” حينها لم يكن يعلم هل يا ترى ستكون حياته أسهل أم موته و هل حياته بعد الحياة ستحمل معها اللين أم أنها ستغدو قاسية تماماً كحياته قبل ذاك المزعوم ، خاصة أنه كان يهاب ذنب قتل نفسه ..
إلا أن ذاك ليس بعيد عن شعور المهجر ، فبالطبع الانسان هنا لم يقتل شخصاً تلو الآخر بهدف الانتقام لشخص مات إلا أنه و بالوقت نفسه لا يستشعر أنه دفيناً و أن روحه قد تشوهّت وسط تلك العجلة إلا حين يمسي تائهاً في أمره لا يعلم أتراه مسنناً بها و أداة يغير بها دفة ذاك الفُلك الذي يقوده نحو مستقبل يأمل بأن يكون أجمل ، أم يا ترى هي التي تتحكم بدفة فُلكه بعد أن أصابتها عاصفة ضربت عرضها فبات كقبطان لا يملك من أمرها شيئاً سوى الاتكال على الله و التسليم بقضاءه عز و جل ، آملاً أن يرى صباح تلك الليلة و أن يرسو على يابسة و ضفة أمان حتى و لو كانت ضفة لمكانٍ هُجر منذ زمن فلم يجد له بها صديق أو قريب ..
Thèâtre la licorne
مسرحية : foirèe montrèalaise