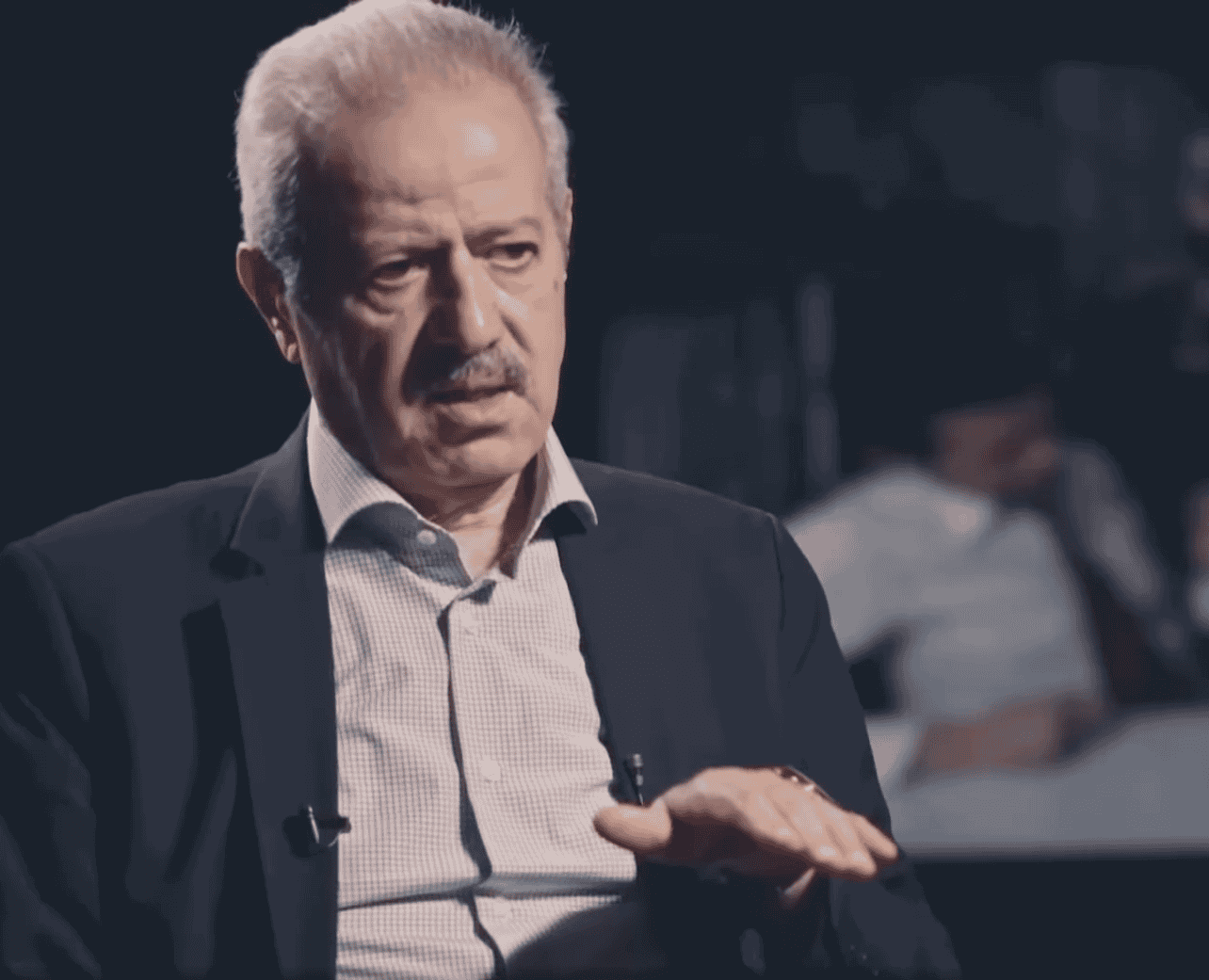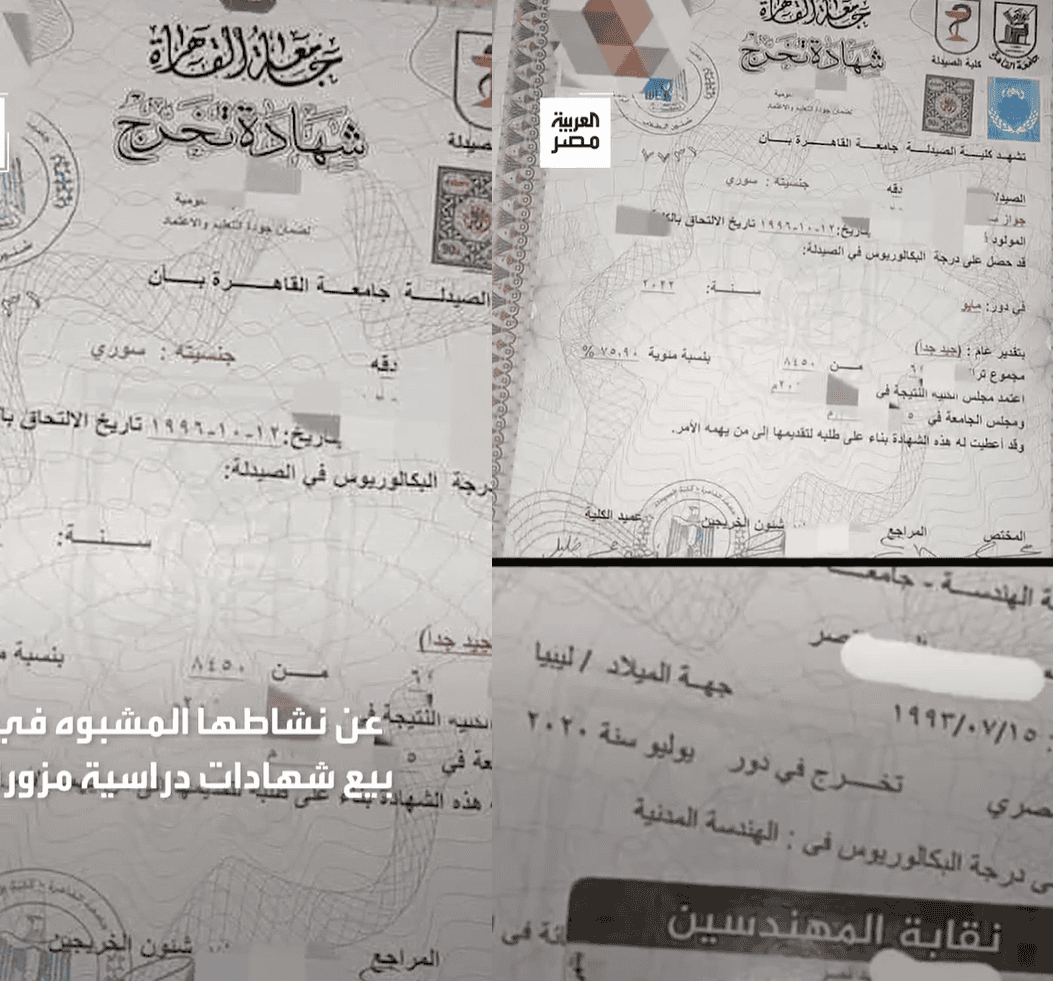محطَّات خالية و أخرى مكتظّة ممتلئة ، مقطورات تصفر فيها الرياح و أخرى ازدحمت بها روائح العابرون و أنفاسهم الغليظة ، و أدراج باتت للرائي مظلمة مخيفة هُجرت منذ زمن و أخرى تكدّست عليها الأقدام لتمسي للناظر أنها مستسلمة مقيّدة خلف ذاك الشريط الأصفر تبحث لها عن مخرج و جواب ، جواب عن أسئلة كثيرة تعتلي صدور المتواجدين حينها دون كلمة تذكر ، فكلمة ” الخطر ” التي كُتبت على ذاك الشريط و جسمان كل ممّن ارتدوا ذاك الزي الأسود ناصبين قامتهم خلفه كان كفيلاً بأن يُصمت أصواتهم برهة من الزمن و ربما أكثر ، لتجدهم ملتزمين الصمت ليس خوفاً منهم ، بل لأنهم تبنوه قلقاً على أرواحهم بل و خوفاً على تلك الجثامين ذي الرّداء الأسود أيضاً ، فهنا قد استنجدوا بالصمت ليخرجوا هم و من يقبع لحمايتهم من ذاك الخطر سالمين غانمين آمنين ، فخوفهم ذاك كان خوفاً على أرواحهم و أرواح من كان معهم لا رهبة و لا رعب من مجموعة من البشر ، علّهم يخرجوا من خلف ذاك المكان بأمان شاكرين بعضهم على أنهم اِلتزموا الهدوء ممتنين لمن قاموا بحمايتهم ، فيخرجوا سوياً من دائرة الخوف عوضاً من أن يغرقوا بها ، فالخوف هنا لا يقبع حدوده عند شخص أو اثنين ، و لا يسلط من قبل مجموعة ، فئة، طائفة أو طائفتين ، فهنا إذا ما استشعرته يوماً يَكُن حكراً على سلامتك ، يتواجد ليحمي روحك لا ليرهبها ..
بل انّه لا يُسلَّط عليك بل أنت من تسلطه على روحك و بإرادتك إذا ما استشعرت غرابة في إحداثيات المكان و الزمان ، هنا على هذه الأرض ، فحتى الخوف بين جدران هذا المغترب تقوم بتطبيقه تماماً كما وصفه علماء النفس حينما نعتوه بأنه شعور يسلطه الانسان على روحه دون تدخل خارجي إذا ما استشعر بخطر ما .
و إذا بنا نشهد زمان كان فيه ذاك الشعور مستورد تماماً كمَلبَسَنا ، مشربنا ، غذاءنا ، و حتى ضمائرنا المجمّدة ، فنستجلبه من الغير ، لنتفاجئ أنّه و على عكس ما سبق من الأمثلة أمسى موجوداً داخل حدود موطني و بين أزقته ينتشر كمرض سارٍ ، يورِّده أحدنا للآخر ، فيمسي ذاك الخوف له رائحة نتنة تشتمّها من على بعد أزقة ، شوارع و أميال ، لنجد أنه ما أن يدخل مدينة ما حتى يحوُّل أهلها إلى أشباه بشر و إذا ما زار قلب أحدهم لا يخرج منه إلا و قد استنزف آخر قطرات رحمته مستأصلاً مع ذاك الأخير إنسانيّته فيمسي الحقد داخله كقيحٍ اعتلى نهاية جسد ما بُتر أحد أطرافه دون سبب أو علّة فلا هو يُشفى و يلتئم و لا هو عاد قادراً على استرجاع ما فقد ، لنعلم حينها أن الموت لأناس فارقوا دنيانا كان أرحم لهم من العيش في عالم الخوف ذاك ، و لتخبرنا الحياة أن خوفنا لم يكن يوماً من الموت ، كيف لا و كثيرة هي الأحيان التي نتمناه فيه ، لعلمنا أنه قد يمسي أرحم بكثير من مجارات الأحداث أو حتى استيعابها ، فنكتشف أن خوفنا كان و مازال نابع من أنفسنا و مسلّطاً منها و عليها أيضاً ، كإحدى فراشات الليل التي تبحث لها عن ضوء وسط ظلام ليلة كاحلة فإذا ما استشْعَرت نور أحد المصابيح حتى راحت تركض نحوها لاهثة ملتمسة ذاك الشُعَاع ظنّاً منها أنه المنجى الوحيد ، دون أن تعلم حينها أن ذاك النور المصطنع هو الذي سيحرق أجنحتها و هو نفسه الذي سيكتب لها أجلها المرسوم ، فما نحن إلا تلك الفراشة إذا ما استشعرنا ذاك المنعوت ، فنجد أننا بُتْنا نصحو و نمسي داخل سجنه الأبدي ذاك …
فليس الجدران فقط التي تسلب حريتنا و لا حتى السجون ، و لو أنه هو المفهوم المتعارف عليه وسط مجتمعاتنا ، فما نكاد ننطق كلمة سجن أو سجّان حتى يخيَّل إلينا معناه الحرفي ليس إلا و لكني أرى أن هناك سجون أكثر ظلمة من تلك ، سجون تقبع فينا و تعيش بيننا و حتى تتنقل معنا ملازمة خطواتنا .
فان هذه الحياة بما رحبت ما هي إلا سجن يدخله المرء منذ أن يعلن صوته الأول دخوله تلك الحياة و بتعبير آخر دخوله ذاك السجن .
فاننا بمجرد ان نكبر ، تكبر معنا أشياء كثيرة و منها قضبان تلك الحياة .
فما أن يعتلي أنفسنا خوفاً من شيء ما حتى نسجن أرواحنا داخله تائهين باحثين لنا عن مخرج من تلك الحجرة و القضبان ، قد نجده يوماً و قد نبقى أسرى بين جدرانه أعواماً و أعوام لنكتشف في كثير من الأحيان أن ذاك المخرج لم يكن إلا مخرجاً لأجسادنا و حسب .
فقد ندرك أحياناً أن تلك القضبان زارتنا يوماً بالفعل و لكن على هيئة انتظار، كانتظار خروج كلمة من فِيْهِ أحدهم بفارغ الصبر أو الخوف من خروجها أحياناً أخرى ، أم تراه في انتظار صوت قد اشتاقت الروح إليه أو ترقب عزيز قد جف بجفاه دمع المُقَل أو ربما جفّ لوجوده ، دون أن نستشعر بأن أيام من عمرنا تتبخر و تختفي كقطرة ندى توضعت على إحدى أوراق الخريف الحمراء بعد ليلة ماطرة لتزورها شمس الصباح بعد أن بدّدت أشعّتها غيوم ليلة مضت لتصبح تلك القطرة أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول أن تتبخر ذاهبة دون عودة فلا يستشعر غيابها أحد كوجودها تماماً و أما الخيار الآخر فهو أن تزيد على ورقة الخريف تلك عبء ثقلها فتسقطها أرضاً لتختلط تلك الأخيرة مع تراب الأرض ، و لتمسي أعمارنا سواسيّة مع تلك القطرة ، فيهرم داخلنا من ترقب الغد ، و إن كانت أعمارنا قد دلّت على اقتبال العمر حينها ، كيف لا ، و نحن قد اتخذنا من ذاك الانتظار عتبة نجلس عليها خلف قضبان الخوف تارة و الحلم تارة أخرى …
فحتى حين نسترق الملاذ لأنفسنا من ظلم قد استحكم مدينتي و أهلها المستضعفين تجدنا خلف قضبان الترقب و ذاك أعلى درجات الخوف ، و ما نكاد نظن أننا قد كسرنا إحدى تلك القضبان مطلقين لأقدامنا العنان ، هاربين من حضن وطن بارد حتى تستقبلنا مخاوف أخرى تأتينا بأشكال مختلفة لتستقر داخلنا و نحن في حضن غربة بات حتى دفؤها مستعار .
فليس القضبان و لا الجدران دلالة على السجن و وجود السجان ، فكثير هي الاجساد المقيدة و لكنها تمتلك أرواحاً حرة و العكس صحيح ، فنشعر أن حتى أرواحنا باتت مقيدة تشتكي العزلة و تئن من غرابة المكان و الوجوه و تبكي ضحكة باتت ميتة ..
و هنا يحضُرني قول الشاعر ” أدونيس ” :
” أقسى السجون و أمرها تلك التي لا جدران لها ”
فلا الجدران سجون و لا رقعة الحياة تدل على حريتنا ، فكم من أرواح تجدها قد لفظت أنفاسها الأخيرة بالرغم من أنها مازالت سجينة داخل أجساد أصحابها و كم من أرواح بات لها دور في حياتنا على الرغم من فناء أجسادها التي كانت تقطن فيها يوماً فلا الموت دلالة على الفناء و لا الحياة دلالة على استمرارية البقاء ، فكلنا راحلون ، و لكل منّا نهاية ، و لكن منا من كان لوفاته ميعاد واحد و آخر كان له ميعادين أو أكثر …
و بالعودة إلى ذلك اليوم حيث محطة القطار السريع و ذاك الشريط الأصفر ، جلست في تلك المقطور مودّعةً ذاك الشريط القابع على الطرف الآخر من وجهتي آنذاك ، ظناً مني حينها أن ذاك الحشد وحده من سيقبع خلف ساعات الانتظار و إذا بتلك المقطورة التي كنت قد اعتليتها نَيَّف من الزمن قد بدأت بتخفيف سرعتها على نحو مفاجئ لتقف عند أحد المحطات الخالية من الناس أيضاً فتطفئ أضوائها معلنة نهاية تلك الرحلة قبل وصولها محطتها الأخيرة ، على أن تعاود المسير إذا ما تمت معالجة ذاك العطل التقني أم لعله الأمني لا أعلم ..
كانت وجوه من شاركوني تلك المقطورة حائرة ، بعضها اتَّخَذ من السلالم سبيلاً خارج تلك المحطة و أخرى استسلمت للنوم داخلها منتظرة أن يوقظها نداء آخر يعلن معاودة عمل ذاك المكان من جديد .
و أما أنا فلم أشعر إلا و أفكاري تلاحقني مرة أخرى ، مقتحمة ذاك الصمت ، مسرورة أنها وجدت لها منفذاً وسط أحداث يومي الممتلئ لتسرح بي مجدداً ، فكان ذاك الصمت هو أكثر ما حفز تلك الذاكرة و كأنه قلم أضناه قلّة الاستخدام فأخذ يدفق من حبره يمنة ويسرة دون أن يعلم له بداية لكلماته ، نهاية ، و لا حتى هدف فذاكرتي كانت تماماٌ كذاك القلم …
لأطرق باب أحد ذكريات الضجيج التي كنت أتأفأف منه يوماً و كأني اشتاق ذاك الدويّ الصاخب و كأن هذا الهدوء اجتمع ليغرز في صدري أسهم صمته علّه يدرأني قتيلاً و إذا بي أهرب من سكين ذاك الوُجُوم بأحد المشاهد التي كنت قد عشتها يوماً في القاهرة .
كان يوماً من أيام تلك المدينة التي قضيت بها قرابة العام قبل مجيئي هذه الارض ، يوماً قد دق به البندول ليعلن عن قدوم صباح آخر من صباحات ذاك المكان ، بندول لم يكن معلقاً يوماً بساعة و لكنه كان يأتي في ذات التوقيت كميعاد أسبوعي خصص لأيقاظي بل و ضبط لإزعاجي حينها ، دون أن أعلم أنني سأشتاق جَلْجَلَة إزعاجه ذاك يوماً ما ، بندول كان يمسك به يد إنسان دُلدلَ من أحد الشرفات المطلّة على شرفة غرفتي ، لتؤرق آهات سجادة جارتنا العفنة بعد أن راحت تضرب عليها بتلك العصا المهترئة منامي ، و كأن تلك العصا ستزيل آثار السنين و تمحي أقدام العابرين عليها لآلاف المرات ، بساط بات أشبه بقطعة قماش مهترئة احتفظت بكل آثارها ناسيةً أنها كانت يوماً بيضاء اللون ، إذا لم تخنّي عيناي ذاك الصباح و اذا ما استطعت حينها ان استشف لونه الأول القابع خلف أحداث السنين حزينة كانت أم سعيدة …
توجهت لأفتح نافذتي علِّي أنفض غبار أفكاري التي بدأت باكرةً ذاك النّهار لأتفاجئ بريح غبراء تلطم وجنتي الدافئتين فأغلقتها مسرعة بعد ما دخل قليلا من ذاك الغبار اللعين حنجرتي فأجبرني على السعال ، أغلقتها متمتمةً حينها قائلة :
” بربِّ السماء ما الذي تنظّفينه أيتها الجارة ؟
أتنفضين غبار سجادتك المتعفنة في جو مقتر ؟
يا لهذه المدينة التي لم أفهمها يوماً ”
سرحت يومها قليلا ثم قلت ربَّاه أتراني في بعض من خيالاتي مجدداً !
توجهت مسرعة الى الماء علِّي أغسل وجهي من ذلك القَتَام و أمحي غبار أفكاري معه ، فتحت الصنبور و أغلقته مرات عدّة و لكن دون جدوى ….
خرجت غاضبة صارخة سائلة :
أين الماء؟ أين الهدوء؟ أين الهواء العليل؟
ليقطع صوت صراخي حينها ضحكات والدتي قبل أن تستدرك قائلة : إنها في دمشق يا بنيّتي !
إنها في دمشق يا صغيرتي !!
نعم صدقت يا أماه ..
إنها في دمشق يا عزيزتي !!
أم تراني أقول كانت في دمشق يا رؤوم !!
قلت جملتي الأخيرة بصوت مسموع كسر جدار ذاك الصمت القاتل ليلتفت إليَّ من اعتلى تلك المقطورة آنذاك ، فلغتي العربية أقلقت نومهم المخمليّ ذاك ..
فحين أذكرك يا دمشق أنسى مكاني و زماني ، أنسى خوفي وحاضري ، ماضيّ و حتى غدي ، ليربتط ذكراك بذاك البيت العتيق المتوضّع في ازقتك الضّيقة و ممراتك الحجرية اللا مستوية ، ذاك البيت الدمشقي القديم الذي إذا ما مرَرْتَ أمامه حتى تسمع له صوت يخبرك فيه عن الماضِ عن أناس قطنوا هناك عن ذكرياتهم همومهم و أفراحهم بل حتى عن أحلامهم ، سواء تلك المحقّقة منها أو التي لم يُسطِّر لها القدر خروجاً إلى النور فتمسي أسيرة جدرانه ، باحثة لها عن نافذة تنقلها من الحلم إلى الحقيقة أعواماً و أعوام منتظرة ذاك الأوان ، ربما كُتِبَ لها المجيء يوماً و ربما لم و لن يحن ذاك الأوان بعد ، فتبقى عالقة بينها تتنقل وسط ساحات ذاك البيت حيناً و بين أحواض الجوري و شتلات الياسمين الدّمشقيّ أحياناً أخرى ، أحلاما قد أكملت الدّرب مع أصحابها و أخرى دُفنت معهم و ربما قبلهم أيضاً .
فتلك الجدران كانت شاهدة على الأيام تكتب تاريخك يا دمشق و تروي أجمل الحكايات في بيت تستشعر به الأصالة و التاريخ ، المودة و الرحمة ، السّكينة و الرضا .
حتى الهموم و مشاغل الحياة كان لها طعمٌ آخر ، بيت ليس رمزاً لك يا دمشق و حسب بل هو عنوان تتلخص فيه حكايتك و معلَم يُستدلّ به إذا ما تاه أبناءك مبتعدين عنك سواء أكان ذاك البعد قسراً أم طواعية ، فهو مرساة لحبّك و دليل شاهد على ماضيك ، هو حاضر يعانق أيام و ذكريات أناس سبقتنا الى عشقك و تزينت قلوبها باسمك ، و مستقبل يكمل طريقه مرتبط بذاك الحاضر الملتف على ذاك الماضي المجيد و أناسه الشرفاء ، تماما كنبتة ” المجنونة ” التي نبتت و اِلتفَّت على جدران ذاك البيت القديم و تعرّشت على نوافذه لتتزين به و تزين أروقته و فسحاته ، فارتبطت به تماما كأرواحنا ، كيف لا فقد كان أول تفتّح لأزهارها على جدرانه و أول نسيم كانت قد تنشقته و اشتمت رائحته فيه و أول صوت سمعته كان ينبع من داخله حيث خرير الماء و آخر سكوت لليل و ظلام حفّ بأغصانها كان داخله إذا ما أغلقت أنواره معلنةً حلول ذاك الظلام و أول عشق قد شهدت عليه كان تحت تلك النافذة التي ترصّعت بها.
أتراني أصف حالنا أم حال تلك الزهرة يا تُرى ؟
قلت مقاطعة ضجيج ذكرياتي من جديد علّي أنفض غبارها من على كاهلي تماماً كغبار ذاك البساط و لكن هذه المرة بصدى كلماتي وسط ظلمة الحاضر و قتامه لا صوت مضرب تلك الجارة وسط ذاك القَتَر ، لأستنبط حينها أن كلماتي تلك كانت تصف حالنا لا ذاك المكان و حسب ، فما نحن إلا نبتةً خرجت من تربتها لتضيع في مكان ما تبحث لها عمّا يرويها كما السّابق و لكن هيهات .
و اذا بصوتٍ يعلو على ضجيج الذكريات ذاك معلناً انتهاء تلك الدقائق الثقيلة يخبرني فيه أن زيارتي القصيرة لصندوق ذاكرتي قد انتهت ذاك المساء على أمل أن يغدو ذاك الصندوق يوماً أكثر رحمة و أن يمسي ضجيجه أجمل و هدوءه أسلم ..
فذاكرتي في تلك اللحظة باتت كالعيسِ الأهيم الذي سُيّب في صحراء قاحلةً جرداء ، و هو محمّل بالماء الذُّلال ، فأضناه الظمئ و أعياه جفاف جوفه فإذا به يتخبط بحثاً عن قطرة ماء تدخل فِيْهِ أو حتى يسترجعها من داخله و لكن هيهات ، ليمسي ضريح العطش دون أن يعلم أن ضالته تقبع فوق ظهره و بين سِناميه .
و لكن على ما يبدو أن ذاكرتي حينها قد غدت أكثر استرجاعاً نسبة لذلك العيسِ ، فأخذت ترتشف من ذاكرتي حينها ضجيجها المتّقد ، علّ ذاك الضجيج ينفذ يوماً فيسافر مفارقاً إياي دونما عودة ، يوماً يكون فيه ضجيج اللّقاء أعلى من ضجيج ذاكرتي المتقد ..
بين قَتَرَة الماض و هَبْوَته و قَتَام الحاضر و هَبَاءه .
القاهرة / مونتريال .