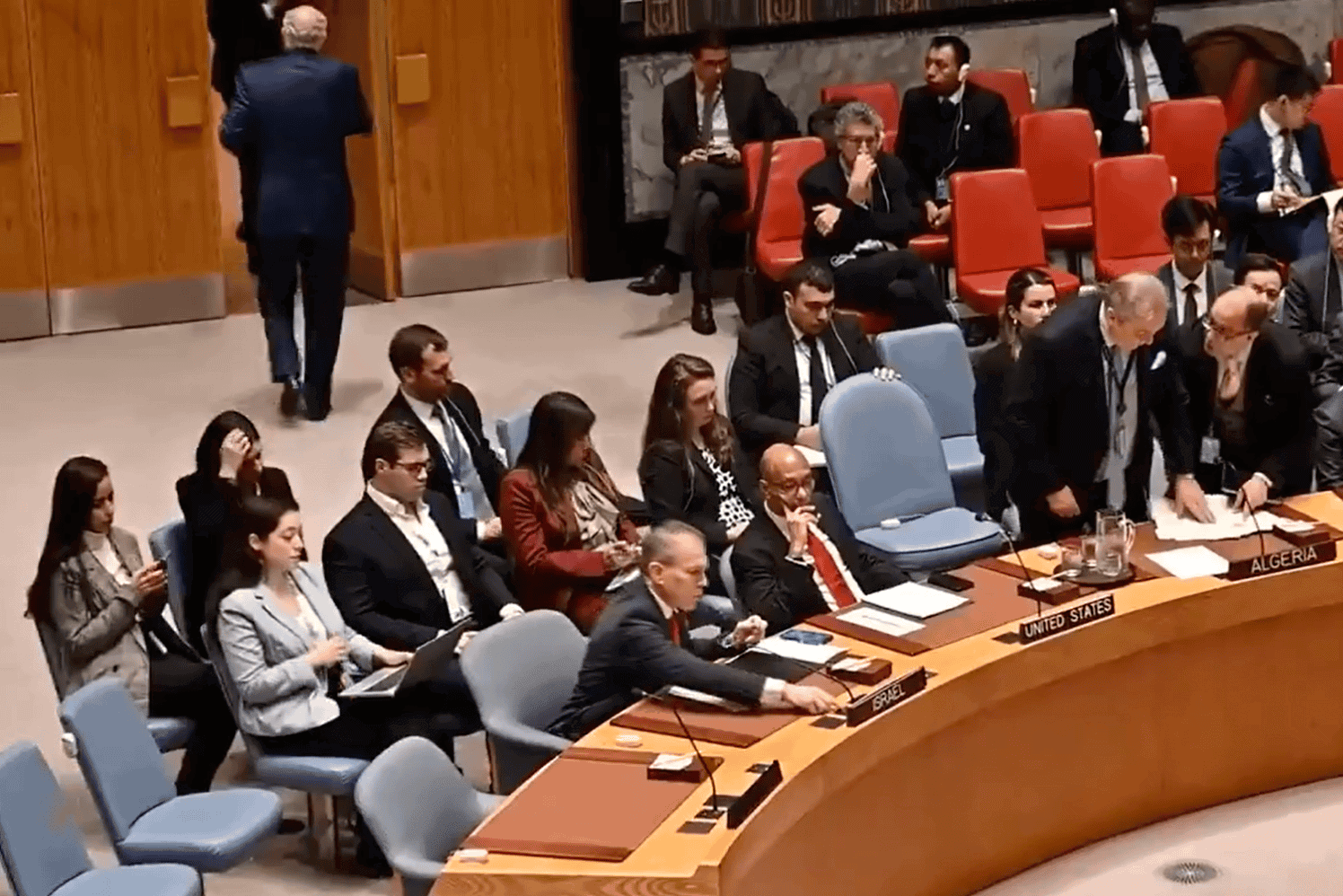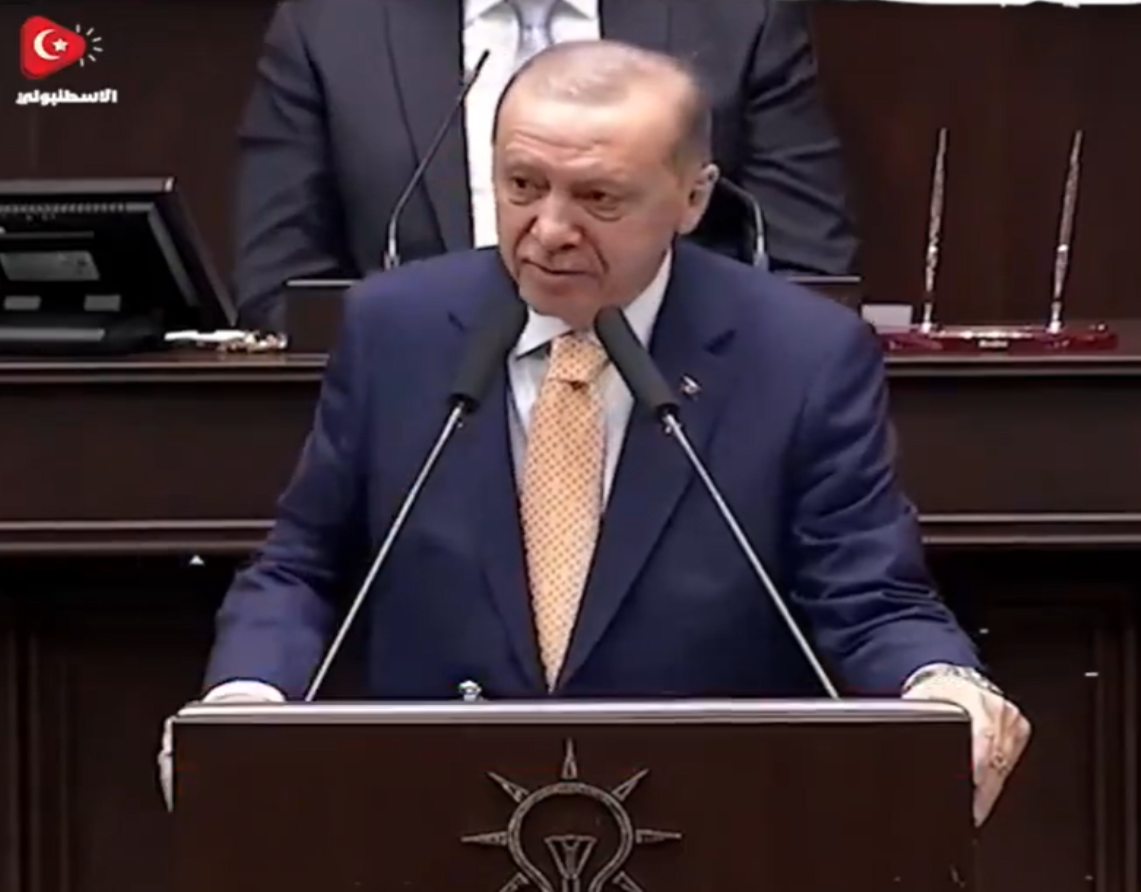نحو قرابة خمسة أشهر مضت ، حيث كان ميعاد لقياه الأخير قبل انقطاع رؤياه ، آملين عودته من جديد ، لقاء لا يعدّ بقريب البتة ، إنه ميعاد ينتظره هنا كل من دبّ على أرض هذا المكان ليستأنف نشاطه من جديد ، فهو موعد آخر مو مواعيد تقلبات الفصول و تغيّراتها ، موعد فيه تزور معالم الحياة هذه المدينة ، فها نحن اليوم نستضيفها مجدداً مرحبين مهلّلين ، لتضفي على واقعنا بعضاً من الحياة التي افتقدنا صوتها ، فحتى الحياة يُسمع لها أزيرٌ و صوت ، فإذا ما صرَخَت بها عاصفة ثلجية جعلتها حياة بلا صوت بل و بلا حياة ، فترى الناس ملتثمين متراكضين و ربما كثيرة هي الأحيان التي تشاهدهم فيها متعثرين منزلقين ليس في ديمومة تلك الحياة و حسب بل حتى على أرصفتها بعد تشكل طبقة سميكة من صقيع قطرات مطر أعقبت ليال ثلجية طويلة وسط أجواء تعادل درجة حرارة اعتدال جسم الانسان و ذلك برسمه على الورق و حسب على أن يُزاد أو ينتقص إشارة السلب أو الإيجاب ، فهنا هو رقم توضع تحت درجة الصفر المئوية جاعلاً هذا المكان أشبه بثلاجة كبيرة زارعاً في أجساد المارة و ربما في أرواحهم أيضاً برد أيام ليال و أشهر فلا نعلم حينها هل تُراه تجمّد هذا المكان أقسى أم هو تجمد أفئدة أخذت من برودة هذا المكان غيض من فيض أم لعله فيض من فيض !
فيبدو أن الطبيعة أيضاً تهدي نفوس البشر شيئاً من قساوتها ، برودتها ، و شيئاً من عواصفها التي أن هي غابت عنا أشهر الصيف ، تركت لنا منها ذكرى قد تجده بتصرف و بنظرة ، همزة أو حتى لمزة من أناس بت أشاركهم ذات المكان و ذات الهواء و هذا أكثر ما بات يقلقني …
و هَكَذَاحتى يعلن صوت الحياة عودته من جديد فترى السناجب استفاقت من سباتها الشتوي إذا ما صح التعبير و تسمع للصباح صوتاً إذا ما فتحت نافذتك و إذا ما مررت تحت شجرة عادت للعري من جديد حين خلعت ثوبها الثلجي ذاك الذي أبرد أغصانها أشهر لتستعيد تلك الأغصان رؤيتها للشمس مجدداً متمردة عمّن كان يحولها عن ذلك فتشعر ببعض الدفئ في داخلك فلا تكتفي بالحمد بل تجد نفسك تقرأ تراتيلاً من الأدعية علّ ذاك الدفئ يزور داخلنا من جديد فيذيب جليد أرواحنا الذي سكن داخلنا أشهر طويلة قبل عودة هذا النسيم العليل …
وجهةٌ ، أملٌ و حزن آخر ، على أن ألتقيهم جمعاً مجدداً إذا ما استمرت أنفاسي تتصاعد معلنةً وجودي يوماً آخر في ديمومة هذا المستقر الذي كُتب له حينٌ و أجل ..
كل واحدة منهنّ اجتمعت مع الأخريات و لكن في يومين مختلفين و قاعتين اثنتين بعيدتين قريبتين ، قد تُبعِد بينهما شارع أو اثنين و ربما حلقة من حلقات الذاكرة ام تراهما اثنتين ، ليبقى القاسم المشترك بين الحدثين هو الوجوه الحائرة و العيون التائهة بعضها قبعت في وجه مسن و أخرى في شاب و أكثرها إيلاما كانت تلك المتوضعة في وجه طفل أو اثنين لا لربما عشرة أو عشرين بل لعلهما عينين اثنتين زارت كل تلك الاعين فغزت بسهام حزنها بؤسها و ضياعها كل الوجوه التي كنت قد رأيت و ذكرت ..
لم يكن بداية أسبوعي بداية جيدة و لم تكن نهاية أسبوع سبقه توصف بالجيدة على الإطلاق …
فرغم اختلاف كلا القاعتين و ابتعاد مكان أحداهما عن الأخرى و رغم اختلاف الناس ليس بملامحهم و حسب بل حتى في مستوياتهم الثقافية، ملبسهم ، حديثهم ، توجهاتهم و ربما أحلامهم أيضاً إلا أن تلك النظرة الخائفة من الغد المترقبة و ربما الحزنة راحت تزور داخلي واحدة تلو الأخرى فلم تكتفي أنها جعلت من عينيَّ أداة تلتقط كلمات تلك العيون دون أن تنطق تلك الأفواه حرفاً واحداً بعد ، بل عاهدت نفسها على أن تجعل من روحي كفاً غليظاً شبيه بذاك الذي يستعمل في لعبة ” البيسبول ” الشهيرة فتتلقفها مثل كرة تائهة في ذاك الملعب تبحث لها عن هدف و لكن دون جدوى …
فحتى الوجوه لها لغة مشتركة ، فحينما تصمت الأصوات و تضيع الحروف في بحر الكلمات حينها فقط تنسج الأعين مئات من الأحاديث تاركة الشفاه صريعة الصمت تحارب علّها تستجلب حرف واحد من ذاكرة الكلمات ، تلك الكلمات التي طالما اعتدنا على استجلابها و التي كانت هي وسيلة التعبير الوحيدة لتأتي لغة العيون ضاربة بمفهومنا الأول عن اللغات و الكلمات عرض حائط وعيينا الأول و الأخير لنغرق ببحر من الكلمات التي لم تنطق و ربما لن تنطق يوماً تاركة إياها أسيرة تلك النظرات مختبئة خلف تلك الوجوه متصارعة بين خروجها من شفاه مالكها أو البقاء متأرجحة بين ثنايا روحه جاعلة منا أشباه بشر فنتأرجح بين الحقيقة ، الأوهام و ربما الأحلام ..
لم تستطع تلك العيون من أن تكبح الروح وقتاً جماً لتتراكض الكلمات معبّرة متأرجحة تهزّ بصداها صمت المكان لتتراقص بوقعها على أوتار أرواح كل الحاضرين و لتستبق الرقص على أبواب روحي أولاً قبل الآخرين ، كلمات ربما لم تعبر عن حجم ألم صاحبها إلا أنها أختزلته و جمعت آلام الحاضرين و ذاك ما إن بدأ المشرف يعلن نهاية يوم آخر من ديمومة الأيام و تواليها ، و لكن و قبل نهايته دعوني أولاً أن أعود إلى بدايته حين جلست في تلك القاعة الخالية إلا من بعض المشرفين قرابة النصف ساعة ليطلعوني على بعض النقاط الهامة التي يتوجب عليّ ذكرها في تلك الندوة ليفاجئني تعقيب إحدى المشرفات على فقرة من فقرات ذاك الكتيّب حينما قالت ” دعينا لا نطلعهم على هذا القانون ، بل دعينا نفعل ما يلي …
سنخبرهم عن قانون هذا المكان على أن لا نذكر أحد حروف كلمة ” موت ” فلربما تترك عندهم انطباعاً سيئاً و لربما تذكرهم بماض لم يستفيقوا منه بعد .. ”
تلك المشرفة ليست من حقوق الانسان و لم تعمل يوماً مع شؤون اللاجئين هنا ، هي مجرد إنسان ، إنسان اتسم بالانسانية دون أن يعوّل عليها مصلحة ما و دون أن يستجلب له الأنظار و دون أن يوظفها تحت اسم دولة ما و لا حتى دين معين ، فقد اختارت أن تحيا انسانة تتسم بخُلْق ديانات كثيرة جاءت آمرة به فشوهت أيادي انسانيتنا التائهة سمات ديننا الحنيف تماماً كما شوهت أدياناً أخرى سبقتها ..
لم استفق من وقع تلك الكلمات إلا حين راودتني تلك المشرفة بسؤال مباغت قائلة :
” ترى لماذا علت وجهك تلك الابتسامة ؟ أتراني أخطأت التقدير ؟ ”
يا سيدتي إن أفكاري هذه المرة هي من أخطأت التقدير لا كلماتك الحكيمة الجميلة تلك و لكن دعيني أطلعك على أمر ما إذا ما سمحت لي بالطبع ؟
أني اسمعك و كلي أذان صاغية قالت معقبة تبادلني الابتسامة من جديد ..
يا سيدتي لم يعد ذكر تلك الكلمة يخيفنا بعد اليوم بل لعله لم يخيفنا يوماً و على وجه الخصوص اليوم ، فما نحن فيه الآن هو أصعب من الموت و أصعب من الولادة فلا نحن نستطيع أن نجلب لأنفسنا حياة كريمة و لا نحن بتنا قادرين أن ننهي تلك الحياة بتخبطاتها و مآسيها ، فنمسي عالقين تماماً كإمرأة انتابها مخاض صعيّب أو عجوز استشعر سكرات الموت فكلاهما لا يعلمان كيف و متى و إلى أين سينتهي بهما ذاك المطاف …
دقائق كانت كفيلة بأن تجعل تلك القاعة القابعة في معهد اللغة ذاك مكتظة تعلو بها الأصوات بعد توافد الناس كأفواج متفرقة راحت تدخل تلك البوابة الواحدة تلو الأخرى ..
ما أن بدأ ذاك الاجتماع يقترب من إعلان نهايته حتى بدأت القاعة تضج بأصوات التعقيبات و راحت الأسئلة تتوافد متعاقبة متتالية دون انقطاع يذكر إلى أن وصل إلى مسمعي تعقيب استوقفني دقائق و أسدل ليس عليّ و حسب بل على كل الحاضرين صمتاً أطبق على أنفاسنا و كأنه يذكرنا بضعفنا و هشاشة أمرنا حين قال ..
هلّا أعطيتِني مكبر الصوت ذاك فهناك ما أود أن أعقب به علّك تساعدينني في إيصال تلك الفكرة للمشرفين ، فإذا بي أومئ برأسي موافقة قبل أن يتناول ذاك الأخير مكبر الصوت و يبتدأ الحديث قاطعاً أحاديث جانيبة و همهمات ثانوية حين أعقب :
يا سادة إننا نعاني من أمر هام هنا ، فنحن هنا لم نعد نمتلك من ثقافتنا علمنا و خبرتنا بين دروب الحياة عملية كانت أم علمية شيء ، فهنا أنا و أنت ، كبيرنا و صغيرنا ، بات لهم واحد كيف لا و نحن لا نفقه حتى لغتهم لنحاورهم و نجادلهم بعلمنا ناهيك أنّهم لم و لن يعترفوا يوماً بمسيرتنا العلمية و لا العملية إلا حين نبعثر من أيام عمرنا القادمة سنين عدداً ، سنين أخرى ستضيع و تُمسي هباء منثورة غير التي قضيناها في وطأة الحرب و بين النيران ، فماذا عسانا فاعلين و كيف لنا أن نخبرهم أننا مثقفين متعلمين و جامعيين ؟؟
لتصمت حروفه حينما استشعر ضعفه و حشرجة صوت بكاءه الخفي قبل أن يلقي إليّ بمكبر الصوت ذاك طالباً مني ترجمة ما قاله لتوّه ..
كان رجل يقترب لقرع باب الخمسين من عمره أو ربما أقل بقليل ، عرّف عن نفسه قائلاً : أنا لاجئ أنا سوري مثلكم وطأت بقدميّ هذا المكان لأول مرة منذ بضعة أيام جئت لا أعلم لي حاضراً و لا يمكنني أن أتوقع مستقبلي و حتى أمسي بات عبئاً عليّ فأنا يا سادة لاجئ …
كانت الأعين تنظر إليَّ مراقبة مترقبة الإجابة حين كنت قد بدأت أشعر بأن صُدغي أصابه ماء بارد على حين غرة و كأن السقف بات غيماً يمطر فيتوضع بحبيباته على جبيني ذاك دون غيره من الأماكن ..
قطع دهشتي تلك صوت المشرفة من جديد تسألني عمّا يحدث ؟ و ماذا عساه هذا الرجل يود أن يخبرهم ؟ ، فرحت أقصُّ لها تفاصيل ما يجري وسط أنظار الحاضرين لتجيبني بكلمات بسيطة لم أعد أذكرها علّها تستجلب من خلالها تهدئة قلوب باتت للقلق عنوان و للخوف مستقر و متاعُ ، لتذكّرني تلك الكلمات بكلمات شبيهة رحت أعيدها مرات و مرات على فتاة في السابعة من العمر في يوم سبق ذاك اليوم لقاعة شبيهة و لكن في مكان آخر ، مكان رغم سعته إلا أنني استشعرت ضيق مساحته حينما رأيتها تجمع كل الأوراق التي وضعت في ذاك المكان ، ترتبهم حيناً و تتأملهم حيناً آخر ثم تستطرد قائلة ” لقد جمعتهم لكي أدرس ، لابد أن أدرس ، بات عمري سبع و لم أرى المدرسة بعد ، كم أرغب برؤيتها .. ”
تلك الفتاة تركت لدي أثر لن أنساه يوماً كيف لا و إذا أنت ما استمعت لكلماتها تلك دون النظر إليها لما استشفّيت و لا حتى خمّنت أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة فأحلامها و أهدافها تساوي أحلام الكثيرين من أبناء موطني الأم و ربما تتعداها أيضا …
كنت في طريق عودتي حين استوقف قدماي صوت خرير ماء كان ينبعث من مكان قريب ، لأجد نفسي على أطراف أحد أنهار هذا المكان استرجع ذكريات هذين اليومين و كأني أخاف عليهما من الضياع و كأن الحزن بات رسمٌ دائم في جدران الذاكرة و كأنني بت أُدمن وجوده و كأن باب الذكريات تأبى أن تفتح نافذة الفرح مجدداً فلعلها خائفة حائرة و تائهة أيضاً…
ليقطع حبل أفكاري تلك صوت آخر من أصوات الحياة ، كان هذه المرة صوت لنوارس اجتمعت فوق سطح هذا الماء العذب ، لتطرق باب أسمُعي نعيق ” زمَجِ الماء ” ذاك ، ليخبرني من جديد أنني مازلت على قيد هذه الحياة أم تراني داخل قيدها و بين أكبالها ….
مونتريال – كندا