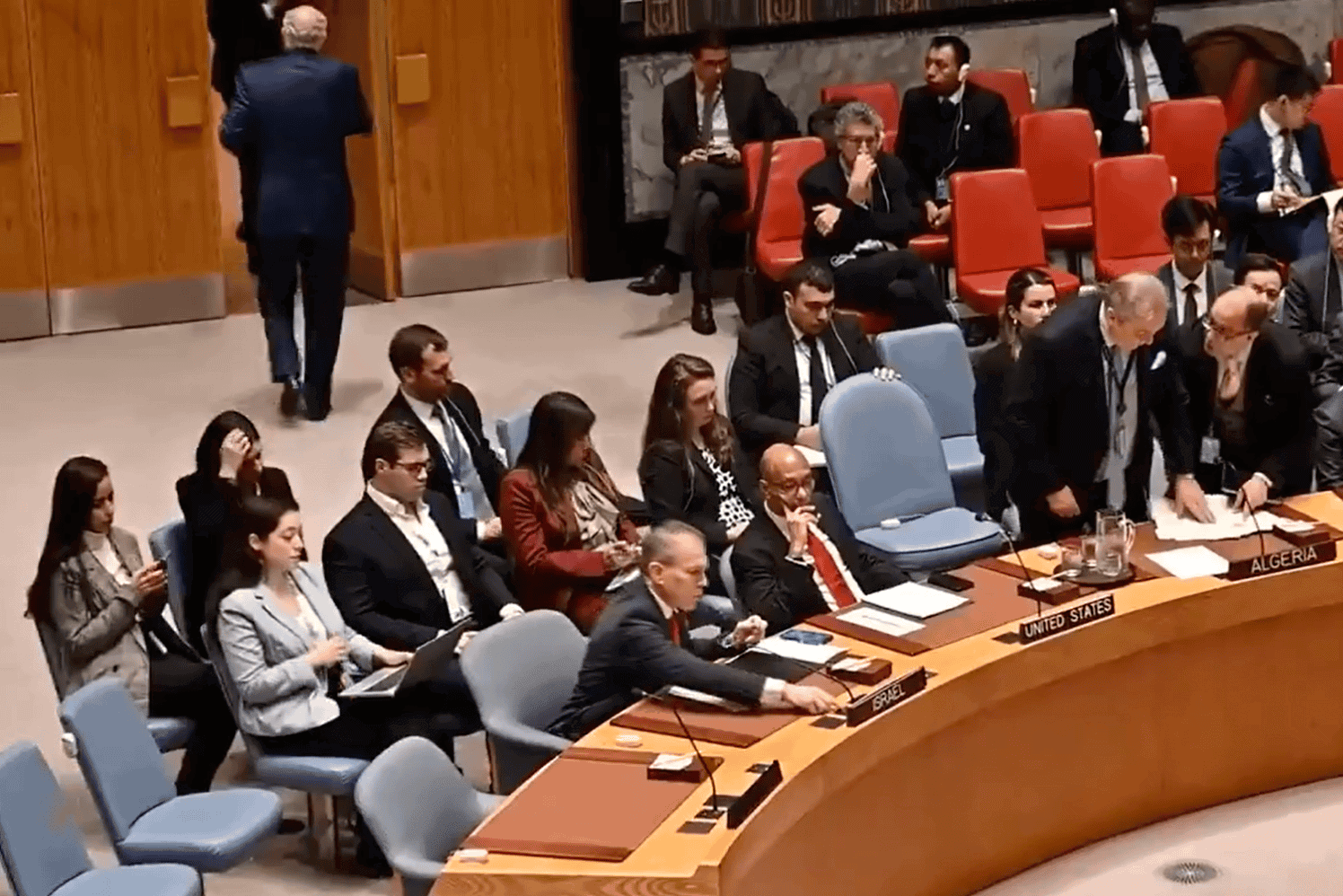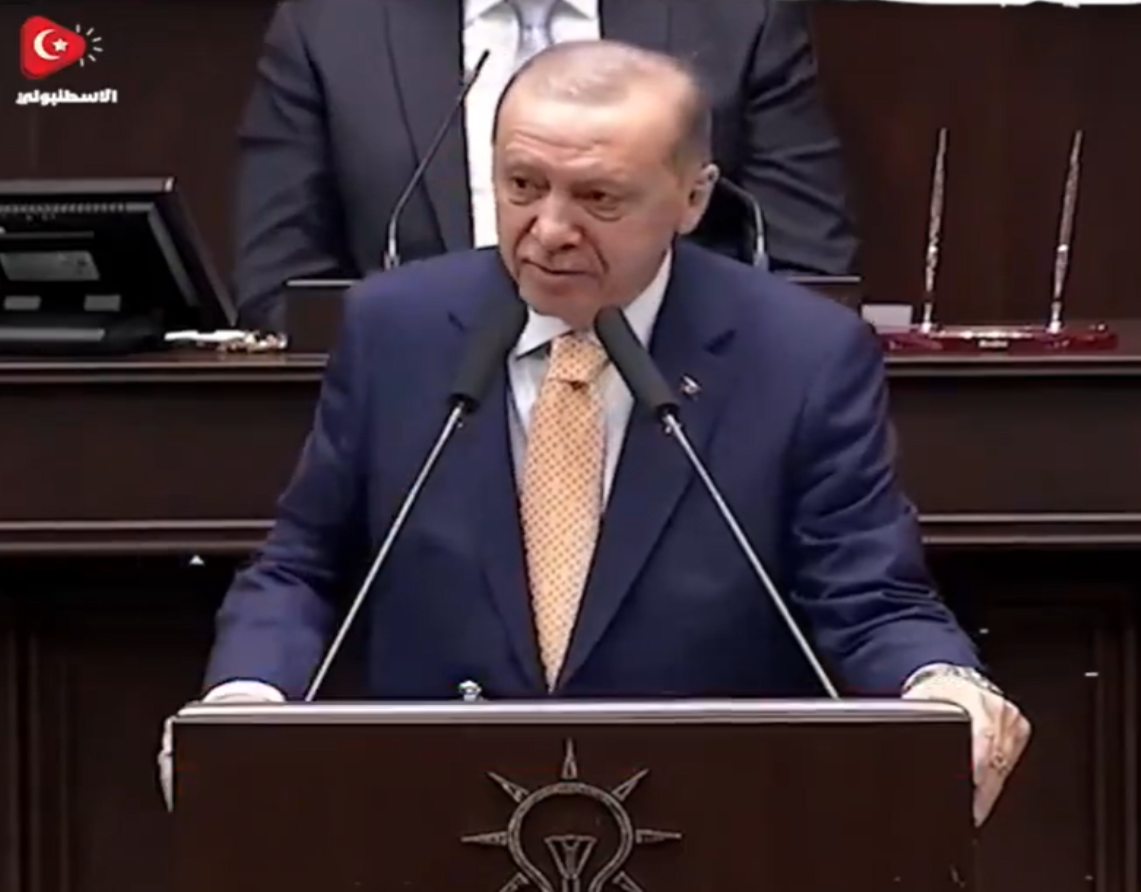وطن- قد نتمسك بغصنٍ ظناً منّا أنه طوق نجاة وإذا به يقذف بنا نحو شاطئ من شواطئ القدر بحلوه و مرّه ، لنجد أنفسنا على رمال غريبة منهكين القوى و ما أن ننهض مستجمعين ما تبقى من قوانا حتى نقع مجدداً ..
فإن موجة واحدة من أمواج ذاك الشاطئ كفيلة بأن تجعلنا نسقط من جديد ، لنقع معيدين الكرّة على تلك الرمال مرّات و مرّات قبل أن نستطيع النهوض و المتابعة ، ملطخين أثوابنا التي كنا قد طهرناها لتونا من تلك الشوائب أو ذاك ما كنا نظن ، لنجد أن سقوط واحد يكفي ليس لتلطيخه بشوائب جديدة و حسب بل أيضاً لتعيد ما كان عالقاً عليه ، ليس فقط على ذاك الثوب الأبيض بل حتى على أغشية قلوبنا و في ذاكرتنا .
كان نهاري قد بدأ يعلن نهايته ، و جسدي كان قد أنهكه طول ذاك اليوم حين وقفت في محطتي المعتادة أنتظر حافلتي اليومية التي لم تأت ذاك المساء في وقتها المحدد لأسباب لا أعرف ماهيّتها .
فأطلقت لقدمي العنان مجدداً و ربما لأفكاري أيضاً ، فلم اشعر بنفسي إلّا حين وصلت أعتاب منزلي ، فإنني
حين عزمت السير لم تكن تلك الحافلة التي لم تأت سوى حجّة أخبر بها جسدي المنهك ليواصل قُدماً ما كنت عازمة فعله و كأن أفكاري تقودني لتجعل من قدميّ عبداً مأموراً لها ، فلم أذكر أني قد قررت عدم انتظار حافلة أخرى نصف ساعة و نيف أم لا، فأفكاري كانت أسبق في قراري مصرحة عن رغبتها آمرة إياي المسير…
كان المساء قد أسدل ظلامه المعتاد على هذه المدينة ليترك الرصيف يئنّ مشتاق للمارة لعلّها تحنّ عليه و تخفّف برودته حين واصلت مسيري فوقه مقلبة بين يديّ بعض الأوراق التي كنت أحملها منذ خروجي من ذاك المكان ، ناظرة حولي مغمضةً عينيّ بين الحين و الآخر ، فأضواء سيارات ذاك الطريق السريع كانت كافية بأن تقلق راحتي بين برهةٍ و أخرى و خوارها كان كفيل بأن يعكّر صفو ذاك المساء رغم تلبّد بعض الضباب في سماءه …
كان مصنف جميل ملون يحوي وريقات رُسم عليها أجمل الرسومات ، قُصّت على هيئة قلبين اتصلا ببعضهما البعض ، تاركاً في إحدى زوايا تلك الورقة بعض الإعوجاج الذي على ما يبدو كان قد خلفه أحد حواف ذاك المقص اللعين ..
و ما إن بدأت أفتح ذاك الظرف حتى استرجعت صورة وجهه الجميل ذاك ، و عينيه الغزلاوتين العسليتيّ اللون ، ما إن تراهما حتى تستشعر حاجته إليك و ضياعه رغم تمرده و عصيانه ، كان يودّ لو أنك تمد يد المساعدة إليه و لكن كبريائه و ربما خجله من جهله كان يصعّب ذاك الأمر عليه ..
ربما لم نستطع أن نوصل افكارنا نحو بعضنا البعض في الكلام و الحروف بشكل جيد و ذلك لأن فرنسيّته افضل من فرنسيّتي بكثير فهو كان قد وُلد هنا ، و عربيتيّ أفضل من عربيّته بمراحل فأنا كنت قد وُلدت في مدينتي مدينة الياسمين ..
كان بين الحين و الآخر يرنو إليّ يسترق النظر يخبرني أنّه في حالة فوضى و أنّه في حالة احتياج و لكن دون أن ينطق بكلمة واحدة و ذلك كله في بادئ الأمر بالطبع ..
كان عنيداً لدرجة قد يمسي جاهلاً بلغته الأم على أن يطلب المساعدة ، دنوت منه شارحةً موضّحة ما يتطلب فعله حينها علّي أساعده في فك طلامس تلك الحروف التي باتت غريبة عليه بالرغم من أنها يجب أن تكون لغته الأم التي تعبّر عن انتمائه الاول و تعبّر عن كيانه أيضاً..
قطع استرجاعي و بحثي في ذاكرتي القريبة تلك أزيراً لسيارة كانت قد مرّت بجانبي ليدخل هديرها ليس إلى أذنيّ و حسب بل إلى أفكاري أيضاً ليزعج راحتها و كأنه أتي ليعيدني إلى واقعي و ينبهني أنّ الرصيف قد انتهى و عليّ عبور ذاك الشارع ..
ما إن عبرت ممر المشاة ذاك حتى راود أنفي رائحة لمخبوزات اشتهرت هنا و عُرفت بانتشار محالها على طول الطرق السريعة و الفرعيّة منها ، فابتسمت ، فعلى ما يبدو أن تلك الرائحة حركت أزير جوعي الخامد ليعلو على صوت أزير تلك السيارات المسرعة و خوارها ..
دخلت ذاك المحل ألتمس ما أسد به رمقي فقد كان نهاري حافل لم أحظى فيه و لا حتى ببضع دقائق أتناول بها وجبة تحييني يوماً آخر في غربتي بل إني لم أحظى بدقائق تذكرني بأن الجوع قد انتابني قبل تلك الرائحة ..
جلست في مكاني المعتاد قرب النافذة أراقب المارة إذا ما وُجدوا و استرق النظر إلى آخرين راحوا يترجلون من سياراتهم على عجل يلتمسون دفئ هذا المكان هرباً من برودة ذاك المساء الذي على ما يبدو لم استشعر شدة برودته تلك في مسيري المتواصل و كأن وجهه الجميل ذاك يضفي على أفكاري الراحة و على كلماتي الجمال و ينسيني برد ذاك الليل ..
تناولت شطيرتي و أخذت أرتشف من فنجان قهوتي رشفات متتالية قبل أن افتح تلك الرسالة ، كانت رسالة رغم افتقارها لمعظم الكلمات إلا أنها كانت تعبر عن الكثير ..
أعدتها داخل ذاك الظرف الأحمر مغادرة المكان أواصل ما بدأت به ذاك المساء ..
لم تستطع ذاكرتي نسيان كلماته الفرنسية تلك حين قال لي للمرة الأول بعد بضع ساعات من جلوسنا ، فيبدو أنه حينها كان قد بدأ يعتاد وجودي و راح ينزع قناع العصيان الذي وضعه فوق وجهه الخائف من جهله رويداً رويداً ..
ذاك القناع الذي اعْتَقَدَ أنّه من خلاله يتدارى به مخفياً مخاوفه عن ناظريّ أو هذا ما كان يظن ..
فقال لي حينها بفرنسيته الممتازة :
? Comment je fais ça
أي كيف أفعل هذا ؟
مشيراُ إلى المصحف الشريف بأصابعه الصغيرة تلك ..
ربتُّ على رأسه مداعبة شعره الذهبي ذاك قائلة له بالفرنسية التي يفهمهما …
عليك أن تقرأ ذلك ..
فرد خجلاً قائلاً :
لكني لا أستطيع القراءة ..
قلت له مشجعة عن جهل بالطبع فهو طفل في السابعة من العمر نشأ في هذا المغترب اللعين ..
قلت :
بل إنك تستطيع ، حاول تهجئة هذه الكلمات ..
فأسرع يجيبني :
صدقيني لا أعلم كيف اقرأ ..
فرحت أردد تلك الآيات ليعيدها على مسامعي مراقباً شفتيّ و هي تلفظ تلك الكلمات ، مقلّداً في كثير من الأحيان صوت ظهور الكلمة هارباً من لفظها ذاك الذي يستصعبه ..
كان حزني حين خرجت من هناك ليس على حاله و حسب ، فشعوره بالضياع وسط أحرف لغتنا كلماتها و معانيها ليس فقط حكراً عليه بل على أبناء كل الجاليات العربية هنا …
لأخرج تلك الورقة من جديد أقلبها بين كفي علّي أجد ولو كلمة واحدة تدل على ما يريد التعبير عنه و لكن هيهات فاللون الأزرق كان قد غطى معالم الورقة يخبرني فيه عن عجزه عن الكتابة و ليمتنع أيضاً عن كتابة ما يود قوله بالفرنسية و كأنه كان خجلاً مني أو ربما من لغتنا العربية ، معبراً بجهله الجميل ذاك عن حبه و امتنانه دون حرف واحدٍ يذكر ..
نظرت إلى السماء حيث منجاي و بارئي و حيث أستشعر نظرات الله لي و مراقبته إيّاي و رحت أخبره دون همس يذكر أني ضائعة أيضاً في شوارع هذا المغترب المتشابهة الباردة و أنّ اشتياقي ليس للحديث بلغتي الأم في الشوارع و حسب و لا لمشاهدة وجوه تشبه ملامحي و حسب بل بتّ أشتاق روحي الأولى ، روحي الّتي اشتاقت لأصوات المآذن تعلو مذكِّرةً عباد الله بدخول ميعاد العبادة ..
ليراودني سؤال يقلق صفو أمسيتي تلك ألا و هو :
ترى إلى أين سيؤول بنا المآل ، و إلى أين سيُرجِع أبناءنا و أجيالاً ستلحق بنا انتمائهم الأول بعد كل هذا التهجير ، و هل يا ترى سنغدو يوماً شعباً عربي الأصل لا يفقه من لغته سوى بضع كلمات إذا ما حالفه الحظ وسط حيطان اغترابه في أيّ مكان كان ، فنغدو ليس مهجّرين و حسب بل أيضاً مشتتين نبحث عن ما يجمع شملنا بين ذكريات و أساطير و قصص ، كماضٍ لم يُكتب له أن يُعش أو يغدو حاضراً لنا و مستقبلاً لأولادنا من بعدنا ، ليندثر ذاك الماضي في ذكرياتنا ، و لتلفظ تلك الذكريات أنفاسها الأخيرة مع آخر نفس تلفظه أرواحنا ، ليبات ذاك الماض بذكرياته حكراً على قصص تداولوها أجداد أجيال قادمة فتمسي تاريخاً و تغدو أساطير وسط حياة مصطنعة يتوه فيها المرء بين تلافيف غربته و جدران وحدته يلتمس فجراً بعد ليال كحال و لكن هيهات …
لتتخبط ذاكرتي من جديد بين موقفين عَلِقا في جدران الذاكرة ، الأول كان في ذاكرتي القريبة حيث صباح ذاك المساء و سوف أتطرّق إليه فيما بعد..
أما الآخر فكان قبل بضع أيام من ذاك اليوم حين ودّعت أحد أساتذتي في المعهد و ذلك بسبب إنتهاء طريقنا المشترك في دروب الحياة لتتقاطع طرقنا مبتعدة مختلفة جاعلةً لكل واحدة منّا درباً بعيدةً عن الآخرى ، لتودعني حينها موجهة الحديث ليّ و لكل الحاضرين قائلة :
إنني كما تعلمون و سبق و أخبرتكم ؛ فرنسية الأصل مهاجرة مثلكم تماماً مُذ سبعة عشر عاماً و ربما يزيد ..
و لكني و رغم طول تلك المدّة لم أتنكر يوماً لانتمائي فأنا أفتخر بكوني فرنسية وأفتخر أن العروق في جسدي يسري فيها دم فرنسي الأصل ، قد تطلقون على كلماتي التعصب و لكنّي أُطلق عليها مصطلح الاحترام ..
احترامي لنفسي أولاً لماضيّ و لأبي المتوفي ، لغدي و لأبنائي من بعدي ..
فأنا لدي الكثير لأورّثه لهم بعيداً عن جنسيّتي الكندية ، فكوني أحمل الجواز الكندي فذاك لا يجعل مني انسانة متملّصة من أصلها عند أول منحة أو اختيار ..
و الدليل أن ابنتي و بالرغم من أنها وُلدت هنا إلى أنها و بعد قرابة الستة عشر عاماً التي عاشت معظمها هنا تخبرني قائلة :
أنا فرنسية الأصل ألبانية الأب مولودة في كندا ، أحترم موطني الجديد و لا أتنكر لموطني أصلي أبي و أمي ، و لن أتنكر يوما ، متمسكة بانتمائي …
ثم أردفت تلك السيدة قائلة من جديد :
إن ما أود أن أقوله لكم ، ليس عليكم أن تأخذوا من كل كلمة تلقّم لكم منهاجاً و مساراً تمشون عليه متناسين عاداتكم ثقافتكم انتماءكم و اعتقاداتكم ، بل احيوا هذه الحياة كما تريدون أن تحيوا ، و كما تحبون ، و بطريقة تجعلكم تحترمون أنفسكم لا حياتكم و حسب ..
فسيأتي يوماً تستعرضون فيه حياتكم كشريط مسجل سريع إذا ما تجاوزتم الستون من العمر ، فلا تتركوا في ذاك الشريط ما يزعج راحتكم و يقلق منامكم حين تبلغون من العمر ما تبلغون ، فالندم على حياة لم تُحيا بطريقة ترضون عنها و عن أنفسكم بها هي من أصعب أنواع الندم و تأنيب الضمير ..
“متمسّكة بانتمائي “..
تلك أجمل كلمة نطقتها حينها ، “متمسّكة.”.
لأعود إلى صباحي حيث نافذتي و الستارة و ذاك السنجاب مجدداً ..
فتحت تلك الستارة معلنة بدء صباح جديد حين استوقفني ذاك السنجاب الذي كان قد جعل من شجرة كانت تطل عليها نافذتي مأوى له ..
كان ذاك السنجاب في ذاك الصباح يختلف عن بقية الأيام ليس في شكله بالطبع و لكن في تصرفاته و حركاته ..
فقد كان اليوم غير متوازن يترنح ذات اليمين و ذات الشمال ، و كأنه أسكرته بعض قطرات من الخمر ، و لكن لا فالريح كانت له بمثابة المُسْكِرِ ..
كان يحاول الإمساك بأحد أغصان تلك الشجرة العارية و لكن هيهات ، فالريح أعلنت هبوبها منذ ساعات الفجر لأولى لتجعل من ذاك الغصن أكثر جفافاً و أكثر قسوة فيمسي أكثر هشاشة و عرضة للانكسار و التهشم ..
كان ذاك السنجاب قد خرج من حفرته القابعة في جذع تلك الشجرة ، متمسكاً بكل قوته بفرع ذاك الغصن حيث موطنه ، التماساً للدفء.
فالسنجاب عادةً حين يشعر أن الشتاء بدأ يلوح في الأفق يبحث عن أوراق الأشجار اليابسة المتبقية على بعض تلك الأغصان التي تصرخ فيها الريح ، و ما أن يجد ضالته حتى يقضم بأسنانه الأمامية ساق تلك الورقة آخذاً إياها إلى عشّه لتُدفئ برد منزله الصغير و تقيه من تلك الرياح ..
لأشعر حينها للحظات أنني لست أفضل حالاً من حال ذاك السنجاب ، فكلانا نتمسك بغصن عاري ملتمسين بعض الدفئ ، و لكنه هو كان قد اعتاد تلك الأغصان فهي موطنه و أنا لم أعتد بعد على أغصان منفاي فجفاف أيامه لا يضاهيه جفاف كل أغصان شجر الشتاء و تهشمي داخل ديمومة غربتي لا يضاهيه تهشماً ..
فتلك الأغصان سيأتي عليها يوماً تتجدد فيه و لكن ما بال أيامي المهشمة الزائلة التي تعلن مع زوالها دنو الأجل ، كيف لها أن تعود يوماً و تتجدد !!
ليوقف سيل أفكاري تلك بوق سيارة عابرة تحذرني أنني على وشك أن أعبر طريق سريع اتخذت منه تلك السيارات حلبة سباق مع الزمن ، لأقف غير مزحزحة عن الثبات ألتقط أنفاسي التي لم يُكتب لها الانقطاع بعد ..
و إذا بقمر ذاك المساء يطل عليّ على عجل و كأنه رسالة من المولى عز وجل يخبرني أن على كاهلي حمل أكبر مما كان عليه حيث كنت في موطني أو حتى في اغترابي في بلاد تحمل طابع الإسلام في كثير من معالمها و يصدح فيها اسم الله في مآذنها ، فذاك الغطاء الموجود على أحرف لغتنا العربية و قرآننا الكريم لن يُكشف عن أعين أطفال هذا المغترب إلا بمجهود كبير سيُقدِّمه من حظى باكتساب لغة القرآن مسبقاً …
و كأنه عز و جل يرسل إلي إشارة يخبرني بها أن ذاك القمر لم تستطيعي اليوم أن تتمتعي بجماله لاكتسائه طبقة ضبابية حجبت نوره عنك ، تماماً كذاك الطفل ، فإن حجاب جهله ذاك لن يُزال دون وجود يد تزيل ذاك الحاجز و تقطع ستار ذاك الجهل ، فيقشع عنه ذاك الظلام بشعاع شمس لغتنا الأم و جمالها ..
دسست ذاك القلب في جيبي متمنية أن يأتي يوماً يعبر لي به عما يجول في خاطره بقلمه الذي ينطق العربية لا ألوانه و حسب ..
مونتريال – كندا