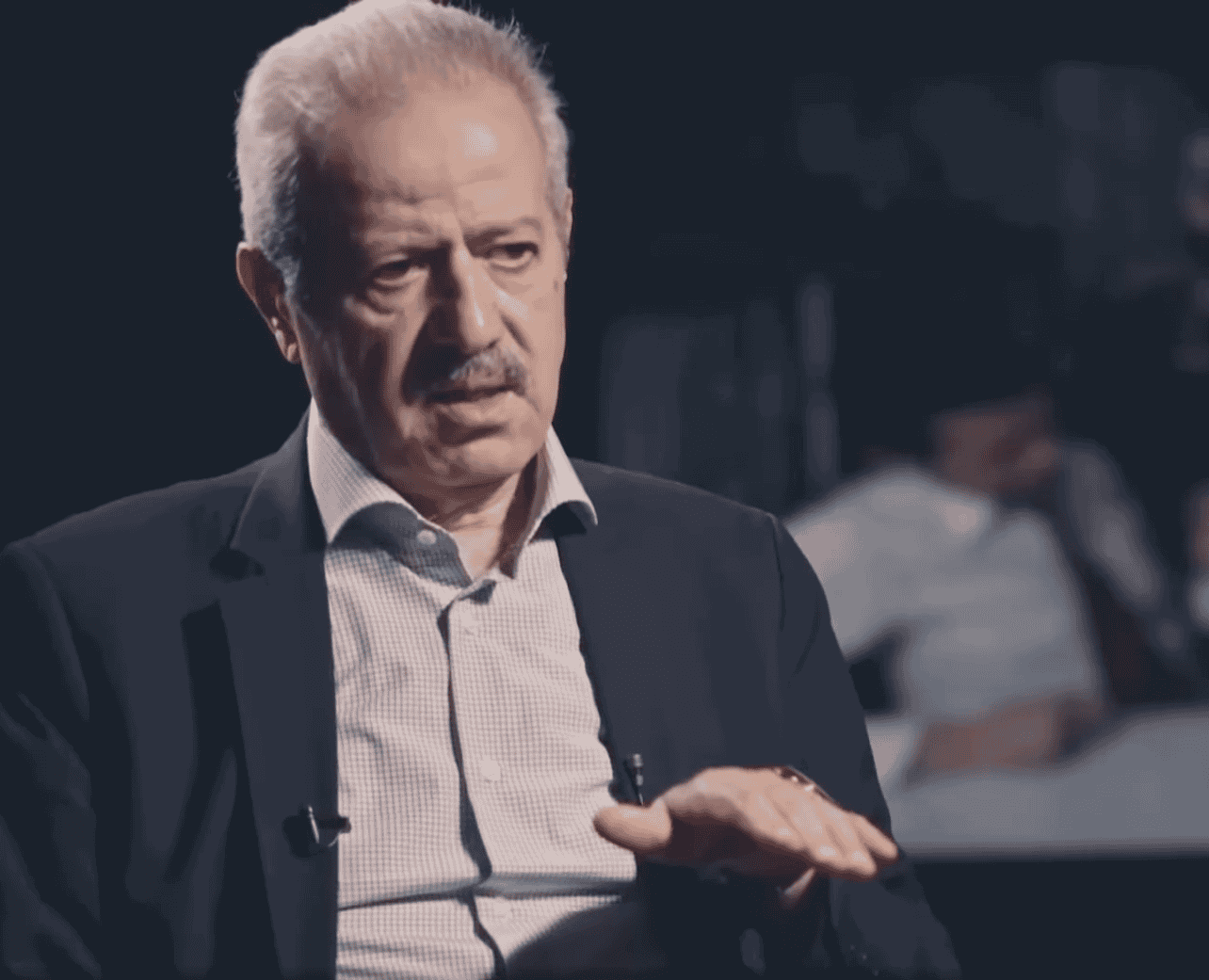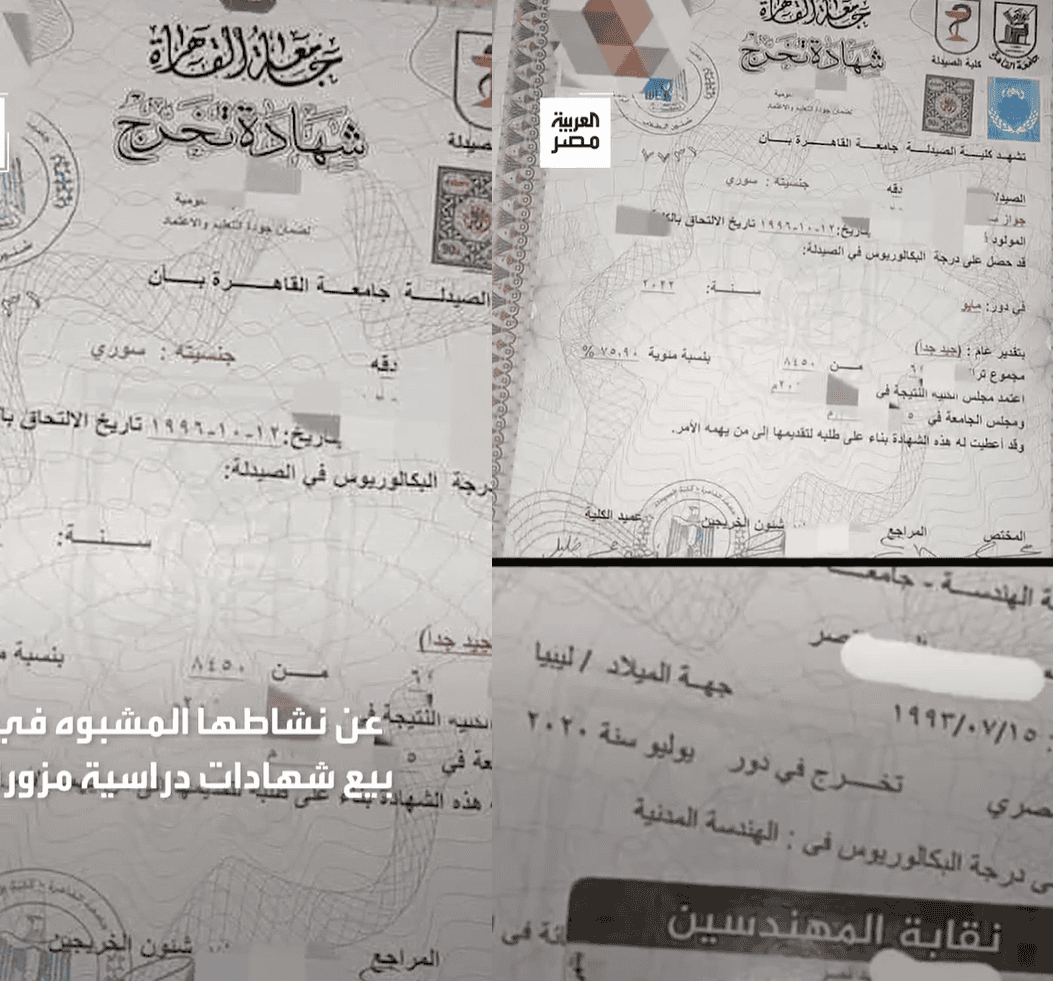وطن- “في 5 شباط/فبراير، أدلى ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن، بشهادة أمام مجلس النواب الأمريكي حول الدلالات المترتبة على المصالحة بين «فتح» و «حماس» وآثارها على آفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يلي ملخص تنفيذي لشهادته.”
السيدة رئيسة اللجنة، العضو البارز في اللجنة السيد دويتش، أعضاء اللجنة الفرعية البارزين:
قضية الوحدة بين «فتح» و«حماس» مسألة تناولها الطرفان بالنقاش على مختلف المستويات منذ 2007 — وتحديداً منذ أن أعلن الطرفان عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي فيما يخص المصالحة في أيار/مايو 2011. ومن المقرر عقد اجتماع بين الطرفين في القاهرة خلال الأيام المقبلة ولا ينبغي استبعاد إمكانية تحقيق هذه الوحدة، إلا أن حالات الفشل السابقة التي مُني بها الطرفان في تحقيق الوحدة تثير العديد من التساؤلات وتشير إلى الأسباب حول احتمالية عدم تحقيق الوحدة في المستقبل. وفي حين أن قضية الوحدة هذه تحظى بشعبية واسعة بين الفرقاء في كل مكان، إلا أنه كانت هناك عقبات حقيقية حالت دون تنفيذ أي اتفاق بشأن الوحدة بين «فتح» و«حماس». أولاً، يبدو أن كلاً من حركتي «فتح» و«حماس» لا ترغب في المخاطرة بما تملكه بالفعل، وتحديداً سيطرة «حماس» على غزة وسيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق الواقعة تحت سيطرتها من الضفة الغربية. فلكل طرف منطقة خاضعة تحت سيطرته ويرغب في الحفاظ عليها. ثانياً، لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرغب في الخضوع لمطلب «حماس» بوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي أدى إلى إلقاء السلطة الفلسطينية القبض على نشطاء من «حماس».
وفي الواقع أنه وإن لم تتم صياغة الأمور بهذا الشكل من الوضوح من قبل، إلا أنه قد نشأ تحالف فعلي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع إرهابيي «حماس» من القيام بأي عمليات في الضفة الغربية. وقد قامت المساعدات الأمريكية بصفة أساسية على إنشاء “مكتب المنسق الأمني الأمريكي”، وهو ما ساهم في تدريب المسؤولين الأمنيين والتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وكان هذا التنسيق محورياً في مكافحة الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل من جانب «حماس» وآخرين.
ويُعد هذا في واقع الأمر إنجازاً هاماً كانت له تبعات قوية. ففي عام 2002، لقي أكثر من أربعمائة إسرائيلي مصرعهم نتيجة لتسلل إرهابيين من الضفة الغربية. وعلى النقيض من ذلك، تراجع عدد القتلى الإسرائيليين بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية ليصل إلى الصفر. وبالطبع يمثل العمل الذي يقوم به جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي (الشين بيت) دوراً هاماً تماماً لا يقل في أهميته عن دور الحاجز الأمني في الضفة الغربية. بيد أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان حاسماً للغاية — حسبما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. لذلك، إذا أردنا أن نعمل لصالح أمن إسرائيل وشعبها، بغض النظر عن رغبة الشعب الفلسطيني الواضحة في الحفاظ على كرامته، فمن الضروري حتماً الحفاظ على دعم السلطة الفلسطينية.
وعلاوة على ذلك، أعاق غدر «حماس» من تحقيق الوحدة الفلسطينية. فقد انتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القيادي بحركة «حماس» خالد مشعل بسبب إلقائه خطاباً هاماً في كانون الأول/ديسمبر الماضي في غزة والذي قال فيه بأن على الفلسطينيين ألا “يفرطوا في شبر واحد من الأرض” لإسرائيل. ومع ذلك، لا يستطيع أحد في الشرق الأوسط أن يقطع بأن الأمور سوف تسير في اتجاه محدد. فالمنطقة برمتها تواجه اضطرابات غير مسبوقة. وبالتالي يجب علينا ألا نستبعد احتمالية تحقيق المصالحة بين «فتح» و«حماس». وفي الواقع، تبرز العديد من العوامل في هذا الصدد.
أولاً، لا يمكن تجاهل الحكومة التي يقودها «الإخوان المسلمون» في مصر المستمرة في تقديم الدعم لحركة «حماس» في غزة. وهذا أحد التغييرات التي طرأت عقب ثورة 2011، إذ كانت مصر قبل ذلك في مقدمة الدول العربية المؤيدة للسلطة الفلسطينية وكان الرئيس المصري السابق حسني مبارك من أبرز الداعمين للرئيس الفلسطيني عباس. ولا يزال العاهل الأردني الملك عبد الله يقدم له الدعم المعنوي، بيد أن دول الخليج العربية لم تقدم سوى القليل لتوفير الدعم المالي لعباس. ويستغرق الأمر عادة شهوراً لكي يستطيع الدبلوماسيون الأمريكيون حّث السعوديين على تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار.
ففي حين يعزف السعوديين على أوتار دعمهم للقضية الفلسطينية ينبغي عليهم الشعور بالخزي لعدم تقديمهم الدعم الفعلي لإخوانهم العرب.
المصالحة الفلسطينية على قارعة الزمن
ثانياً، في الخريف الماضي، كان أمير قطر أول رئيس لدولة عربية يزور قيادة «حماس»، إذ عرض تقديم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، مما يوفر الغطاء المالي لتحقيق الوحدة المزعومة. وقد تم ربط عزوف الولايات المتحدة عن ممارسة النفوذ الكافي لمنع وصول الدعم القطري التقليدي إلى «حماس» — الذي وصل الآن إلى مستوى جديد في ضوء زيارة الأمير — بالاستخدام الأمريكي لـ “قاعدة العديد الجوية” في قطر مع بعض القيود. ويمكن أن يكون اضطلاع هذه اللجنة الفرعية بعقد جلسة استماع بشأن الدعم القطري لـ «حماس» هو أولى الخطوات نحو تصحيح هذا التصور وإعلام الدوحة بأن واشنطن تراقب ما تؤول إليه الأمور عن كثب.
والعامل الثالث الذي يصب نحو تحقيق الوحدة هو تراجع النفوذ الداخلي لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. فقد أوضحتُ في إحدى الشهادات السابقة التي أدليت بها في أيلول/سبتمبر 2011 بأن فياض كان له دور بارز في التركيز على الإصلاح والحوكمة في الضفة الغربية منذ توليه هذا المنصب في عام 2007، حيث ساعد في تحفيز النمو في الضفة الغربية بنسبة 10 في المائة سنوياً على مدى عدة سنوات. وعقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء سلام فياض في عام 2007، شهدت الضفة الغربية نمواً سريعاً في إجمالي الناتج المحلي حتى 2010، بما في ذلك الارتفاعات الكبيرة بنسبة 12 في المائة في عام 2008، و10 في المائة في عام 2009، و8 في المائة في عام 2010.
ومع ذلك، فقد أعربتُ في شهادتي السابقة عن اعتقادي بأنه إذا منعت الولايات المتحدة وصول الدعم الاقتصادي إلى السلطة الفلسطينية، فإنها بذلك سوف تُضعف القوى المعتدلة التي تكتسب نفوذاً متزايداً هناك. وفي واقع الأمر، بدأت شعبية فياض في التراجع عندما بدأت الولايات المتحدة إيقاف ضخ هذه الأموال. ووفقاً لتقرير «البنك الدولي»” عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فقد هبطت مستويات النمو بنسبة ثلاث نقاط مئوية كاملة.
إن الأزمة المالية المتفاقمة قد منعت فياض من دفع الرواتب الكاملة في الوقت المحدد لنحو160,000 موظف عن الأشهر القليلة الماضية. وقد حذر تقرير «البنك الدولي» نفسه من أن “السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً طاحناً [،] مع وصول عجز ميزانيتها إلى مستويات أعلى من المتوقع وتراجع الدعم الخارجي للميزانية.” فبعد سنوات من تراجع معدلات البطالة في الضفة الغربية، تزايدت الأرقام مؤخراً بواقع نقطتين لتصل إلى 17 في المائة. كما دخل موظفو القطاع العام في العديد من الإضرابات على نحو دوري. ومن الناحية النظرية، كان يجب أن تكون هذه الاحتجاجات خارج مكتب عباس إذ أنه كان مسؤولاً عن التماس الشرعية من الأمم المتحدة رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى الرغم من أنه قد عُرف عن فياض اعتراضه على التوجه إلى الأمم المتحدة، إلا أنه كان هدفاً سهلاً ولقمة سائغة لأي احتجاجات متعلقة بالاقتصاد. وقد ظهرت أغنية فلسطينية تحمل اسم “دبر حالك يا فياض” تطالب بالإطاحة برئيس الوزراء. وهناك تكهنات جديرة بالاعتبار حول ارتباط أعضاء من حركة «حماس» بالاحتجاجات المناهضة لفياض. وترتبط هذه الشكوك بالمخاوف الشائعة القائلة بأن أي شخص غير منتمي إلى حركة «فتح» لا يمكنه أن يخلف عباس في السلطة بشكل منطقي.
ولا يمكن للمرء افتراض استدامة الوضع الراهن وأن السلطة الفلسطينية ستظل في الضفة الغربية. وواقع الأمر أن السلطة الفلسطينية معرضة لخطر الانهيار بدون حصولها على المساعدة المنتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ظهر في بعض الحالات عدد من المتظاهرين الشباب الملثمين يتقدمون في مسيرات داخل مخيمات اللاجئين. وتُظهر بيانات استطلاع الرأي زيادة تأييد استخدام الفلسطينيين للعنف ضد الإسرائيليين، على الرغم من المعارضة الصريحة والعلنية لمثل هذا العنف من جانب عباس وفياض. ولا يمكن لأحد أن يشير صراحةً إلى الوقت الذي قد ينفجر فيه الوضع بشكل كامل. بيد أنه ينبغي علينا الالتفات إلى التوترات المفروضة على الساحة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانتفاضة الأولى — التي استمرت لسنوات — اندلعت نتيجة لوقوع حادث سيارة في غزة ذات الأوضاع الأمنية المتردية.
ينبغي أن يقوم النهج السياسي السديد على ما يلي: مكافأة الأفراد الذين يفضلون التعايش السلمي مع إسرائيل مع استبعاد أولئك الذين يفضلون طريق الإرهاب. وبرغم جميع التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق فياض إلا أنه يواصل جهوده المضنية في عملية الإصلاح، بما في ذلك من خلال التنظيم لانتخابات البلدية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما اضطلع فياض في العام المنصرم بتوسيع القاعدة الضريبية وجباية الضرائب، وهي خطوة هامة (وإن كانت لا تحظى بشعبية) في ظل معاناة السلطة الفلسطينية من عجز في ميزانيتها. ويجري نشر الميزانيات بمنتهى الشفافية عبر الإنترنت بعد خضوعها لتدقيق خارجي. كما يتم توظيف قوات من الشرطة وغيرها من قوات الأمن على أساس غير سياسي. وهذا على النقيض مما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمان، عندما كان ياسر عرفات يتولى توزيع الأموال على الموظفين من حقيبة ورقية بينما كانت الأجهزة الأمنية مسيّسة تماماً.
وعلاوة على ذلك، فإن «حماس» لم تشُب عن الطوق بعد. فلو قيل لـ «حماس» في عام 2006 أنها لن تكون قادرة بعد سبع سنوات على إثناء الدول الأوروبية عن دعمها لسياسات الولايات المتحدة، لشعر قادتها بصدمة كبيرة. فقد كانت هذه هي المهمة التي أخذوها على عاتقهم، وكانوا على ثقة تامة بتحقيق النجاح. بيد أن هذا الأمر لم يتحقق إلى الآن. وعلاوة على ذلك، رأت «حماس» أن «فتح» استطاعت جذب عشرات الآلاف في إحدى المسيرات الحاشدة في غزة في كانون الثاني/يناير من هذا العام. وأخيراً، تؤمن «حماس» بأن حليفتها، جماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة، سوف تعزز وضعها. بيد أن أعمال الشغب التي تشهدها القاهرة على مدار الأيام والأسابيع الأخيرة تشير إلى أن «حماس» لا تأتي على الأرجح في مقدمة أولويات مصر في هذه الآونة، حيث أصبح مستقبل حكومة الرئيس المصري محمد مرسي على المحك. كما يبدو أن «حماس» شعرت بالدهشة والذهول من إطلاق إسرائيل لعملية “عامود السحاب” في تشرين الثاني/نوفمبر، في ضوء وجود حليف وداعم مُفترَض جديد في القاهرة. وعلى الرغم من ذلك لم ترتدع إسرائيل وكان لمصر دور محوري في الوساطة لوقف إطلاق النار.
ولذلك فإن المسألة السياسية أمام إدارة أوباما تدور حول ما إذا كانت الإدارة تبذل كل ما بوسعها لإقناع الدول السنية مثل مصر وتركيا وقطر باستخدام نفوذها الكبير من أجل التأثير على «حماس» لتقبل الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة) في عام 2006. وتنص هذه الشروط على الاعتراف بـ «حماس» كطرف شرعي في محادثات السلام بمجرد نبذها للإرهاب والاعتراف بالاتفاقات السابقة وحق إسرائيل في الوجود.
إن كل ما سبق يثير التساؤل حول ما يمكن القيام به لإنهاء الشلل التام الذي أصاب جبهة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية؟ فباستثناء ثلاثة أسابيع في 2010، لم يعقد عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي محادثات سلام خلال السنوات الأربع الماضية. وهو الوضع الذي لم يتغير إلى الآن، إذا تقول إسرائيل بأن عباس لن يجلس معها على طاولة المفاوضات. فقد بدأ عباس — الذي لم يربط في السابق بناء المستوطنات في أي مكان في الضفة الغربية أو القدس الشرقية باحتمالية عقد محادثات — في القيام بذلك الأمر في عام 2009. وإسرائيل تنظر إلى هذا الأمر كشرط فلسطيني مسبق. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى الجهود التي يبذلها عباس في الأمم المتحدة على أنها وسيلة لتجنب إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة.
مما لا شك فيه أننا في منعطف فاصل. فإدارة أوباما هي في بداية فترة ولايتها الثانية، كما أن إسرائيل أجرت انتخابات مؤخراً وها هو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس الخيارات المتاحة له في سعيه لتشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت الذي تصوغ فيه الولايات المتحدة سياستها المتعلقة بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، تحتاج إلى إدراك واضح لما هو ممكن وما هو غير ممكن. فالأمر الذي يبدو مُحالاً في الوقت الراهن هو إبرام اتفاقية سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من شأنها أن تضع حلولاً لجميع قضايا المرحلة النهائية — من بينها قضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين — فضلاً عن وضع نهاية للصراع الدائر. وهناك العديد من العوامل المتغيرة المرتبطة بالسعي للوصول إلى اتفاق شامل. فقضايا مثل وضع القدس واللاجئين أصبحت قاصرة على التعريف الذاتي لكلا الطرفين، وليس لدى أي طرف الاستعداد لتقديم تنازلات بخصوص هذه المسائل الملحمية. والشيء الأكثر خطورة هو أن المنطقة لا تزال في قلب بركان ثائر في وقت يُستبعد فيه توصل القادة إلى اتفاق، وهم يدركون أن الإسلام السياسي آخذ في الصعود — لا سيما في ضوء الصعوبات الداخلية الخاصة بهم. وهذا لا يعني أن التوصل إلى اتفاق أمر أقل أهمية، بل أنه يجب على أي شخص يسعى للتوصل إلى اتفاق أن يكون واقعياً فيما يتعلق بالاحتمالات.
يجب أن تستند مساعي الولايات المتحدة إلى رغبتها في تمهيد الطريق للتوصل إلى حل قائم على الدولتين. وتشمل الأهداف المرحلية تقليص السيطرة الفعلية للإسرائيليين على أجزاء من الضفة الغربية حيث ستقوم دولة فلسطينية مع الاعتراف بحق إسرائيل في الاحتفاظ بحوالي 5 في المائة من الضفة الغربية بالقرب من المناطق الحضرية — مقابل تبادلات أو مقايضات نهائية للأراضي قائمة على مقترحات تقدم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أيار/مايو 2011. فهل من سُبل لدفع هذه الأفكار قدماً في نفس وقت تنفيذ عمليات مقايضة رئيسية؟ هل من الممكن تحقيق هذه الأهداف عن طريق قيام الولايات المتحدة بجمع الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة واحدة أم هل يمكن تحقيقها عن طريق اتفاق الولايات المتحدة مع كل طرف على حدة لمناقشة تلك جوانب من الاتفاق؟ يحتاج وزير الخارجية الأمريكي – جون كيري – إلى تأكيد هذه الإجابات بالتحدث إلى طرفي النزاع أنفسهم. فكلا الطرفين لديه قائمة من المظالم ضد الآخر، وسوف يستمر نتنياهو بثبات بالاستفسار من وزير الخارجية الأمريكي عن الفائدة المرجوة من الاجتماع مع محمود عباس بعد محاولته مراوغة إسرائيل بذهابه إلى الأمم المتحدة.
ويتضمن منهج تحديد جوانب الاتفاق حمل الولايات المتحدة لإسرائيل على توسيع سيطرة الفلسطينيين على مدن الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها مع قيامها في الوقت ذاته بتغيير التصنيف القانوني لأجزاء أخرى من الضفة الغربية. (قسّمت الاتفاقيات التي تبعت عملية أوسلو الأراضي إلى ثلاث فئات– مناطق A، B، و C — استناداً إلى مستويات مختلفة من السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية). وفي المقابل، لم تعارض الولايات المتحدة أي أنشطة إسرائيلية داخل الكتل الاستيطانية الإسرائيلية التي لا يقع عليها نزاع عادة والمجاورة إلى حد كبير للمدن الإسرائيلية والتي تظهر في الخرائط الفلسطينية المنشورة على أنها جزء أساسي من إسرائيل، بينما يحق لها معارضة ما سواها مما يقع خارج تلك الكتل الاستيطانية. (أميل إلى التفكير بشكل مختلف فيما يتعلق بمستوطنة اريئيل التي يوجد نزاع كبير بشأنها، ولا أُخضع هذه المنطقة لهذا المبدأ). في الواقع، يعيش حوالي 80 في المائة من مستوطني الضفة الغربية على 5 في المائة من مساحتها. وهم ليسوا موزعين بالتساوي على جميع أنحاء الضفة. فهذه المناطق تتاخم حدود ما قبل عام 1967 بشكل كبير وتعرف باسم الكتل الاستيطانية وتلازم الحاجز الأمني لإسرائيل. ومن شأن هذا المنهج الشامل تأخير القضايا المتعلقة بالأمن في وادي الأردن وعلى طول نهر الأردن حتى ينقشع الغمام بخصوص عدم الاستقرار العام في منطقة الشرق الأوسط.
لماذا يعد إنشاء جوانب اتفاق أمراً ضرورياً؟ علينا توضيح اتجاه يسير فيه كلا الطرفين حتى وإن كنا لا نستطيع دفعهما على الوصول إلى اتفاق شامل. وكما هو الحال حالياً، فإن البديل لسلام شامل هو الشلل التام وعدم القدرة على إنجاز أي شيء، حيث يرى كل طرف أسوأ ما في نوايا الطرف الآخر. وإذا قال أي طرف إنه لا يستطيع تحقيق كل شيء ولكنه لا يزال يوافق على اتخاذ خطوات معينة، فإن هذا من شانه أن يقلل من مستويات القلق ويؤثر على المحادثات الداخلية في كلا الجانبين. وفي طيات صراع كهذا يعتقد المتطرفون من كلا الجانبين دائماً أن المعتدلين مخدوعون من الطرف الآخر؛ وبالتالي يلزم توفير بعض الإشارات الواضحة على أن التوجه نحو الحل القائم على دولتين سوف يعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا التركيز ينبغي أن يُقلل من التوترات في كلا الجانبين ويدعم المعتدلين مع وضع اللبنات الأساسية لاتفاق شامل.
من بين الميزات الأخرى لمنهج تحديد جوانب اتفاق أنه سوف يضع نهاية للغموض المُدمِّر الذي ظل يعمل على زيادة عزلة إسرائيل عن العالم في السنوات القليلة الماضية. ويقيناً أن العديد من الحكومات العربية وغير العربية كانت دائماً معادية لإسرائيل. وقد تفاقمت الأمور في الآونة الأخيرة. ويرجع هذا التأزم جزئياً إلى اختلاف التصورات حول مستوطنات الضفة الغربية. فعندما وصل بعض زعماء الدول الأوروبية — مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي — إلى مناصبهم الرئاسية كانوا على أتم الاستعداد لدعم إسرائيل إلا أن علاقتهم مع إسرائيل تدهورت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المرتبطة بمسألة المستوطنات.
ويلاحظ البعض أن النشاط الاستيطاني في ظل حكومات إسرائيلية أكثر ميلاً إلى وسط اليسار بقيادة إيهود أولمرت وإيهود باراك تجاوز بالفعل نشاط بناء المستوطنات تحت قيادة نتنياهو، إلا أن الشكوك أحاطت بـ “كل من أولمرت وباراك” وذلك لوجود إحساس واضح بأن إسرائيل مستمرة بالفعل في الاستيلاء على الغالبية العظمى من الضفة الغربية وأن إسرائيل سوف توافق على إنفاذ عمليات تبادل الأراضي أو مقايضتها. وعلى الرغم من ذلك، هناك تخوف على الصعيد العالمي من أن النشاط الاستيطاني في ظل حكومة نتنياهو ما هو إلا جزء من محاولة أوسع لفرض السيطرة الدائمة على الضفة الغربية بالكامل وليس على 5 في المائة منها فقط رغم أن نتيناهو يعد رسمياً من الداعمين للحل القائم على الدولتين. وكان نتنياهو قد قال أمام الكنيست قبل زيارته إلى الولايات المتحدة في أيار/مايو 2011 إنه سوف يعتمد على الحدود مع الفلسطينيين استناداً إلى الكتل الاستيطانية ولكنه لم يكرر ذلك منذ ذلك الحين.و قد يكون للمنهج القائم على تحديد جوانب اتفاق التأثير الأكبر على الطريقة التي ظهر بها نتنياهو في أوروبا وأماكن أخرى.
وبطبيعة الحال فإن هذا المنهج يقتضي أن يحصل وزير الخارجية الأمريكي — جون كيري — على دعم جميع الأطراف.
ويجدر بنا هنا أن نتطرق إلى الحديث عن تبعات الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، فقد ألقت بظلالها على نتنياهو، حيث إنه يواجه تحدي تشكيل حكومته في شباط/فبراير. فهل سيعمل نتنياهو على تشكيل حكومة بحيث يكون لحزب المؤيد للنشاط الاستيطاني بقيادة نافتالي بينيت هيمنة على ميزان القوى أم هل سيعمل نتنياهو على تشكيل حكومة تضم أيضاً مع ذلك الحزب أحزاباً أخرى بشكل أوسع؟ ومن حيث المبدأ، يظل من مصلحة كلاً من عملية السلام وأي رئيس وزراء أن يتم تشكيل حكومة موسّعة بحيث لا يتحكم حزب واحد بميزان القوى الحاسم. فإذا ما قام نتنياهو بتشكيل حكومة موسعة، فسوف تكون أمامه حرية أكبر لدفع إسرائيل إلى الأمام.
“كيري”.. مفاوضات السلام لـ 9 أشهر.. كانت (حملا) كاذبا
إلا أنه لا ينبغي قياس هذه المسألة من الناحية الكمية البحتة. إذ يتساءل البعض عما إذا كانت الشخصيات الرئيسية سوف تتسلم حقائب وزارية رئيسية. فهناك تكهنات حول ما إذا كان رئيس أحد أحزاب الوسط يائير لابيد — الذي قاد حزباً جديداً أبلى بلاء حسناً في الانتخابات — سوف يصبح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ويتحدث باسم إسرائيل أمام العالم. وهل وجد نتنياهو وسيلة لإبقاء شريكه إيهود باراك في وزارة الدفاع على الرغم من عدم خوض باراك هذه الانتخابات؟ ومما لا شك فيه أن هذين السؤالين يجذبان اهتمام المسؤولين في واشنطن. وعلى أيه حال، إن الأفراد لا يمثلون السؤال الأهم، ولكن ذلك يتعلق فيما إذا كان نتنياهو سيشكل ائتلافاً يناسب المهمة أم سيضع مهمة تناسب الائتلاف. فالمهمة هي إيجاد سبل للحفاظ على أمن إسرائيل مع السعي في الوقت ذاته إلى إحراز تقدم في عملية السلام المتعثرة مع الجيران الفلسطينيين — وتحديد ما إذا كانت هذه المسألة ستحظى بأولوية بينما تتعامل إسرائيل مع قضايا حيوية أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني والاقتصاد الإسرائيلي وإيجاد سبل لدمج الحركة الدينية المتشددة في نمط الحياة الحديثة. وبطبيعة الحال، سوف يكون قرار تشكيل ائتلاف إسرائيلي في يد الإسرائيليين أنفسهم، إلا أن تكوينه له تداعيات على الولايات المتحدة أيضاً. وبصرف النظر عن القضية الفلسطينية، تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة لمساعدتها في التغلب على الصعوبات المتزايدة في الشرق الأوسط إلا أن قدرة واشنطن على مساعدة إسرائيل ترتبط بالاعتقاد بأن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها. وقد تزيد القيود التي فرضتها إسرائيل على نفسها فيما يتعلق بتشكيل الائتلاف من صعوبة مساعدة الولايات المتحدة لحليفتها القوية إسرائيل.
والمسألة الأخرى التي تفرض نفسها على الساحة تتعلق بما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيناقش مع نتنياهو استعداده للدخول في عمليات متزامنة لتبادل الرسائل السياسية مع عباس من أجل كسب دعم الرأي العام، الذي أصبح متشككاً ومتشائماً تماماً بشأن المستقبل. ورغم اختلاف السياق، إلا أن الرئيس أوباما ذكر مؤخراً أنه لا يمكن تحقيق سوى القليل بدون الرأي العام. ومع الرأي العام لا يمكن تحقيق القليل.
هناك إحساس راسخ بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بأن السلام لن يتحقق مع وصولنا إلى الذكرى العشرين على إبرام اتفاقيات أوسلو للسلام. ولا تزال الغالبية تدعم الحل القائم على دولتين، وإن كانت بأعداد آخذة في التضاؤل. ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهر أن غالبية الفلسطينيين والإسرائيليين يدعمون إجراء مفاوضات سلام، إلا أنه عندما سؤلت نفس المجموعات عما إذا كانت هذه المفاوضات سوف تؤدي بالفعل إلى إحلال السلام في السنوات القادمة، كانت الإجابة بلا قاطعة. وبالتالي فإن أي إستراتيجية أمريكية تتطلب دمج إستراتيجية لكسب الجمهور من كلا الجانبين. ويمثل التأييد الشعبي في كل جانب أهمية بالغة منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها عملية السلام. فمن دون حث الشعوب لقادتها، سوف يتجنب القادة الذين يكرهون المخاطرة اتخاذ أي قرارات حاسمة. وهذا صحيح خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة للغاية.
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الولايات المتحدة التفكير في تبادل متزامن للرسائل السياسية. وسوف يتطلب ذلك من نتنياهو وعباس التركيز على المواضيع التي تلقى قبولاً لدى الجماهير من كلا الجانبين. على سبيل المثال، ينبغي على نتنياهو وعباس التأكيد بصورة منتظمة لشعبيهما على أن كلا الجانبين وليس أحدهما فقط له ارتباطات تاريخية ومستمرة بهذه الأرض. يتحدث عباس بين الحين والآخر أمام الأمم المتحدة عن القدس باعتبارها المدينة المقدسة لكلاً من الديانتين الإسلامية والمسيحية. ولقد قوض رفض الاعتقاد بأن القدس مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية الثلاثة بما فيها اليهودية من دعم عملية السلام. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي من شأنها ضبط المسار على مستوى القيادة لتثقيف الشعوب من أجل التعايش. ولا شك أن هذا المسار يمثل فارقاً.
في النهاية، أتمنى أن تحث وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الفلسطيني محمودعباس على بذل جهود أكبر للتأكد من عدم سعي بعض مستشاريه وحركة «فتح» نفسها إلى تدمير صورة الشخص الذي قطع أشواطاً كبيرة في بناء الدولة الفلسطينية من القاعدة إلى القمة، وهو رئيس الوزراء فياض. يتطلب دعم جهود فياض لتنفيذ برامج الإصلاح وبناء الدولة تأييداً كبيراً من عباس، وكذلك فتح خط اتصال مباشر مع نتنياهو.
وخلاصة الأمر أنه يمكننا جميعاً أن ننفض أيدينا ونقول إن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بالغة التعقيد، ولكن التأثير النهائي — كما تعلمنا من التاريخ الحديث — يشير إلى أن الجمود المستمر يمكن أن يفضي إلى التطرف والإرهاب وسفك الدماء. وستصبح النتيجة مقابر جديدة ومشاكل مستمرة من قديم الأزل. وبالتالي، من الأهمية بمكان تحديد قوى العمل البنّاء ثم العمل بعد ذلك مع الأشخاص الذين يمكنهم أن يُحسنوا من هذا الصراع المأساوي أو يضعوا نهاية له. وإذا بذلنا كل ما في وسعنا فسوف نحرز تقدماً كبيراً واضعين الأسس اللازمة لإنهاء هذا الصراع.