اليوم كان صباحي مختلفا فقد زار نافذتي سنجاب صغير يبدو أنه يقطن بجوار منزلي فوق إحدى الأشجار ، فهنا ما إن تشهد أول صباح في هذا المنفى حتى تلاحظ وجود أسراب من السناجب لا من الطيور هذه المرة تقفز حول منزلك ..
كان خائفا هائما لا يعرف أي وجهة عليه أن يختار ، كل ما يريده أن يجد له مساراً بعيداً عن نافذتي و ربما بعيداً عن بني البشر أجمع ، فما إن اقتربت منه علي أمد له يد المساعدة حتى قفز هارباً واجداً له طريق عودة نحو منزله حيث مأواه .
رحت أراقب طريق عودته ذلك و أنا أهمس لنفسي قائلة :
ليت عودتي إلى منزلي مأواي و موطني كانت بتلك السهولة أيضاً ..
ابتسمت و اغلقت نافذتي مجدداً فالبرد بدأ يزور هذا المكان ..
أكملت روتين حياتي الذي اعتدت عليه منذ قرابة العشرة أشهر هنا أو ربما أحاول الاعتياد عليه لا أعلم ؟
روتين لم أكن أتخيل يوماً أن أتماشى معه و أتصنع فيه فهم صعوباته و الانعزال داخله و البعد فيه عن أحبتي و عن ملامح وجوه ألفت النظر إليها ، تشبه ملامحي الشرقية ، تخبرك أنك في المكان الصحيح بين أناس يتكلمون لغتك و يحملون هويتك تاريخك و انتمائك ، مكان يصدح بعروبتك و تتنفس فيه شرقيتك ، فهناك إذا ما أنت رأيت إحدى وجوه المارة للمرة الأولى لا يصيبك الخوف و لا يقطن فيك أي احساس بالدهشة أو الغرابة و لا حتى رغبة بالبحث الدؤوب ، البحث عن وجه قد ألفت ملامحه يوماً ، هناك حيث موطني…
ترجلت من منزلي حتى وصلت إلى المكان الذي انتظر فيه تلك الحافلة ، و ما إن وقفت حتى تناولت هاتفي علّي أحظى ببعض من الأخبار التي يهمني أمرها ، قلبت بين صفحات تلك الشاشة الالكترونية و لكن دون جدوى فلا شيء جديد يوحي لك بأمل عودة قريبة ، أغلقت ذاك الهاتف فقد وصلت إلى وجهتي مترجلة من تلك الحافلة لاستقل ذاك القطار السريع القابع تحت الأرض …
هنا ..
لا تستطيع حتى أن تسرع من روتين تلك المقطورة بقراءة الأخبار و تصفحها فلا يوجد وسيلة اتصال تساعدك على ذلك ، فكان لا بد لي أن أنتظر ثلاثين دقيقة حتى أخرج فوق سطح الأرض مجدداً ..
رغم أنني في بعض الأحيان و أنا في ذاك السجن المتنقل أتناول كتاباً كنت قد شرعت بقراءته و لكن اليوم لم افعل ذلك ، فلسبب لا أعلمه رحت أراقب وجوه الراكبين ، أعمارهم ، اختلافاتهم ..
كنت ابحث عن شيء ما ، شيء لم أعد أراه بين الملامح والوجوه هنا ، نظرت ، ترقبت ، انتظرت و لكن هيهات دون جدوى ..
فالجميع يترنح و أنا معهم وسط تلك المقطورة كحال واحد أثملته ضغوطات تلك الحياة ليتشرب مآسيها التي سكنت على تجاعيد وجهه جاعلة من ذاك المكان مستقراً و متاعاً إلى حين ، تخبرك في كل واحدة منها قصة عاشها يوماً سببت له ندب لا يبرأ منه مهما طال به العمر ، بل لعلها تزداد مع تقدم العمر ، فيمسي في تلك المقطورة كإنسان أسكرته كثرة الهموم و تجرعها و راح يترنح في غربة دون أن يذوق طعم الخمر يوماً ، ربما ، فتلمحهم و كأنهم سكارى و ما هم بسكارى ..
فهناك تجلس إمرأة تقدم بها العمر تتجاذب أطراف حديث يبدو مهم بالنسبة لها مع رجل كان يجلس بجوارها على مايبدو أنه زوجها ، فتعابير وجهه غلب عليها اللا مبالاة ، و في الطرف الآخر يجلس شاب بدت آثار النوم واضحة على وجهه فيبدو أن استيقاظه لم يكن بالأمر السهل هذا الصباح ، فاختار له زاوية هادئة بعض الشيء واضعاً في أذنيه ترنيمة ما ، ترنيمة يفقهها ، يحبها و تتكلم لغته ، مغمضاً عينيه علّه يحظى ببعض من النوم قبل وصوله إلى محطته المنشودة ..
و هناك في نهاية المقطورة شابان في مقتبل العمر أسندا ظهريهما على جدار المقطورة و راحا يتناقشان و لكن بحدة يعلو عليها على ما يبدو سمات لمشكلة أقلقت يوم عطلتهم الذي مضى و رافقتهما إلى بداية هذا الأسببوع ، و هنا شابة تقرأ كتاباً ، و أما بجواري فقد جلس رجل عجوز وضع نظارته السميكة ، متناولاً جريدة كانوا يوزعونها قبل أن نستقل ذاك القطار ، و أما الآخرين فكانو يقفون مترنحين يمنة و يسرة ، ليحافظوا على توازنهم مستعينين بحبال أنزلت من سقف تلك المقطورة ..
و بالرغم من طول تلك المراقبة و تزاحم الناس و تبادل الحشود مواضعهم عند كل محطة إلا أنني لم ألمح ما كنت أبحث عنه ، نظرت و نظرت لكن دون جدوى ، فكل تلك الملل على اختلافها توحدت على ذلك الأمر .
فهنا يا سيدي موطن لكل من لا وطن له او ربما لكل من لم يجد لمستقبله شعلة نور وسط ظلام موطنه الأم و مسقط رأسه
لا..! إني هنا لا أبالغ البتة ..
دعوني أصف لكم هذا المكان أولاً ثم احكموا على كلماتي تلك ؛
فهنا اذا ما أنت اطلقت العنان لقدميك و مشيت في تلك الشوارع ، الحدائق و الأسواق تجد أشياء كثيرة تدهشك و تجعلك تعيش حرباً داخلية مع معرفتك الأولى …
إن ما اود قوله هو أن من أكبر تناقضات هذا المهجر حين مسيرك عشر دقائق ليس اكثر بين أزقة هذا المكان و حواريه ستتلاحق المشاهد على مرآك لتجد أناس من جميع الأطياف و الألوان و الأجناس و ستتسارع على مسمعيك عشرات اللغات اذا لم تكن أكثر فقد كنت قد حاولت سابقاً أن أحصي كم ملّة و أجزاء أمم تعيش هنا و لكن هيهات ..
فهنا اللغة الرسمية للحكومة هي الفرنسية بالطبع ، فالسكان الأصليون يتحدثون بها و المهاجرون أيضاَ ، فما إن تطئ قدم المهاجر هذه الأرض حتى يهرع لتعلم تلك اللغة ، و الدولة تضمن بذلك الألفة و الوحدة بين تلك الأمم جاعلين منهم أمة بلغة واحدة ، و أما فيما بين بعضهم البعض كأبناء أرض و أصل واحد فهم أحرار فيما بينهم بكل تأكيد ، فهنا تسمع اللغة الصينية الافريقية التركية الانجليزية و اللغة العربية بكل لكناتها و اختلافاتها من مشارق الوطن العربي الى مغاربه و غيرها الكثير الكثير..
و اذا انت دققت و حاولت البحث عن أناس ينتمون بأصلهم الأول الى هذه البقعة من الأرض فلن تجد أو ربما قد تجد القليل القليل منهم ليس أكثر ، و خاصة في فصل الشتاء ، و ذاك أنهم لا يستطيعون تحمل برودة هذا المكان و صعوبة المعيشة فيه في هذه الأشهر الطوال ، فيأخذون من السفر منجياً و درباً ليعودوا على مشارف الربيع هنا ، فتلاحظ ان أفواج الأمم المتعددة أكثر بكثير من هذه الأمة و تواجدها على هذه الأراضي ، لتجد نفسك ساخراً مستهزءاً قائلا : ان كل من أولئك المهاجرين كانت بلدهم الأم اكثر برودة من هذا المكان و أصعب معيشةً منه فاختاروا خير السماء و ثلوجها عن شر البشر و أحقاد الحكام لأستخلص انني هنا في موطن اتصف بأنه موطنٌ لكل انسان بلا وطن و بلا مأوى لنصبح هنا مهاجرين نمتاز بصفة عن الباقين اننا مسلوبون اوطان…
…
لنعد إلى خريف هذا العام حيث اليوم ، فقد تمنيت حينها أن يكون
نقصان ذاك الشيء حكراً على ذاك المكان ..
..
سأبحث عن ضالتي ما إن أخرج من هذا المكان الكئيب ، قلت حينها .
تناولت تلك الجريدة بعد أن تركها صاحبها مترجلاً من المقطورة ، حاولت أقرأ تلك الكلمات بفرنسيتي المتلعثمة ، قلبت و قلبت في تلك الصفحات قبل أن أتركها مترجلة من تلك المقطورة أيضاً ، فحتى الجريدة هنا لم يعد لها طعم أو معنى…
خرجت من المحطة أمشي متلفتة ناظرة مراقبة الوجوه داخل السيارات و خارجها ، و لكن دون جدوى لم أعد ألمح و لا حتى طيفها على وجوه الساكنين هنا ، لتبدو و كأنها ضيف عزيز لا يكرمك بزيارته إلا بعد ليال طويلة من الرجاء ، فالابتسامة هنا باتت يا صديقي أغلى بكثير مما كنت أتوقع و أعرف يوماً ، فقد بتنا ندفع ثمنها أيام من عمرنا تُطوى دون عودة و دون فرحة تذكر و دون لقاء من اعتدنا وجودهم يوماً ..
ليزورني لقطة من ذاكرتي القريبة حيث صباحي اليوم ، حيث ذاك السنجاب ، فأذكر أنه ما إن شعر أنه بات بأمان حتى راح يقفز على تلك الشجرة مع خليله ليلحق أحدهم بالآخر ، يلهوان و ربما يتسامران ، فحينها أدركت أن خوف ذاك السنجاب منا نحن بنو البشر ، خوف اصفه بالمبرر إلى حد ما ، فنحن بنو البشر بتنا اليوم لا نخاف من بعضنا البعض وحسب بل بتنا نخاف من أنفسنا ، من وجوهنا إذا ما ارتسمت على المرآة ، وجوه أضناها كثر الاغتراب و أعياها افتقار الأحباب ، كيف لا و نحن لا نشعر بالأمان الأول ، ذاك الأمان الذي يصل بحباله نحو دمشق و قاطنيها ، نحو أهلك و أصدقائك ليبات حالنا تماماً مثل ذاك السنجاب حين ضاع عن مأواه و عن أبناء ملّته فراح يتخبط على النوافذ باحثاً له عن طريق عودة ، مع فارق مهم ، أنه في موطنه و وسط أبناء جنسه ، و نحن اليوم بتنا فقراء وطن بعيدون كل البعد عن أبناء ملّتنا بل بتنا و إن حظينا بأحدهم أبعدتنا أفكارنا آراءنا و اختلافاتنا عن بعضنا البعض من جديد ،لنبقى تائهين و لكن و بالوقت نفسه موقنين أنه و مهما اختلفت النوافذ و اختلف معها مكان اقامتك يبقى حنينك الأول و الأخير لنافذة طفولتك تلك .
4_ 10 _ 2015
مونتريال _ كندا


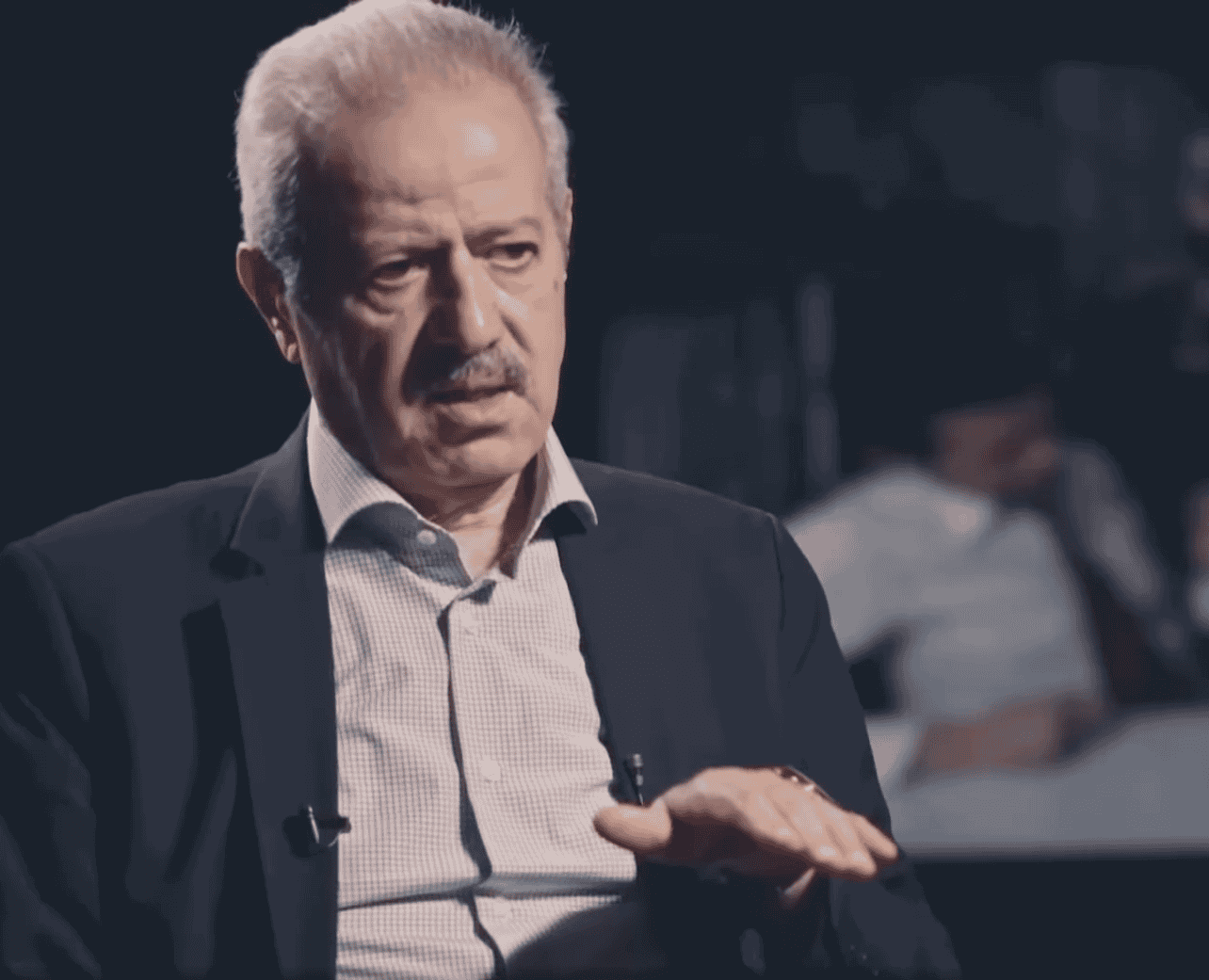









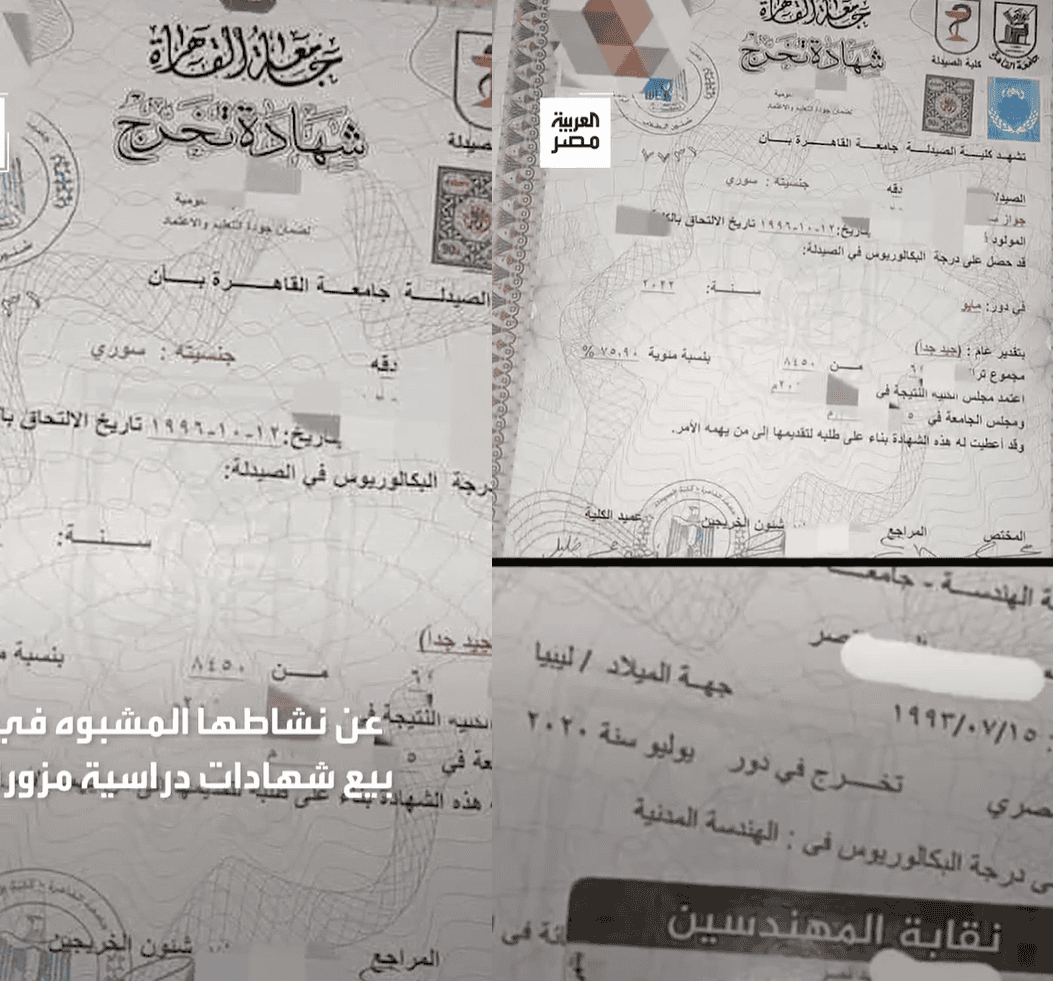






انشاء الله باقرب وقت تعود بلد الياسمين لنشر عطر الياسمين بدل البارود والقنابل ونعود جميعا لعمل السيارين على ضفاف بردى